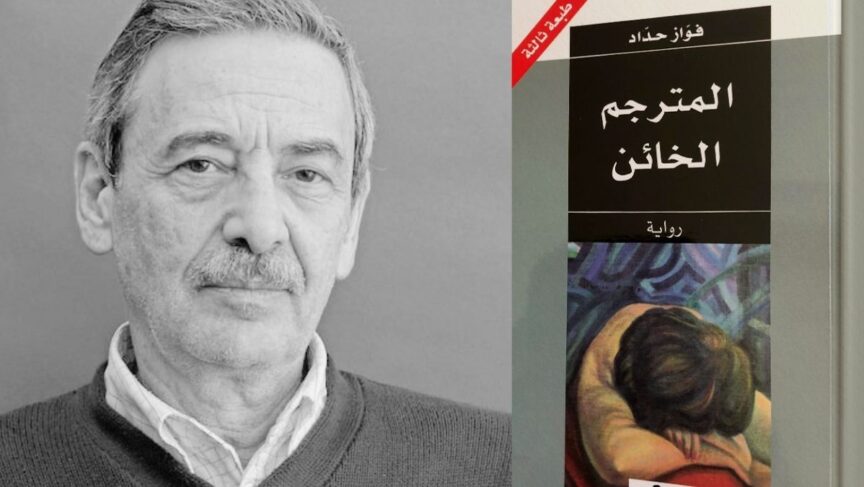في 22 فبراير/ شباط 1942، قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، عثَر البستاني ومدبرة المنزل على جثتَي الكاتب النمساوي ستيفان تسفايغ وزوجته لوت في فراشهما، بعد تناولهما جرعة زائدة من الباربيتورات (مادة مهدئة ومنومة). ترك تسفايغ وراءه رسالة انتحاره، ومعها مشاريعه غير المكتملة.
جاء في الرسالة: “أن تبدأ كلّ شيء من جديد بعد الستين يتطلب قوى خاصة، وقد نفدت قواي بعد سنوات من الترحال بلا مأوى. ولهذا، أُفضّل أن أنهي حياتي في الوقت المناسب، واقفاً، رجلاً لطالما كانت سعادته الحقيقية في العمل الثقافي وحريته الشخصية”.
وفي رسالته يكتب أيضاً: “كانت كتبنا أول ما أُلقي في النيران… لكنّنا لا نشعر بأي ندم لهذا النفي القسري… لقد أصبح ضميرنا أكثر صفاءً بعد القطيعة التامة مع من قادوا هذا العالم إلى الكارثة الكبرى”، كما لم يستطع أن يقطع صلته تماماً باللغة الألمانية التي كتب بها، بما يمكن اعتباره اعترافاً مريراً بأنه لا يمكن للمرء أن ينتزع نفسه من اللغة التي يبدع ويفكر بها.
بدلاً من أن يكونوا معارضةً راشدة، اختاروا الترويج للخراب
انتحر تسفايغ في البرازيل، المنفى الذي اختاره لموته، وخلافاً للاعتقاد السائد، لم ينتحر لأنه ظنّ أن النازية ستنتصر، أو لخوفه من امتداد الحرب إلى أميركا. لم ينطق بكلمة توحي بأنه يشكّ بأن النصر النهائي سيكون من نصيب الحلفاء. كان مؤمناً بأن الديمقراطيات والحريات لن تهزم، رغم تأكده من أن الحرب ستكون طويلة ومدمرة. والأهم، أنه كان يعتقد أن “موجة الكراهية التي شعر بها تكتسح العالم” ستترك أثراً لا يمكن علاجه، وهو ما ترك أثراً بالغاً فيه.
ويبدو أننا نحن السوريين الذين اخترنا المنفى طوال الأربع عشرة سنة الماضية، أن خيارنا منحنا البراءة من الجرائم المرتكبة في الداخل السوري، ولم يضطرنا للصمت أو للمساومة أو للخضوع، لقد نجونا من هذا كلّه، بثمن زهيد، الخروج من البلد. في تلك السنوات كنا مكشوفين ومقيّدين ومعرضين للموت كمداً أو انتحاراً، هناك من مات كمداً، وهناك من انتحر. فاليأس الذي تسلل إلى النفوس تفاقم مع الوقت، مع انسداد أي بارق لبزوغ حل في الأفق، ولم يكن من السهل الأعوام التي كانت تمرّ تباعاً، بينما كانت الآمال تنهار تباعاً. كانت أكثر الفترات التي بلغنا فيها الذروة في اليأس، تلك التي سبقت سقوط النظام ببضعة أشهر، حين طلبت تركيا التفاوض، لكن الدكتاتور أبدى وقاحة في الرد بعدم القبول، في الوقت نفسه فتحت البلاد العربية ذراعيها لاستقباله، ولم تجد أوروبا بأساً في إعادة التواصل معه، على الرغم من جرائمه. ظهر النظام وكأنّ شيئاً لن ينال منه.
كان تسفايغ يستخدم أحياناً عبارة “يموت من الحرب”، على نمط القول “يموت من مرض”. أما نحن في تلك الأوقات، فكنّا نحسّ بأننا على وشك أن “نموت من الانتظار”. حسناً لم نَمُتْ من الانتظار، فقد انتهى وعادت بلادنا لنا. لكنّنا اليوم، نكاد نموت من تفشي موجة الكراهية، حتى بدا وكأنّ سنوات الحرب تجدّدت، وكأنّنا لم نستحق الثورة ولا سقوط النظام، ولا هذا الانتصار، ماذا عن السوريين الذين استشهدوا؟ هل ذهبت أرواحهم سدى، حتّى بات يخيّل إلينا أنّ ما يزيد عن نصف قرن، لم تعد زمن الرعب، وإنما مجرد زمن مضى كغيره. بئس السوريون على نسيان ما لا ينسى.
تحول هذا الذي لم نتجرأ على أن نحلم به إلى حقيقة، لكن هناك من انصرف إلى إحداث الانقسام والفوضى، بالتشكيك بانتصارٍ كان لسورية وللسوريين جميعاً. بات ضيق الأفق والمصالح الأنانية تدفعهم لإيذاء شعبهم بالأكاذيب والشائعات، بدلاً من أن يكونوا معارضة راشدة، اختاروا الترويج للخراب.
هذه الموجة من الكراهية، ألَا تثقل ضمائرهم، عندما تتمحور رغباتهم حول تعمّد إفشال تعافي سورية؟
-
المصدر :
- العربي الجديد