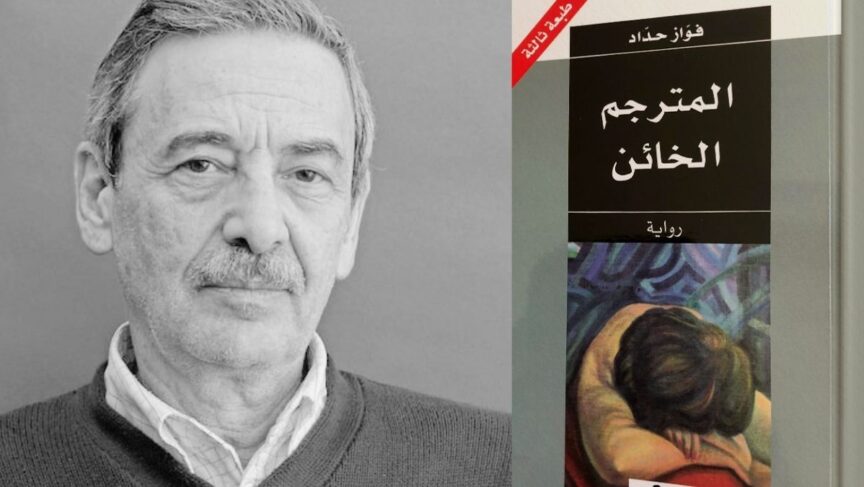أفرطت الأنظمة التقدمية طوال النصف الثاني من القرن الماضي في الإشادة بالشعب، وكان الرئيس جمال عبد الناصر، من أوائل من عمل على رفع رايته عالياً، في زمن كان بدايات أفول الاستعمار، بشعار أطلقه بعد ثورة يوليو، عشية جلاء الانجليز: “ارفع رأسك يا أخي، لقد انتهى عهد الاستعمار”، أما لماذا لم تبق الرؤوس مرفوعة في عهود التحرر، فليس مستغرباً، مع أن قادة الشعوب العربية، مشوا على درب الحرية، وحاولوا تقليد الزعامة الناصرية، لكنهم لم يفلحوا؛ الأصل غير التقليد.
لم تغفل الحكومات العربية الاستئناس بالشعب في دساتيرها ومشاريعها الإنمائية وخططها الاقتصادية، والمعاشات التقاعدية…. من دون نجاح يذكر في توفير العيش الكريم، وإن نجح المثقفون ومفكرو الأحزاب في تطوير صياغة هذا المفهوم على نحو مجلجل، فأصبح الشعب وراء كل عمل وغاية، والهدف من كل ثورة وانقلاب وتصحيح وانجاز. ومن كثرة ما أسبغ عليه من تعظيم، جعلوا منه الملهم والروح والمنارة والنور والنار… تُستمد منه الآمال العريضة وتستهدى به رؤى المستقبل والخطط الخمسية، لولاه لما كانت هناك بلاد ولا حكومة وحكام ولا تقدم… بمختصر العبارة، القوة الدافعة والمحركة لكل ما تنوي الدولة القيام به!! حتى أصبح الشعب أسطورة الثورات وأيقونتها، لا يمسه العطب ولا يخطئه الصواب، وتابع آخرون على منوال اكثر جرأة، وأسبغوا عليه القداسة، وأصبحت كلمة الشعب، كلمة الله. فكان الشعب وكيل الله على الأرض، والسادة الحكام منفذين بررة لإرادته الخيرة.
انطوت هذه التأويلات على الكثير من المبالغات والضجيج، في الوقت الذي استلبت إرادة الشعب، لكن بعد أن أصبح غطاء لجميع التجاوزات والأخطاء والجرائم، فالعصر كان عصر ثورات، وإزاحة طبقات، وتخوين شخصيات وطنية، واسترداد حقوق مزعومة، واستنهاض كرامة مهدورة، وسفك دماء، وسجون وزنزانات. كان الشعب، افتراضياً، سلطة مطلقة.
هذا التوافق بين الشعب والسلطة، كان مديناً لتنظير مثقفي الثورات، أما على الأرض، فلم يعره العسكر اهتماماً، من هو الشعب؟ كتلة غامضة، لا ملامح لها، ذات وجود اعتباري متخيل، إذ لا ناطق باسمها، وإن كانت تضم عمالاً وفلاحين واتحاد نسائي ومثقفين ثوريين وبرجوازية وطنية. وحتى إذا كان هؤلاء هم الشعب، فصفوفهم تحتاج إلى ضبط في مسيرات، وقائد مرشد يقودهم إلى مستقبل بلا طبقات، وإلا ابتلعوا الدولة… مرحى لسلطة العسكر الثورية.
لم يعد الشعب سوى مادة خام، متعددة الاستخدامات: التضحية به في الحروب الخاسرة، والتنكيل به في المعتقلات في حال التمرد. وفي أزمنة الطاعة، دفع الضرائب، والتقيد بقوانين السير، وفي أزمنة الرخاء، إلقاء القمامة في الحاويات، ودفع الرشاوى، أضيف إليها تسديد فواتير الهاتف الجوال…
في عاصفة الربيع العربي، تظاهر الشعب السوري في أرجاء البلاد، واستعاد بانتفاضته صورته النموذجية البكر، الانسانية ما قبل اليسارية، صورة المناضل حتى الموت في سبيل الحرية، احتجاجاً على ما لحقه من هوان، وما ابتدع لأجله من وسائل تعذيب، وما ناله من أحكام جائرة، وما وقع عليه من اعتقالات كيفية، واستملاك ظالم، وما أصابه من فساد وإفساد. كانت معجزته الوحيدة، البقاء على قيد الحياة على الرغم من عسف أجهزة أمنية كانت تعد عليه أنفاسه، هذا إذا لم تسجنه أو تقتله. الخلاصة، هذا ما يدعى بالاستبداد.
المستغرب أن الكثير من الذين حاكوا عنه الأساطير، إضافة إلى القداسة، تنكروا له، ومعهم ليبراليون وعلمانيون وعلماء ومتعلمون، بل وفقهاء… يزعمون أنهم ينبذون الطائفية والطوائف والمذهبيات والمذاهب، ويؤمنون بحق الشعب في العيش بكرامة، إلا أنهم لا يستطيعون اغفال أن هذا الشعب المارق يطابق المواصفات المطلوبة للسحق بالمدفعية والطائرات والدبابات والصواريخ، فجرى تحويله إلى موظفين مرتشين، وعمال مأجورين، وفلاحين خبثاء، وعملاء لدول عربية وغربية، ومتسوليّ دولارات، وزعران، ومهربي ممنوعات، ومتعاطي مخدرات، وأصحاب سوابق… الحثالة التي تخرج منها عصابات مسلحة سلفية وأصولية!!
الشعب حسب الطبعة الأخيرة، ارتكب خطيئة العمر، لم يدر أن الموت هو الوجه الآخر للحرية.
-
المصدر :
- المدن