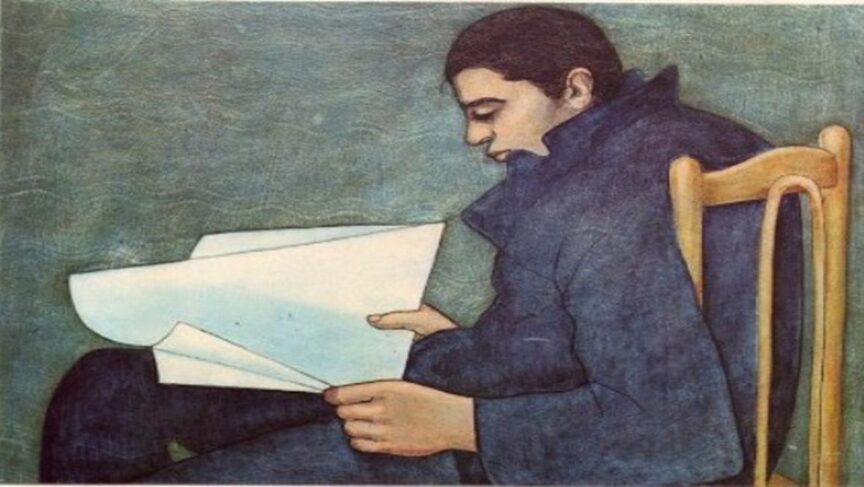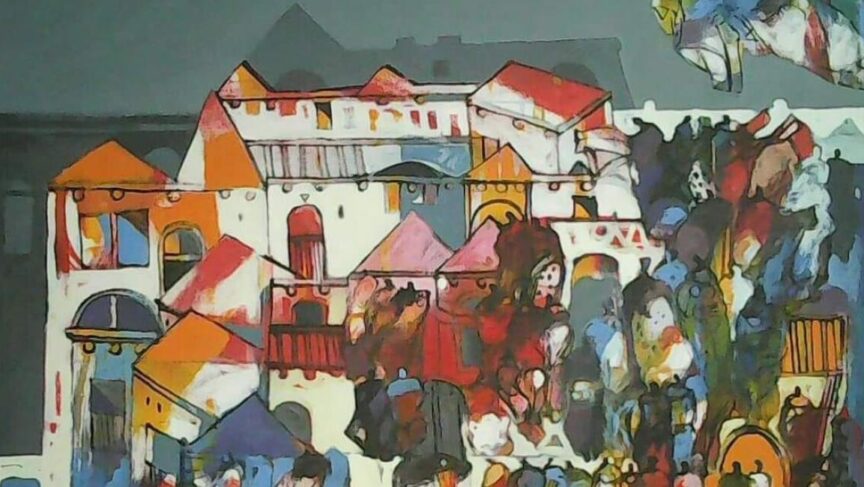يبدو أحياناً أنَّ مُشكلة الكاتب هي مع القارئ، بحكم قابليّته للانقياد لمؤثّرات الدعاية التي تلعب الدور الأول في اختياراته. هذا الأمر لا يقتصر على الكتب، بل يمتدّ إلى جميع مناحي حياتنا، من معجون الأسنان إلى الأفلام السينمائية وملابسنا الداخلية. لكن الأمر بالنسبة للقراءة يجب ألّا يخضع لها، ولو كان القارئ يتأثّر بها، فالقراءة فعلٌ مضادٌّ للسطحية وعلى علاقة بالمتعة المعرفية والتأمّل وسبر غور الأشياء.
في الحقيقة، لا يجوز تعميم الحكم على القرّاء وكأنّهم فصيل واحد، فهناك أكثر من نوع. إذا افترضنا أنَّ هناك قارئاً سيّئاً، فهو الذي يستسهل قراءة التعليقات اللافتة والتغريدات الخاطفة والتريندات المثيرة ويكتفي بها. يلتحق به المُستهلك السريع للكتب، يتصفّحها على عجل ليثبت للآخرين أنّه مثقف. لا يمنحُ الكتابَ حقّه من الوقت، أو يحاول الإصغاء إلى صوت الكاتب، ومن الطبيعي ألّا يسائل ما يقرأ.
أما القارئ الانتهازي الذي يقرأ ليبدو مثقّفاً نخبويّاً، فيتميّز بأنّه يسارع إلى إصدار أحكامه على المؤلّفين، وعادة تكون سلبية. لا يقرأ ليغيّر رأيه، بل ليؤكّده. يبحث في الكتاب عمّا يدعم أفكاره المسبقة، ويهمل كل ما يناقضها، فهو يعرف ولا حاجة للمزيد. فالكتب ضرورية بالنسبة إليه، إنها مادة للظهور والغرور.
هناك أيضاً القارئ العابر؛ صديق الكتب المؤقّت الذي يقرأ حين تسنح الفرصة، أو حين تدهمه رغبةٌ مؤقّتة، مبعثها الفضول أو الهروب من الملل. لا يحمل طموحات فكريّة كبيرة، ولا يطلب من الكتب أكثر من لحظات من المتعة أو التشويق. ورغم بساطة موقعه في حلبة القراءة، فإنه يُعتبر أفضل وأكثر إخلاصاً من القارئ الانتهازي، لأنّه لا يتظاهر بأنّه يعرف، بل يسعى إلى المعرفة. هذا القارئ صادق، ويعول عليه بأن يتحوّل مع مرور الوقت إلى قارئ متميّز إذا ما نمت علاقته مع الكتب.
الرقابة على الكتاب هي رقابة على القارئ، خشية أن يصبح مثقّفاً
أمّا القارئ الجيد، فليس بالضرورة الأذكى، بل الأصدق في شغفه بالكتب، وطلب المتعة بالقراءة، ولو كان في البحث المعرفي. يمتاز في قراءاته بالتأمّل، يُصغي إلى الكاتب، وقد يعيد قراءة الكتاب مرّة ثانية أو أكثر من مرّة. وفي كل مرّة يعيد اكتشافه، ولا يعدم الرغبة في تغيير آرائه وربّما حياته تحت تأثير أفكار أخلاقية أو إنسانية.
أمّا خطر القراءة الجيّدة، فهو أن تذهب بالقارئ إلى التماهي مع الرواية، فيقرأ ذاته عبرها، ويصل التماهي مع بطلها إلى مجاراة مستوى العيش نفسه، وقد يبلغ أقصاه بالنهاية نفسها. وفي هذا مثال شهير، فقد أدّت قراءة شبّان تأثّروا برواية غوته “آلام فرتر” إلى الانتحار. ترى هل ينفع النصح بعدم التماهي مع الرواية، وذلك بخفض مستوى الاندماج لئلا تتعدّاه إلى أكثر؟ لا يمكن المراهنة على ذلك، فالقراءة الجيدة لا يمكن ضبطها، طالما أنها أنتجت أيضاً مجرمين تحت تأثيرها.
ولا ننسى القارئ العملي، إذا حاولنا وصفه، فهو بالمقارنة مع من سبقه، لا يتفاعل مع النص، لا يقبله ولا يرفضه، إنّما يقرأه فقط على أساس إعادة إنتاجه، أي يفهمه كي يشرحه للآخرين بطريقة مقنعة. لا يُستثنى المؤلّفون من هذا التصنيف المبسّط، فالكاتب قارئ أيضاً، إذا كان قد كتب عدّة كتب، لكنّه قرأ مئات الكتب. أما كيف قرأها، فلسنا بصدده.
أخيراً، لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الرقابة على الكتاب هي رقابة على القارئ، خشية أن يصبح مثقّفاً، لا سيّما الرقابة في الدكتاتوريات الطاردة للقراءة بأنواعها كلها، وتجهد بقمع القراءة الحرّة باعتبارها هرطقة وآفة مفسدة. فتمنعها بمنع الكتب، وتستسهل قتل القارئ أو سجنه أو تعذيبه حتّى الموت. ولا تزيد في هذا الكلام، فقد حدث في سورية في زمن دام نصف قرن، هذا ليتذكّر السوريون قبل غيرهم، وخاصّة المثقفين منهم، أنهم كانوا مستهدفين، فلا ينسوا، حسب تنبيه مأثور للروائي المصري نجيب محفوظ “آفة حارتنا النسيان”.
-
المصدر :
- العربي الجديد