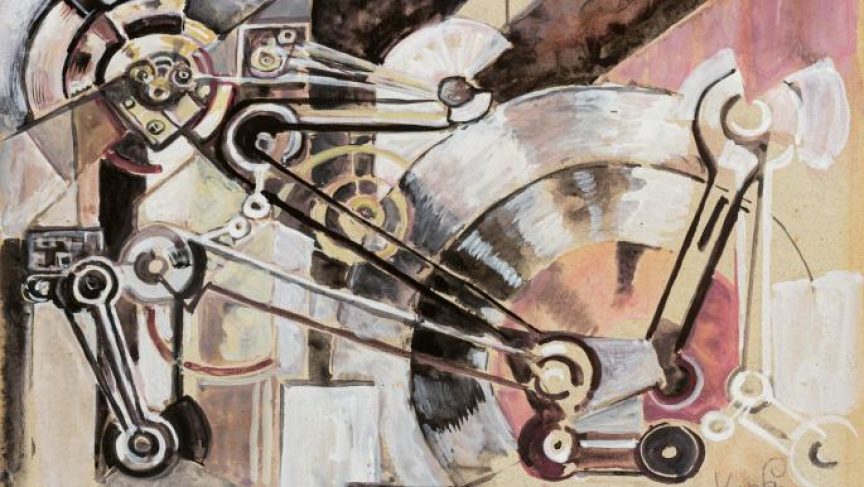بعد اختراع الطباعة، أخذت المطبعة على عاتقها نسخ الكتب، واختفت مهنةٌ بكاملها: لم يعد هناك نسّاخون ينكبّون طوال النهار، وفي الليل، على لهب الشموع، ينقلون ذخيرة الماضي إلى الحاضر، وذخيرة الحاضر إلى المستقبل، يُسطّرون بالمداد المجلّدات لطلبة العلم والمعرفة، وللّذين يتقصّون أمور دينهم ودنياهم. يحفظونها خوفاً عليها من التلف، لئلّا تغدو طعماً للغبار في الخزائن، بما يوفّرونه لها من عناية وصيانة، لكنهما لا تحميانها من النهب، ولا الحرق، أو من أن تجرفها الأنهار وتبدّد حروفها في الماء. المهمّة شاقّة وشائقة: عدم ضياع ما كتبه الأسلاف ولا المعاصرون.
مع ظهور المطبعة، لم تعد المخطوطات عدّة نسخ، بل كتب بمئات النسخ، كانت أعدادها الكبيرة ترفع من حظوظها في البقاء تحت تأثير عوامل الزمن. باتت مشاعاً، لا تُتداول في نطاق محدود، تنتشر على نطاق واسع، يسهل الوصول إليها، ولو صادرتها السلطات، أو طاردها الجنود عبر الحدود، وإذا نالوا منها، فالمطبعة كفيلة بعدم التفريط في جهود مؤلّفيها.
لم يكن التراث في حالة عطالة وركود، إلّا لصعوبة الوصول إليه وتداوُله. كان يتطلّب السفر من بلد إلى بلد، ودائماً بانتظار المهتمّين به. لولا النسّاخون، لكان أسير ذاكرات فردية تتوارثه، يُعتمد في الوصول إليه على جهود فردية. مع الطباعة، أصبحت الكتب المطبوعة ذاكرة الإنسانية الجمعية. تفوق طاقتها ما تختزنه المخطوطات، لا يشقّ عليها احتواء معارف كانت توالي تضخّمها في العالم. لكن مع توالي القرون، باتت تحتاج إلى ما يحفظها، ربما حافظة خيالية ذات سعة لا يمكن تصوُّرها، تستوعب الآلاف المؤلّفة من الكتب لمختلف ما أصبح يشكّل معارف العصور السالفة، وهذه العصور التي لا تتوقّف عن القدوم، فإذا كانت تُحفظ عن ظهر قلب من قبل، ومن بعد تُنسَخ في مجلّدات، ثم الطباعة، لكن لم تعد تفي بالغرض.
خفّفنا الحملَ على ذاكرة يُجهدها تكديس المعلومات
ماذا عن الذاكرة الشخصية؟ لا شكّ أنّها تقتصر على أطوار حياتنا، واحتياجاتنا، وما مرّ علينا من أحداث مؤلمة ومفرحة، ومعالم أماكن عشنا فيها وتنقّلنا بينها، ولغة نستعملها بحكم الولادة والعادة. أي أنّ الذاكرة البشرية محدودة، قدراتها مهما تضاعفت لا تجاري ولا تتّسع لثقافة في ازدياد مطرَد ومتسارع، إلى أن حقّقت الشبكة العنكبوتية إنجازاً لا نظير له كان مكسباً للبشرية، وفي غنى عن الذاكرة الشخصية، ساعدت على حفظ التراث الإنساني وانتشاره، مع قدرة سحرية تأخذنا إلى أكبر المكتبات للاطلاع على ما حفل به من كتب بمختلف اللغات.
يمكن القول، إنّنا خففنا الحمل على ذاكرة يجهدها تكديس المعلومات، لم تعد ملزَمة إلّا بتذكُّر أشياء تعني حياتنا ومشاغلنا اليومية وذكرياتنا الشخصية، ما أصابها بالوهن، وعطّل تنشيطها، لم نعد نهتم حتى بالمعارف الضرورية، إلى حد قد ننسى حتى جدول الضرب، ذاكرة في إجازة، هل ما خسرناه يعوّض عنه ما ربحناه بدلاً منها؟ الخسارة مؤلمة، وإن مقابل ذاكرة هي انفتاح على ثقافتنا وثقافة العالم.
وفّرت التكنولوجيات الحديثة ذخيرة معلوماتية لا تنضب، وُضعت تحت تصرّفنا، بعد انتقالها من الورقية إلى الإلكترونية المرنة، فالصلبة، ما وفّر أخيراً للفرد، إمكانية إنشاء مكتبة شخصية تُشكّل مستودعاً لمئات آلاف الكتب، بوسع أيّ باحث وقارئ حيازتها وضمّها إلى مقتنياته، تغدو ملكاً له، وفّرته ذاكرة إلكترونية هائلة الحجم في توسّع دائم، تسمح بالنهل منها أفراداً وجماعات ومؤسّسات ومراكز أبحاث.
قدرة الذاكرة الإلكترونية على التخزين المتواصل، وفي تمدّد مستمر، انعكست فوائدها على العلم والتعلّم في المدارس والجامعات، وطلبة الدراسات العالية العلمية والاجتماعية والتاريخية. ما يحيلنا إلى أنّ ما لا تتّسع له رؤوسنا الصغيرة، يتّسع له قرص صلب يوضع في الجيب. فالعلم لم يعد التعلّم بالحفظ غيباً، ولا بتكديس المعلومات، ولا أن نُرهق أنفسنا بصرف الوقت بالتنقيب عن المراجع، بل في أن نتعلّم كيف نفكر، ما دام أن المعلومة بمتناولنا بكبسة زر فقط. إنّ الاعتماد على الذاكرة الإلكترونية، يعني سهولة الوصول إلى المعرفة المستقرّة وما يستجد عليها من تطوّر وتحوّلات. لقد أصبح بإمكاننا الانصراف إلى نشاطات فكرية أكثر إبداعاً. ما يحقّق عبارة مونتاني: “أفضّل رأساً جيّد التكوين على رأس محشو بالمعارف”.
فشكراً للعلم، وسحقاً للرقابات التي تحاول أن تضع سدّاً بيننا وبين المعرفة، وشكراً للفضاء المفتوح على أكثر من مصراعيه، وسحقاً لكلّ من يسعى إلى إغلاقه.
-
المصدر :
- العربي الجديد