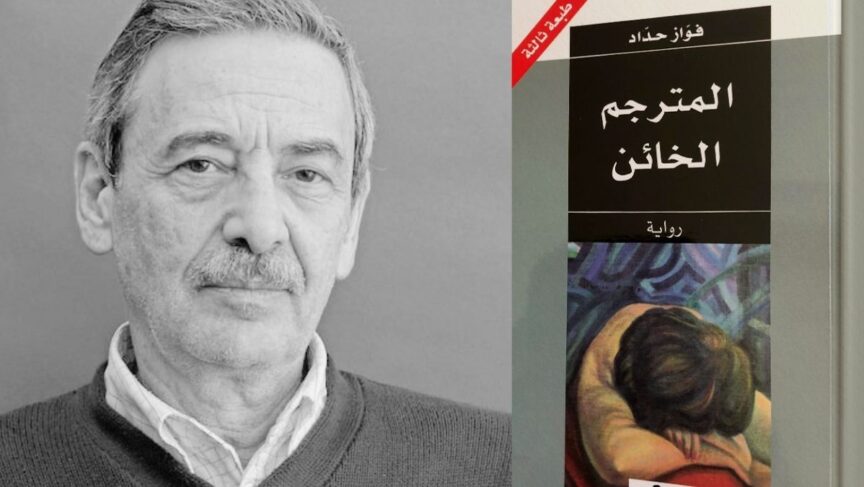المتوقع أن تثير فضيحة إبستين الكثير من الضجيج ليس في أميركا وحدها وإنما في العالم أيضاً، بحكم امتداداتها، وتورط شخصيات سياسية لافتة فيها، أكثر مما أثارته اغتيالات تاريخية كاغتيال كينيدي، الذي بقي معلقاً حتى اليوم، بعدما جرى احتواؤه. لن تشذ عنها فضيحة إبستين، فالمشاركون لا يمكن إحصاؤهم، والوثائق بالملايين، فلنتصور ما سينجم عنها من تحقيقات وأوراق، عدا عن براعة المحامين في مراوغة العدالة، فالجرائم المرتكبة لا يمكن النجاة منها، لكن يمكن إلصاقها بمتهم واحد قضى منتحراً، وقدم موته هدية قسرية لجميع المشاركين بهذه المأثرة، هذا إذا كان قد تبرع لهم بشنق نفسه.
ما تكشفه فضيحة إبستين أنها ملف عن جرائم الاتجار الجنسي بالقاصرات، وتكشف أيضاً عن أغوار أعمق وهي، أن الجسد لم يعد شأناً أخلاقياً أو خاصاً بل أداة سياسية، والانحراف الجنسي ليس انحرافاً سادياً، وليس المرضى المهووسون مصابين في عقولهم، وإنما أثرياء وسياسيون ورجال أعمال ورؤساء مصابون في ضمائرهم. هذا من ناحية الأداة والأدوات، التي تعمل سلطة غامضة لتصبح أدوات هيمنة وسيطرة.
أما كيف تؤدي عملها، فمن خلال منظومة تواطؤ خطيرة؛ تعبر أشد تعبير عن ترابط وثيق بين الثروة والسياسة، النفوذ والإعلام، مع التمتع بحصانة سرية غير معلنة من قبل الأجهزة الأمنية. لم يكن لهذه الجرائم أن تكون ممكنة، لولا شبكة واسعة النطاق على أكثر المستويات العالمية الفاعلة والمرموقة، ما شكل حماية لها، حتى أن الصمت الذي أحيطت به، أصبح سياسة أسهمت باستمرارها.
الجسد لم يعد شأناً أخلاقياً أو خاصاً بل أداة سياسية
أبرز ما تكشف عنه الفضيحة، ملامح رأسمالية متأخرة، نشأت مع دخول العالم الألفية الثالثة، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك رابطة الدول الاشتراكية، وانتصار الرأسمالية، ودخولها عالم السياسة، فرأس المال لم يعد أحد الضغوط الفاعلة فيه، بل أصبح جزءاً لا ينفصل عن آليات اتخاذ القرار، بحكم التشابك العضوي بين مصالح المليارديرات وصنّاع القرار. ما يخشى منه ولا يصعب تقدير أضراره، أن تصبح الديمقراطية نفسها قابلة للاختراق عبر شبكات تعمل في الظل، ما يحيلها مع الوقت إلى سلطة ترعى الجريمة المنظمة.
ضمن هذا السياق، لا يظهر إبستين بوصفه شخصية هامشية، بل وسيطاً مثالياً بين عوالم متنوعة؛ المال، السياسة، الاستخبارات، الإعلام، الجنس، التجسس، الجريمة؛ ما هذا الفساد إلا العقدة في شبكة معقّدة، تُمرر من خلالها مصالح الأطراف، شبكة لا يمكن تفكيكها دون الاصطدام بالنظام نفسه.
يجري التلويح بالفضيحة بوصفها مشكلة أخلاقية، لكن شبكات النفوذ، ستسمح بتعليق القيم الأخلاقية، لاستحالة إجراء مجازر سياسية لما يعتبر تجاوزات جنسية، لا تزيد عن نزوات لأشخاص متنفذين، يمكن التعتيم عليها تحت غطاء الأمن القومي أو المصلحة العليا للبلاد. لهذا أية محاولة للعثور على إجابات حقيقية، تذهب إلى متاهة، ويصبح الحل الوحيد التعايش مع الفساد، وإدارة الفضيحة بالتضحية بكبش فداء، تشريعات شكلية، ولجان تحقيق تُدفن نتائجها. ما دام أن التجربة تشير إلى أن مثل هذه الفضائح تنتهي غالباً بإجراءات محدودة: محاكمات انتقائية لبعض المتورطين، ثم طيّ الصفحة. لكن البنية التي سمحت بحدوث كل ذلك تبقى على حالها، لأن المساس بها غير مسموح به.
يعتقد أن حضارة الغرب تتمتع بمناعة ذاتية، لا تنال منها الجرائم ولا المخدرات ولا عصابات المافيا، واليوم أضيفت إليها تجارة الجنس، غير أن ما يعلمنا إياه التاريخ بأن الأمراض المستفحلة المؤدية إلى انهيار الحضارات، تصنع عادة في داخلها، ولا تأتي من خارجها.
أما في دول الديكتاتوريات، فاستيراد فضائح كهذه، ليس عملياً لأن السلطة والمال بيد فرد أحمق واحد، وفي حال تهدد لا يفقد سوى السلطة ويهرب بالمال.
-
المصدر :
- العربي الجديد