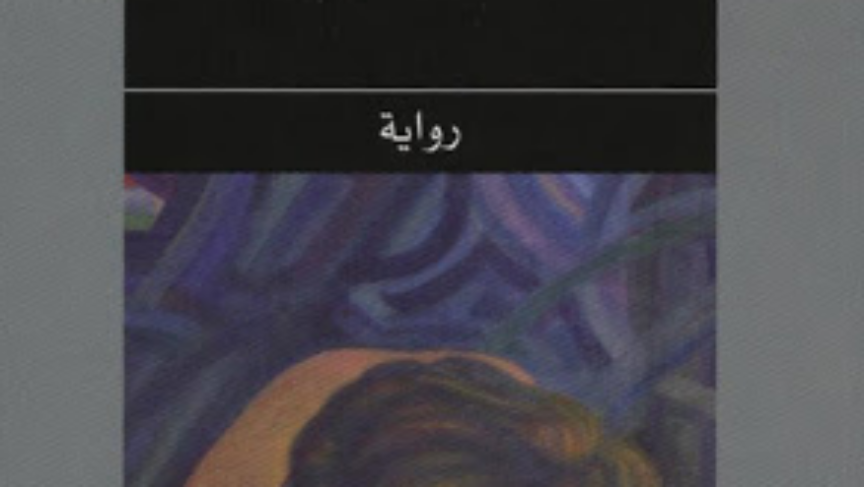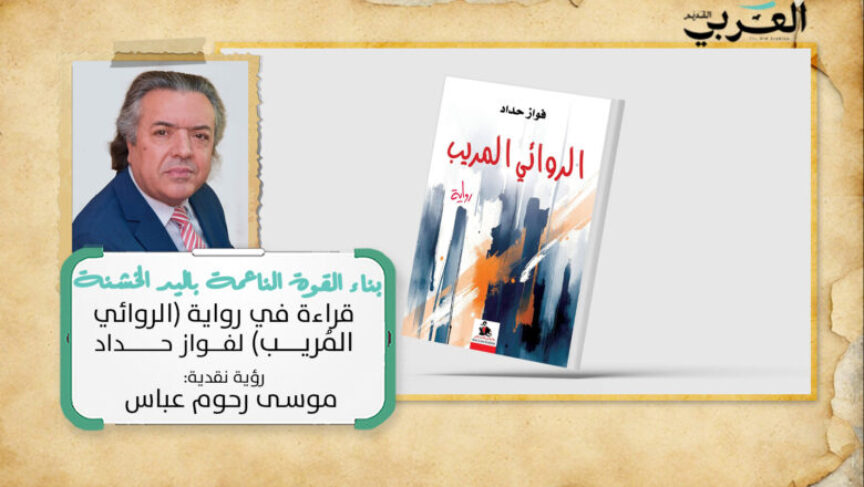نحن إذْ نقف برواية ” المترجم الخائن ” للروائي السوري فواز حداد – دار الريس ، طبعة أولى / 2008 / – سنجد في العنوان صوى وأصداء لمقولة بسطت ظلها على الوسط الثقافي عموماً، والأدبيّ – على وجه التخصيص – مفادها أنّ ” كلّ ترجمة هي خيانة للنصّ الأصليّ ” هذا إذا تجاوزنا الإسراف في توصيف الكتابة ذاتها بعيداً عن التقريض، كما جاء على لسان الروائيّ الفرنسيّ جان جينيه مثلاً، والتي يذهب فيها إلى أنّ “الكتابة هي الملاذ الأخير لمن خان”!
إذاً ما جديد الحداد في هذا العنوان، ومن ثمّ في المتن المُتواري خلفه!؟ وفي الجواب قد يتعجّل أحدنا فيرى بأنّ الرجل لم يضف إلى المُعرّف جديداً، وأنّه فسّرَ الماء – كما تقول العرب – بعد الجهد بالماء! غير أنّ إعمال الفكر مليّاً سيكشف لنا ذكاء اللعبة التي مارسها الحدّاد على قارئه، إذْ لماذا يعمد روائيّ معروف إلى عنوان واضح يُفسّر ذاته!؟ من هذا السؤال المُلتبس – في وضوحه المُحيّر – ستتوالد أسئلة أخرى تبحث في العنوان ومتنه، ثمّ تحلّل العلاقة بينهما، ولذلك قد نبدأ بالتساؤل التالي : أن هل الترجمة – حقاً – خيانة للعمل الأصليّ!؟ وإذا كانت خيانة فكيف للشعوب أن تتبادل ثقافاتها وتجاربها !؟ كيف يتأتى لدول لا تسهم في إنتاج الحضارة المُعاصرة اليوم – ونحن من أولاء – أن تشتغل على جنس وافد كالرواية، باعتبارها إنجازاً للبورجوازيّة الأوروبيّة في مسار صعودها، ناهيك عن أنّها – بحسب جورج لوكاتش – في أسّها وريثة شرعيّة لفنّ الملحمة، ولكن بعد أن أسقط الروائيّون منها تاريخ الملوك، ومن ورائهم الآلهة التي كانت تنتصر لهذا الملك أو ذاك، لتلتفت إلى جموع المُهمّشين، باعتبارهم المُنتجين الفعليّين للخيرات الماديّة في المُجتمع، والمُستهلكين الأساسيّين للثقافة والفنون، وحاملي مشاريع التغيير يميناً ووسطاً ويساراً!؟
على هذا ألن نشتغل عليه بدلالة نظرية الرواية للوكاتش؟! أليس هذا حالنا في الأدب على وجه العموم، إذْ لا نستطيع أن نجزم في ما إذا كنّا أبناء شرعيّين لنثر الجاحظ والتوحيديّ وابن المُقفّع، لكنّنا – بكلّ تأكيد – سنجزم بترّسمنا الدرب في ضوء نظرية الأدب الغربيّة لرينيه ويليك على سبيل التمثيل!؟ ثمّ هل تفترق الحال في النقد – كمُمارسَة تاليه على الأدب – عن غيره من ضروبه؟! أليس ما نكتبه – في مُعظمه – في هذا الجانب صدى لرؤى تزفيتان تودورف وجاك دريدا ورولان بارت وكلود ليفي شتراوس ونورثروب فراي أو بلينسكي أو تشيرنشيفسكي!؟ ترى كم من نقادنا يشتغلون بدلالة القاضي عبد القاهر الجرجانيّ أو الآمدي أو ابن قدامة أو ابن جعفر على سبيل التمثيل!؟ وإذاً فهل ثمّة بديل عن الترجمة للقيام بما تقدّمَ من مهام!؟
بهذا المعنى يكون الحداد قد خاتلنا، واجترح عنواناً يُشكّل عتبة تمهيديّة لمتنه، ذلك أنّ أيّ عنوان ينهض بوظيفتين.. سيميائيّة ومعرفيّة، وذلك عبر إشارات أو علامات تذهب بنا نحو فضاءات النصّ وعوالمه، من غير أن تتورّط في فضح أسراره دفعة واحدة، لأنّها – إذ ذاك – تقتل لعبة التشويق التي يقوم عليها، ومُخاتلته هذه دليل نجاح في إحالة المُعرّف إلى خانة التساؤل، فالتحرّي بقصد الوقوع على أجوبة تسدّ الأفق أمام المُقلق والمُثير للتوجّس، ما سيدفع القارىء إلى تقرّي الأجوبة من خلال المتن، أي أنّها ستكرهه على قراءته، وهذه إحدى الوظائف الرئيسة للعنوان!
اشتغل الحدّاد على الحياتي – إذاً – عبر المُترجم حامد سليم، فرسم صورة نمطيّة للمُثقف في عاداته اليوميّة، التي لا معنى للكثير منها، وبذكاء بيّن بأنّه يعيش دواخله المُتشظيّة أكثر ممّا يعيش علائق سويّة مع الآخرين، لهذا كان – على الأغلب – غير قادر على التكيّف مع وسطه، فزوجته مُتخاصمة معه، لقد غادرت وولديها إلى بيت أهلها، ومُشكلته – هذه – قطعاً ستحيل إلى الاجتماعيّ، أي إلى زمن مُحدّد، لكن بعد أن نسخ عنه الروائيّ التحديد الرقمي مثلاً، لتحيل إلى عالم ذكوريّ فظّ، ولا تخلو من بعدها الاقتصاديّ، ذلك أنّه يعيش القلّة تحت هاجس الرسالة والمُثَل والقدوة، ثمّ أنّها بالضرورة نفسيّة أيضاً، إذْ أنّ المُثقف المُعاصر في علاقته المُرتبكة والشائهة مع مُحيطه، ابتداءً بعلاقته المُلتبسة بالسلطة، وانتهاءً بعلائقه الواهيّة بمُحيطه الاجتماعيّ، غبّ أن وهنت لغة التواصل بين الطرفين، نكص نحو الدواخل القصيّة، ليعيش حلماً مُنكسراً أو أوهاماً تخلقّت على هيئة حقائق، مُتخيّلاً أنّه مُثقف عضويّ بتعبير غرامشي، في حين أنّه ليس أكثر من مُتعاطف مع الشرائح الفقيرة، تلك التي تحدّر منها، غير أنّه – بالتأكيد – لا يرتضي لنفسه أن يكون محلّها!
ولأنّ الترجمة بحدّ ذاتها عمل يتحصّل على خصوصيّة، عبّر عنها الحداد بالمُدلهمة / المُكفهرة، في علاقتها الخاصة بالنفسيّ، ليمّر – من ثمّ – بالوسط الثقافي، وهو وسط مثاليّ افتراضيّ بين الناس، ليكشف كم هو شائه في علاقاته، ويلعب على دلالات الأسماء، إذ يشي مقال الناقد المعروف شربف حسني – عن المُترجم حامد سليم – بغياب التقاليد الثقافيّة، في سلوك يفتقد إلى الشرف، أو إلى صديقه سامي الذي يعتذر من حامد، وبذلك خلا سلوكه من السمو، أو الشخصيّة المُوازية لحامد تحت اسم عفيف الحلفاوي، في حين يفتقد سلوك الاثنين إلى العفة أو التحالف الإنسانيّ، أو المُستشار حكيم نافع، في سلوكه المُنحط وانتهازيّته المُقزّزة، فهل جاء حامد من فعل الحمد؟ وهل يقوم الحمد على القلة؟ إنّ شريف إذ يهاجم ترجمات حامد يناقض نفسه، أي أنّ سلوكه على عكس أسمه لا يتأتى على الحسن من الأفعال، حكيم يتصف بالانتهازيّة لا الحكمة، ويستحيل على الانتهازية أن تكون نافعة إلاّ لأصحابها، ولا نعتقد بأنّ محمود تفكّر في أن يكون محموداً من الآخرين كقاتل مأجور، ناهيك عن أنّها – أي الأسماء – تشير إلى شخوص ينتمون إلى عالم مُحدّد في المكان والزمان، وقد يحيلوننا إلى شخوص نعرفهم!
بهذا المعنى سنعود إلى لوكاتش مُستنجدين، لنقول بإنّ شخصيّات الحداد إشكالية بامتياز، لقد حشرها جميعاً في لحظة المُفارقة، فتساقطوا كأوراق الخريف إذ تتحرّك الريح!
في هذا الفلك المّشوّه – إذاً – تدور شخصيّات الحداد، ما يشي بالتسلق وغياب التقاليد الثقافية، ناهيك عن الجهالة بين أنصاف الموهوبين، أمّا المرأة فعلى عكس ما هو مُتوقّع في وسط نخبويّ، يتحدّد عالمها بين المطبخ والسرير، برغم رغبتها في التميّز، عبر كتابة النصّ المفتوح مثلاً!
ثمّ إنّ قراءة أوليّة في المتن، ستدفعنا إلى الإقرار بنجاح الحداد في التخلّص من مطبّ التاريخيّ.. التاريخيّ المُعاصر في أفقه السياسيّ، الذي شغل الكثيرين، ذلك أنّ عدداً غير قليل من الروائيّين وقع في هذا الفخّ، إذْ تصدّت رواياتهم لمرحلة مُعيّنة من التاريخ المُعاصر، فتحدّد زمنها بين نهايات العهد العثماني وسنوات التحرّر الثلاث 1918 – 1920 مثلاً، أي في أعقاب نجاح الثورة العربيّة الكبرى التي قادها الشريف حسين 1916 ، والتي شكلّت المرجعية الأساس لمُجمل النثر العربيّ الحديث، إذْ رسمت حلم العرب في بناء دولة مُتحرّرة وعصرية في مشرق الوطن العربيّ، ولا نظن بأنّ مغاربه كان بعيداً عن هذا الحلم، الذي جسّد حلم الجمعيات العربية السرّيّة في بناء دولة عصريّة، بعيداً عن الاحتلال العثمانيّ، وفي ردم الهوة بينها وبين العالم المُتقدّم، ثمّ إنّها تناولت مرحلة الاستعمار الأوروبي لمعظم البلدان العربية، أو تناولت الاستقلال، فتسنّمِ العسكر للسلطة في أعقاب هزيمة الـ 48 أمام إسرائيل، وذلك في ظاهرة عالمثالثيّة بامتياز، وتوطّد دولة العسف – من ثمّ – مُدجّجة بأجهزتها السرّية والعلنيّة وسجونها، لتقف بالراهن في تخومه المُشكِلة لأكثر من سبب!
لقد نفّذ الحداد روايته بالاعتماد على السرد التقليديّ، فحضر الفعل الماضي في مُجمَل الخطاب الروائيّ، ليُحيلنا إلى ضمير الغائب الشهير ” هو ” نحن إزاء السارد العليم إذاً، لكنّه عمد إلى تقانات فنيّة لكسر رتابة السرد، فعمد إلى التقطيع، ما سمح له بالتنويع في زوايا الالتقاط، لكي تتمكّن الأنساق اللغويّة من الإحاطة بأفكارها على اقتدار، أو إتاحة الفرصة للشخصيّة الأخرى، حتى تعبّر عن نفسها بحدود، كسراً لرتابة المسرود ، على ألاّ يُفهم – ممّا تقدّم – أنّنا بصدد إخراج السرد من جنّة القصّ، لقد تجاور السرد بأنماط أخرى من التعبير أكثر حداثة، ليس هذا فحسب، بل إنّ الشكلانيّين الروس – تشيرنشيفسكي – يرون في السرد بنية مُعقدّة ، تحكم زاوية الالتقاط، وعلاقة الأجزاء ببعضها، فعلاقتها بالكلّ، فإذا أحسنت التوليفة جاء المتن غاية في الجمال!
إنّ الزمن في ” المترجم الخائن ” فيزيائيّ، لا لعب فيه، ولا محاولة لكسر رتابته، فهو يسيل من الماضي نحو الحاضر فالمُستقبل، مع أنّ المتن كان يسمح بزمن مُنكسر، وذلك بتقسيم مستويات السرد إلى أجزاء مُرتبة ترتيباً قصدياً مُضمراً، مرة لمصلحة التشويق عبر التقديم والتأخير، ومرة لضخ مزيد من التوترّ الدراميّ لمصلحة ذلك التشويق، ثمّ لتقول مقالة الرواية مُضمَر، ثمّ أنّ الزمن الدائري لم يكن هو الآخر بعيداً عن الإمكان، ما كان سيكسر رتابة السرد، بيد أنّ الروائي ارتأى الاشتغال على توليفة مُتناغمة ، فاشتغل زمناً يتناسب ومقام السرد، وإن كان القول بسرد استعاديّ – عبر تذكّر الشخصيّات لمواقف أو أحداث وقعت لهم – وارداً بحدود!
ثمّ إنّ الحداد سينجح في تلافي مفهوم البطولة، ذاك الذي يتكىء إلى عدد الصفحات التي تشغلها هذه الشخصيّة أو تلك، على هذا تضحي فاعلية الشخوص وتأثيرها في الحدث مقياساً لبطولتها، على هذا يتحدّد مفهوم البطل بالشخص المناسب في الزمكان المناسب، وقد لا يجافي القول ببطولة جماعية المنطق بكثير، فالحلفاوي يوازي حامد، وحامد يوازي شريف، لكنّ حدادا يحشرشخوصه في مآزق فتنكسر ربّما لأنّها شخصيّات مهزومة، مهزومة في علاقتها بالسلطة، ومهزومة في علاقتها بالوطنيّ، خاصة إذا استرجعنا مسار الصراع العربيّ / الإسرائيليّ!
وكما في العنوان يحضر المكان إضماراً، هو لا يسمّيه، لكّننا نعرف بأنّه يقصد دمشق، بما هي عاصمة، كيف؟! عبر انتقال بعض شخوصه من البلدات البعيدة إليها، فهل نسخ الحداد الاسم لمصلحة النمذجة؟! ذلك أنّ بلدان العالم المُخلّف تتسم بتركّز الفعاليّات في عواصمها، ليُسجّل المكان حضوراً واقعياً يبيّىء العمل، وحضوراً نفسياً يحيل إلى نظرة شخوصه إليه، إلاّ إنّ الروائيّ لم يبدُ مشغولاً بأسطرته، لينسب إليه حضوراً سحريّاً، يحوّله إلى فضاء روائيّ، يندغم بمصائر شخوصه، ويقف إزاءهم كندّ وكبطل!
أمّا لغة الحداد فتحيل إلى التعبيريّ، هي – من كلّ بدّ – تتجاوز وظيفة التواصل، ناهيك عن تحصّلها على السلامة اللغويّة، لتندرج في نسيج فنّيّ روائيّ، ندرك – من خلالها – كيف تبنى الجملة الروائيّة، لكنّها لا تعنى بالبلاغة كثيراً، فهي تخلو من الديباجة والتوريات، لكنّ القول بخلوّها من الجماليات يجافي الحقيقة، هي لغة مُقتصدة، تمّ الاشتغال عليها بدلالة اقتصاد لغويّ كمبدأ، لتتحصّل على رصانة وإيجاز، إنّها ترسم علاقة الدال بالمدلول عبر خطّ مُستقيم، ما أبعدها عن الضجيج والتقعّر، لقد استمدّت شاعريّتها من الحدث لا من اللغة، من غير أن ننكر عليها تلوّنها لتحيط بحدثها كما ينبغي!
تتحرّك شخصيّات عديدة في المتن، ليتلون كلّ منها بما ينفذ رغباته وأحلامه، لذلك سيصعب إغلاق تلك الشخصيّات درامياً، لكنّ تراجيديّات حياتهم تنبىء بالخواتيم، برغم أنّ المتن يشي بنهاية مفتوحة على غير تأويل أو استنتاج!
بقي أن نشير إلى أنّنا قدمنا قراءة ذاتيّة في قضيّة خلافيّة، ذلك أنّ العمل الفنّيّ يحتكم إلى الذائقة، على هذا تتأبّى الذائقة البشريّة على التنميط، ما سيضعنا أمام قراءات تتعدّد بتعدّد قرّاء العمل ما يثريه، ويثير حوله الآراء!
لقد نجح الحداد في استثارة فضولنا عبر عنونته للرواية، كما نجح في رسم عالم روائيّ تتحرّك فيه شخوص تحيل إلى الواقع، وتنفصل عنه، شخصيّات مقنعة في سقوطها التراجيديّ، ألم يكُ ذلك دأب الحداد في غير عمل؟! ولنا في روايته ” جند الله ” خير مثال، ولأنّ قراءتنا ذاتيّة، فهي تحتمل الكثير من الأخطاء كما تحتمل الصواب، ما قد يقتضي الإشارة!
21 يناير 2026