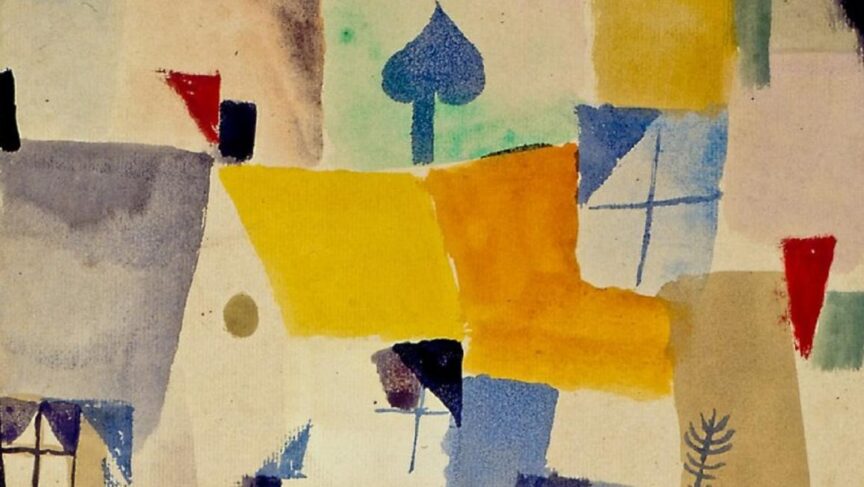يزعم الروائيون أنهم الأقدر على البحث عن الحقيقة، لا يمكن الثقة بهذا القول، لسبب بسيط، افتقادهم للأدوات، فلا أساليب بحث ولا مناهج، وليسوا فلاسفة أو علماء اجتماع، أو أطباء في علم النفس، ولا مؤرخين. ما يجعلنا نتساءل: ما الأدوات التي بحوزتهم، أو ما الذي يتمتعون به؟
ليس لديهم كل هذا، لكنهم يملكون أكثر منها، تلك البراءة من الأدوات والمناهج… فلنقل اختصاراً، النجاة من القيود، هذا امتيازها، أما الروائيون الذين ارتاحوا إلى القيود وتشبثوا بها على أنها المعرفة المتكاملة، فوجدوا بغيتهم في الأيديولوجيات.
منذ نشأة الرواية، لم تكن مهمتها محصورة بهدف، أكثر من التسلية والمتعة، وما تلهمها به قريحة الروائيين من أحداث متخيلة، أشبه بالأساطير، ثم قفزت إلى التاريخ، هناك ذخيرة لا تنضب، خاصة أن ما يحدث اليوم يصبح تاريخاً في الغد، ولم توفر علم النفس، وتنطعت لأدوار معرفية وفلسفية، وجودية وسياسية، أخلاقية واجتماعية، ولم توفر العلم، حتى أنها زجت به في المستقبل.
واحدة من أعظم مزايا الرواية هي الحرية التي توفرها للروائي
ما أنجزته أنها استفادت من كل ما تأثرت فيه. وأتاح للرواية مساحة يتقاطع فيها الأدب بالفلسفة، والسرد بالتأمل، فامتلكت وسائل فعّالة للبحث عن الحقيقة، لا باعتبارها حقيقة مطلقة أو نهائية، بل باعتبارها تجربة مستمرة في التفسير والتأويل.
هل هذا ما أهلها لمساءلة العالم؟ نعم، لكنها لم تظفر بجواب نهائي ولا شاف، ما اضطرها إلى تفكيك الواقع بمختلف عناصره، من دون استثناءات، بغية النفاذ إلى حقيقته. انطلاقاً من هذا التصور، يمكن النظر إلى الروائي باعتباره باحثاً عن الحقيقة، يستخدم أدواته السردية والمعرفية لاستكشاف أعماق الوجود الإنساني والواقع الاجتماعي، من دون التنازل عن الجمالية مع طموح فكري، لتقديم رؤية متعددة للعالم، ومتنوعة إلى حدود التناقض في ما بينها، وإلا كيف بوسعه العمل في عالم يعج بالتناقض. أما لماذا أو كيف؟ فالرواية، في عمقها الجوهري، لا تنصاع للخطاب الأحادي المبني على التبسيط أو الأيديولوجيا المغلقة، كما أن الروائي لا يُقدِّم أطروحة جاهزة، وانما عمارة في طور البناء دائما، تظهر من خلال سرد يُتيح للقارئ رؤية العالم من السطح والعمق.
إن الرواية، بما تملكه من طاقة تعبيرية لا حدود لها، تعد الأقدر على أداء هذه المهمة، لما تتميز به من قدرة على طرح الأسئلة الكبرى في بنية سردية تتسم بالمرونة والانفتاح ذات قدرة لا تُضاهى على التعبير عن التجربة الإنسانية. إنها لا تقتصر على نقل الأحداث، بل تنزع نحو تحليل البنية العميقة للواقع، عبر أدوات فنية مثل السرد وتيار الوعي، وتعدد الأصوات، والانغماس في الذات، مع تعدد النظر إلى القضايا الاجتماعية والوجودية. وتعيد تفكيك الثابت واليقيني.
هذا ما يجعل الرواية فنّاً كاشفاً، ويمكّنها من مساءلة الحياة وتفكيك العالم، وفتح المجال لظهور “الآخر” والمهمّش والمسكوت عنه. في هذا السياق، تغدو الرواية ميداناً لسبر الواقع، عبر الأدب.
واحدة من أعظم مزايا الرواية هي الحرية التي توفرها للروائي، لا حرية التعبير فقط، بل حرية التجريب، والتجاوز. فالرواية لا تتقيَّد بقواعد صارمة، بل تحتفي بالانزياح، وبالأسئلة المفتوحة. هذه الحرية تُمكِّن الروائي من أن ينتزع دور المحقق البوليسي، ينقب مثله، ويرى مشهد الجريمة بأبعاده كلها، لا يغفل طرفاً على حساب آخر، من دون الادعاء باليقين، بل عبر لغة الفن والانفعال.
هكذا يتعامل مع الواقع، تستأثر به التفاصيل، ولا يغفل المشهد العام، والأطراف التي تتجاذبه، وما يدور داخله، وما يحركه من الخلف، ما يظهر منه، وما يختفي وراءه، والأكاذيب التي تطفو على السطح.
إضافة صغيرة، لا يمكن أن يكون الروائي التلميذ النجيب للحقيقة، ولا البحث عنها مجدياً، لولا الشك المقيم في داخله، ومثلما ينبغي أن يثق بالناس، يجب أن يعرف بأنهم قد يعادون الحقيقة، ويتخفون عليها، ولا يتورعون عن دفنها.
كم مهمة الروائي صعبة ومعقدة، هذا اذا أراد أن يكون منصفاً.
-
المصدر :
- العربي الجديد