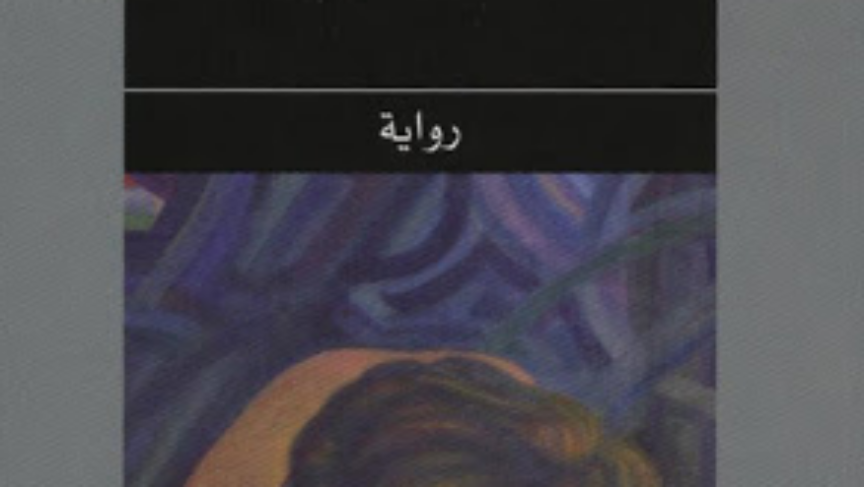أذكر، وكنت قبل أكثر من عشرين عاماً قد حملت مخطوطة كتابي (فيروز والفن الرحباني)، لتقديمها لدار الريس للكتب والنشر، أنني كنت في مكتب الأستاذ رياض نجيب الريس في بيروت، حين دخل أحد قراء النصوص المعتمدين في الدار مخاطباً إياه بدهشة وتعجب: “شو هيدا فواز حداد… شو هيدا اللي عم يكتبه”، وامتد الحديث… ثم تصادف خلال جلستنا أن رنّ جرس الهاتف، وما إن رحب الأستاذ رياض بالمتصل، حتى ضحك منتشياً، وقال بصوته المفعم بالحيوية والحماس: “صديقنا وقع بحبائل فواز حداد يا سعاد”.
وقدرت أن المتصل هي الزميلة سعاد جروس، التي ظلت تربطها بالأستاذين رياض وفواز علاقة وطيدة، حتى رحيل الأول وهجرة الثاني… لكنني أعجبت بتعبير الأستاذ رياض الذي وصف سحر أدب فواز حداد بعمل السحرة وحبائلهم… وعدت بذاكرتي إلى ما قبل عشر سنوات مضت من ذلك اللقاء، حين سحرتني رواية (دمشق موازييك 39)، التي قرأتها مأخوذاً باسم دمشق على الغلاف، لا اسم فواز حداد المجهول حينذاك… فمن عادتي أن أقتني كل كتاب يحمل اسم دمشق، سواء كان الكاتب معروفاً أو مجهولاً. وما إن انتهيت من الرواية، حتى صار اسم فواز حداد أثيراً لدي، وطفقت أبحث عن عنوانه، أو رقم هاتفه لأجري أول حوار صحفي معه حول روايته تلك، نُشر في مجلة (الكفاح العربي)، حيث كنت أعمل، وكان عام 1992 على ما أذكر.
يحمل الأدب العظيم سمة الاكتشاف، لا الاطلاع أو القراءة وحسب. إنه شيء تشعر أنك تكتشفه، مثل الثروات الباطنية أو المعادن النفيسة أو الآثار الخالدة… وعلى مدار عقود كلما أهديت رواية لفواز حداد، لأحد أصدقائي ومعارفي، ممن لم يقرؤوا له من قبل، كان يسألني أسئلة تنم عن دهشة الاكتشاف، وأحياناً صدمته اللذيذة، تذكرني بعبارة رياض الريس عن الوقوع في “حبائل فواز حداد”. وحين أهداني الأستاذ فواز روايته (السوريون الأعداء)، إثر صدورها عام 2014 شعرت مجدداً، أنني أمام اكتشاف جديد، أمام روائي شجاع وحر وجسور، يقوم بواجب تاريخي كان يجب على أحد الكتاب السوريين العظام، ممن عاصروا زمن المجزرة وما بعده أن يقوموا به، وهو تخليد مجزرة حماة في ذاكرة الأدب بعمل ملحمي رفيع المستوى، كي لا ننسى، وكي لا نغفر، وكي لا نقول: ما من عمل كُتب بمستوى مجزرة حماة، ننصح به أبناءنا أن يقرؤوه. لقد قام فواز حداد بالواجب الإنساني والأخلاقي والأدبي ممتلئاً بالضمير والموهبة، وحس الانتماء للضحايا… إلى الدرجة التي جعلتني أسير هذه الرواية لسنوات، لم أستطع أن أتحرر منها، حتى ألّفت كتابي عنها: (ضمير المتكلم: المواجهة الطائفية في رواية السوريون الأعداء).
كثيرون اليوم يعرفون اسم فواز حداد… فالأديب الذي لا يظهر في وسائل الإعلام المرئية البتة، يواظب على نشر الروايات وكتابة المقالات، والحضور في سجالات أنيقة ومترفعة على السوشال ميديا. لكن في عصر المعرفة بلا قراءة… معرفة القص واللصق، معرفة العناوين والمانشيتات، من يقرؤون لفواز حداد، هم أقل ممن يدعون معرفته وصداقته والاهتمام بأدبه. وهذه علة عصر تتشابك فيه الأمراض، وتتوالد فيه مصائب الثقافة، حتى بوجود مثقفين كبار في عصرنا.
إن الاهتمام بأدب فواز حداد اليوم، هو وجه أصيل وأساسي من وجوه الاهتمام بالأدب السوري وارتقائه وتطوره. وهو غوص عميق في سوريتنا: هوية وأسئلة وقضايا وهموماً وآلاماً وأوجاعاً. فقد عالج أدب فواز حداد بصدق وجدية كل هذا في الحياة السورية المعاصرة، وكان الأديب الأبرز الذي لم يتخذ مكاناً وسطاً بين الثورة وما عداها… فقد انتمى إليها وسماها وتحدث عنها بإسهاب، ولم يغفل عن عيوبها وانحرافاتها، مثلما لم يغفل عن تطلعاتها ومشروعيتها وتضحيات أبنائها. و(العربي القديم)، إذ تقدم هذا العدد الخاص عن فواز حداد، وهو بيننا تؤكد مراراً وتكراراً أن زمار هذا الحي يطربنا، وأن علينا أن نحتفي به، وهو بيننا بدل أن نتباكى على غيابه يوماً، ونكتب المراثي الإنشائية عنه، وعن آخر رسالة بعثناها له، وآخر صورة التقطناها معه. شكراً فواز حداد؛ لأنك أضفت لعصرنا وثقافتنا.
-
المصدر :
- العربي القديم