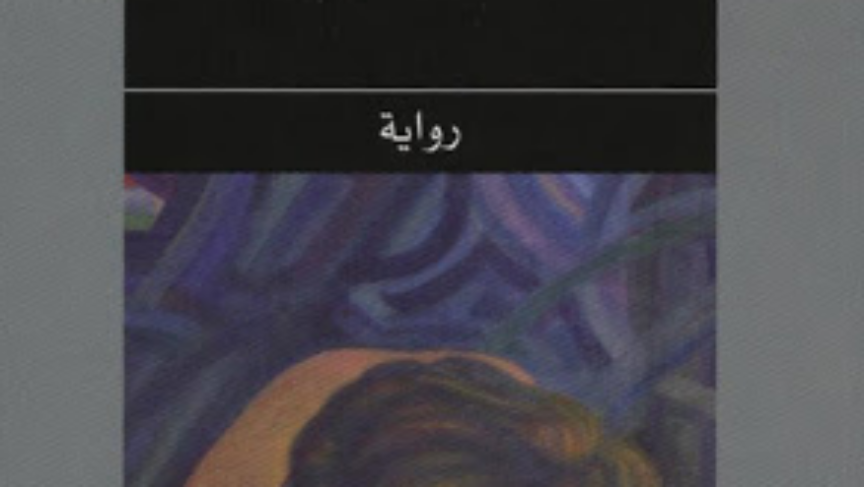تقدّم آخر أعمال الروائي السوري فواز حداد، «الشاعر وجامع الهوامش»، حكاية غريبة عن شاعر كلّفه جهاز سياديّ أعلى مكلّف بالدفاع عن النظام السوري بجولة أدبية مزعومة كقناع لمهمة يتابع خلالها تطوّرات حدث غريب في قرية جبلية، بدأته مجموعة من الضباط المتقاعدين الذين قرّروا إنشاء «دين جديد» (وبدأ ذلك تحت دعوى بعث الدين بالعودة إلى الأصول، ونشر العقيدة بعد تجديدها)، وما لبثت أن نافستهم على الدعوة مجموعة من الشباب، وهو ما جلب انتباه النظام لكيفية استغلال هذه الظاهرة لفائدته.
يكتشف الشاعر (وهو لا يعدّ نفسه شاعرا)، الكثير من المفاجآت، بدءا من اختياره، وهو الشخص الذي ترك مسافة اعتراض بينه والسلطة، وبالتالي فلا ولاء مباشراً لديه للنظام، والذي تجمعه علاقات بأشخاص يعملون مع الثورة، ليكتشف، بعد ذلك، أن النظام كان قد ساهم في صعوده.
تبلبل الشاعر هذه المعلومة (ردا على سؤاله لماذا لم يختاروا غيره يرد ممثل النظام: إنهم عملاء لنا أكثر من اللزوم)، لكن ذلك لا يمنعه من إكمال المهمة المكلّف بها، من دون أن يشعر بخسران لذاته، أو تناقض مع مبادئه.
يدخل في باب المفاجآت أيضاً أن هذا المكلّف بحلّ صراعات لاهوتية مستجدّة في بلدة علوية السكان هو من الطائفة السنية، وهو أمر يُفهم أيضاً على الخلفية التي شرحها ممثل النظام من حاجتهم لشخص يستطيع أن يقدّر الأمور ولا يكتفي بالمبالغة في أخذ موقف النظام.
يفتح الطابع «الثقافي» للمهمّة الباب لأهل البلدة للتعامل مع مأمون الراجح، بطل الرواية، بداية، كمنتوج ثقافي للعاصمة، ولكنّه لا يلبث أن يدخل في خضم صراعات مراكز القوة في البلدة، كضابط الأمن، وفرع الشبيحة، بالتوازي مع العلاقة الملتبسة مع خالد، الممثل الواقعي/الأسطوري للنظام وحساباته المعقدة، التي تحاول الحد من اشتطاط الضباط والشباب، والاشتغال على فكرة بناء «الدين الجديد»، والحفاظ على التناقضات بين جميع الأطراف.
تفتح الرواية عددا من التفريعات الضرورية، كقصة الصحافي حسين، الذي تعامل مع تنسيقيات الثورة في توثيق الضحايا والانتهاكات، وانتهى به الأمر متابعا لقضية تحوّل الاغتصاب إلى سلاح منهجي معتمد لدى القوات التابعة للنظام، وهو ما أدى في النهاية إلى موته، في عز الاشتباكات «الثقافية» و«اللاهوتية» التي كان مأمون يشرف عليها في قرية مغربال، وهي إحدى المفارقات التي اشتغل عليها الروائيّ لإظهار الوضع الغرائبي السوريّ.
التفريعة الأخرى، والتي تستمر طويلا داخل الرواية، هي علاقة الشاعر بفتاة مسيحية، على خلفية اعتراضهما على النظام، واكتشافه لاحقاً أنها تركته وعادت إلى زوجها السابق، وهو جرح لا يتمكن بطل الرواية من لأمه، ويساهم، بدوره، في الإضاءة على أشكال الخذلان التي حفلت بها سوريا بعد الثورة، وارتباطات ذلك، أو عدم ارتباطها، بجدل الفرد / الجماعة، فخالد، المشرف الأمنيّ الأكبر على كل ما يجري، يعتبر تركها للشاعر عودة طبيعية إلى طائفتها، وخفّة تميّز النساء، ويؤنب البطل على انشغاله بهذا الأمر الطفيف، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أحداثا كبرى خطيرة.
أطوار السلطة وتجلياتها
تشكّل شخصية خالد، استمرارا للشخصية (الفكرة) نفسها التي كانت موجودة في «السوريون الأعداء»، واستمرارها يقدّم تشريح فواز حداد لطبيعة النظام المفارقة والمحايثة في الآن نفسه.
السلطة في الرواية مفارقة بطابعها المتجبّر العُلويّ المتغطرس الذي لا يعتبر سكان البلاد، سواء كانوا معارضين أو موالين، إلا مواضيع لتنفيذ السلطة وحيثية مطلوبة (وإن لم تكن ضرورية بالمطلق) لممارستها. السلطة موجودة بالتفارق مع الآخرين، وبالتعالي عليهم، وهي موضوع ذاتها الذي تعتاش عليه.
وهي محايثة بسبب تخللها لكلّ شيء ووجودها الضامن لاستمرار التوازنات والصراعات.
وبهذا المعنى، تتشابه السلطة، مع موضوع الرواية، وهو سبب انشغالها بالحدث «اللاهوتي» الذي يبدو مضحكا من بعيد، لاقترابه من فهمها، فتسعى لجعله مستعصيا وغامضا، أو منافستها، وهو ما تقاومه وتقضي عليه.
ولا يجد ممثل السلطة العليا حرجا في شرحها في نقد، على ما يبدو، لنقادها والموالين لها، وحسب هذا الشخص فإن «النظام في حالة تفكير دائم بتؤدة وعلى مهل ولديه الوقت لذلك وغالبا ما ينظر إلى البعيد، البعيد جدا»، وهذه الفكرة، على إطلاقها وفساحتها، تعطي ممثل السلطة، والنظام نفسه، طابعا ميتافيزيقيا، وهو ما يتوازى مع حدث الرواية الكبير نفسه، وهذه نقطة يمكن اعتبارها محورية في فكر الرواية، وتحتاج بالتأكيد حفراً فيها.
كوميديا سوداء / تراجيديا ساخرة
يحافظ الكاتب على تساؤلات روايته الممضة وسيرورتها الطبيعية رغم أن لا شيء طبيعيا يجري فيها، بدءاً من الاختلال الوحشيّ الكبير في الطبائع وأثرها الخطير على كل البشر، وصولاً إلى الحدث المركزيّ فيها، الذي يتبدى أحيانا على شكل كوميديا تزداد قدرتها على التهريج كلّما انهمك الضباط والشباب وفرع الأمن والشبيحة في محاولة التدخل فيها، وكلّما زادت ضحاياها والصراعات التي تشقها والاهتمام الذي يبديه النظام بها؛ وعلى شكل تراجيديا تودي بمصائر البشر الذين لا ينفكون عن الانخراط فيها، فيما تتداعى معانيها التراجيدية أيضاً وتنفرط فالمصائر لا تنصبّ بشكل عشوائي فحسب فكثيرون يقررون المشاركة في صنعها بإرادتهم.
تسير الرواية على هذا الخيط الرفيع من الأحداث السوريالية الهائلة في قسوتها ومساخرها، إلى جانب وحوالى الحدث الذي يخضّ القرية وأهلها، ويبدو منتزعاً من سياق ما يجري، بحيث يتنافس معه في الغرابة.
لا ينجو أحد في الرواية من هذا النوّاس العجيب، بمن فيهم البطل نفسه، الذي يستفيق، وهو الشخص المعترض في داخله على السلطة، وقد كلّف بمهمة يشرف عليها رأس النظام الأمنيّ، ويلعب هذا الاختيار الذي لا يتناسب مع تنميطات السلطة وكليشاتها، دوره في هذا الاهتزاز العامّ بين التراجيدي والكوميدي، فالبطل أقوى من ضابط الأمن المخيف في المنطقة، ولكنّه مجرد شاعر فاشل، تركته صاحبته، ولا وزن حقيقياً، في النهاية، لكل ما يفعله، غير أن يكون شاهداً على العبث والمحنة والانحطاط.
توظيف الطائفية
تتناول الرواية الكثير من الظواهر التي استفحلت إثر الثورة، أحيانا بشكل عضويّ ضمن العمل، وأحيانا أخرى ضمن تفريعات الحوارات، كما في فصل «سهرة تحت ضوء القمر: في التعفيش والمعفشين والمعفشين»، على خلفية حوار بين بطل الرواية ورئيس فرع أمن المنطقة الذي «يحلّل» أهمية الشبيحة بالقول إن «الجنود يترددون أحيانا إزاء القتل أما هؤلاء فمجرمون بالسليقة»، كما يستطرد بالحديث عن القتل بهدف «التعفيش» الذي «يتطلب قتل عائلات بكاملها»، مؤكدا أنه لا يجب لوم المعفشين «إنهم يدافعون عن الوطن».
مثير للتأمل، بعد جولات الشاعر، الذي لا يعتبر نفسه شاعرا، المعترضة على تفاصيل القتل والتشبيح والتعفيش وهول إجرامها أن يتواصل مع خالد، ممثل النظام، ليخبره أن ضابط الأمن «فظ، لا يحلل ولا يحرم»، فيرد عليه: «أنا مثلك لست مخيرا في التعامل مع أمثاله»!
وفي اشتغالها على خيوط التناقضات السياسي للطائفية تقوم الرواية بإزاحة القوالب النمطية لهذا المسألة، بحيث يكون الحضور الكبير فيها هو لثقل النظام الذي يبهظ حياة الجميع، رغم الانشطار بين مناطق الثورة، التي تسكنها أغلبية سنّية، ومناطق النظام، كقرية مغربال نفسها، التي يسكنها علويون يعانون بدورهم من استهتار النظام ليس بأرواحهم فقط، بل كذلك بعقائدهم الدينية نفسها، التي تصبح أيضاً موضوعاً للاستخدام الوظيفي، مثل كل شيء يلمسه النظام، مثل ميداس الإغريقي، الذي يحوّل كل شيء إلى ذهب، ولكن، في حالة النظام، يتحوّل كل شيء إلى وظيفة تفقدها معناها الأصلي، فتتحول إلى سلعة في المجهود الحربي للحفاظ على رأس النظام وأقطابه.
يقوم البعض، كالأستاذ أحمد، بالتحايل على هذا التوظيف الوحشيّ للطائفية، فيشارك في خدعة اختطافه لإطلاق سراح أفراد من قرية سنّية اختطفهم الشبيحة، وينال، مع انكشاف القصة جزاءه من الخوف والإرهاب واحتمال القتل.
جامع الهوامش
تظهر شخصية «جامع الهوامش» في مرحلة متأخرة من الرواية، وهي تقدم باحثاً متبتلا وزاهدا بالعالم يجد نفسه فجأة في صلب الصراعات والتناقضات القائمة، مع استعانة مجموعة الضباط به لإعانتهم على صد قدرات الشباب الثقافية.
الأستاذ إسماعيل، الذي استأجره اللواء، قائد حركة الضباط، تحت مسمى «المستشار»، مستعينا في ذاكرته بسابقة الاستعانة بالخبراء الروس، والذين لولاهم لكانت أسلحة الجيش السوري، خردة، بحسب اللواء، وصار هذا الشخص مناط اهتمام القيادة في دمشق، ومركز التفكير بموضوع الدين الجديد.
تحمل فكرة «جمع الهوامش» في توصيف الأستاذ إسماعيل محمولات عديدة، منها، فكرة استبطان الهوامش لما يمكن أن يقال في المتون، وإذا كانت هذه الفكرة تنطبق على فكرة الدين الجديد، ويستوحي، بالطبع، علاقة المذاهب الإسلامية المنشقّة، كالدين العلوي نفسه، بالمدرسة «القويمة» السنّية وسلطتها المعنوية، فإنها تتحوّل، لاحقاً، إلى فكرة الاستخفاء في الهوامش عن النظام نفسه، الذي يريد التلاعب بهذا الدين، وتحويله إلى عبادة للسلطة ورئيسها.
إلى هذه المحمولات المذكورة، فإن «جامع الهوامش» نفسه، هو شخصية وجدت نفسها في الهامش واستمرأت الحفر فيه، ولكنّه، مع إدخاله القسريّ، والذي ارتضاه لاحقا، في لعبة «المفكر» ذات الأبعاد السلطوية، يتعرّض لامتحان وجوده في المركز وتحت الأضواء أمام مهمة مستحيلة تقتضي أن يخرج من هامش نفسه الذي يرتضيه، إلى هامش النظام الذي يفرض عليه.
المسألة الدينية والمعضلة الأخلاقية
تدور بؤرة الحديث المركزية في رواية «الشاعر وجامع الهوامش» حول موضوع الدين، والذي أعطاه الصراع السياسي والعسكري في سوريا ثقلاً هائلاً، حيث أن أغلبية كبيرة من الفصائل المسلحة المعارضة للنظام تحمل رايات وأسماء دينية، كما أن جزءاً من الميليشيات الإيرانية التي تحارب في كنف النظام تحمل رايات دينية أيضاً، وهو ما خلق، حسب الرواية، فراغاً لدى جمهور النظام، لا تكفيه رايات الممانعة والمقاومة والشعارات التي لا تقنع أحدا والتي ظلت أجهزة النظام تتابع تردادها على مدى سنوات الحرب.
يتابع فواز حداد في روايته هذه خطا مهمّا ظهر في «السوريون الأعداء»، وفي أعمال أخرى، على شكل جدل بين ما يجري على الأرض، وما يجري في المخيّلة، ويعطـــــي في هذا السجال المحـــــتدم، مكاناً قلقاً لنقاش قضايا الواقع والفكر، سواء تمثّل ذلك بالدين وتمثّلاته الفكرية والأرضية، أو بالأفكار السياسية، أو بالأخلاق.
وبغض النظر عن حجم هذا السجال في روايات حداد، فإنه، موجود دائما في صلبها، كتعبير عن القلق الإنساني من انفلات الوحش البشريّ من دون إمكانية لعقله أو ضبط حدوده.
وتلعب هذه الفكرة، في «الشاعر وجامع الهوامش» دوراً كبيراً في سجالها المرير مع منطق الاستبداد الذي يقوم بتجويف كل شيء، ابتداء من البشر أنفسهم، وانتهاء بما يؤمنون ويعتقدون.
يتأكد الأستاذ إسماعيل، مع وصول الحكاية إلى خواتيمها، أن وحش الاستبداد لن يقبل بأقل من التهام روحه وإلغائها، وهو ما يجعله يتقبّل فكرة الموت بعد أن راودته أفكار السلطة والنفوذ.
وبدخول جرافة النظام إلى بيت «جامع الهوامش» المليء بالكتب وهدمها فوق رأسه، يكتمل المعنى الرمزيّ للرواية، مع إنهاء النظام لأي هامش ولأي فكرة لا يكون الخضوع المطلق هو هدفها.
-
المصدر :
- القدس العربي