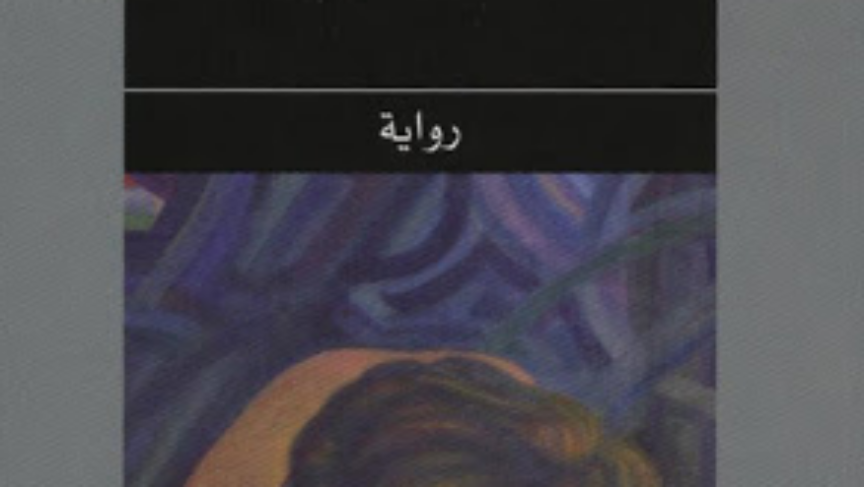صعوبة الحوار مع الروائي السوري فواز حداد لا تكمن في المساحة الغامضة أو المنسية. تلك التي رافقت مسيرته الروائية نتيجة بعده عن الإعلام لسنوات طويلة، أو ربما نتيجة خوف. الاخر، من الخوض في عوالمه الروائية التي اشتغلت على مناطق معتمة من التاريخ السوري. كان مجرد الحديث في الوسط الثقافي عن روايات فواز حداد في منتديات ومقاهي دمشق وحلب وغيرها من المدن والعواصم العربية كاف لأن يلتزم البعض. الصمت، صمت لا تستطيع تفسيره سوى على أنه رهبة الضحية على تحدي ومواجهة الجلاد، والضحايا دائما لدى فواز حداد شخصيات من لحم ودم تتماهى ضمن العجينة ” السبيكة الروائية ” ، على حد وصفه في هذا الحوار . يدخلون الرواية من بوابة. التخيلي، لنكتشف لاحقاً قسوة. الواقعي. من هنا ربما تكمن الصعوبة الحقيقية في محاورة. حيادية، مع فواز حداد الذي يجد في الحياد جريمة ، ولا يستثني من ذلك الحياد الروائي ” إغفال الروائي شيء مما يعتقده صواباً، أو تجنبه والتغاضي عنه، لا يعني سوى أنه يكتب رواية ما مسلية للترفيه عن النفس” .
.
1 لا ترم الماضي وراء ظهرك قبل أن تتصالح معه. قلت ذلك في رواية “مشهد عابر”، هل مازال هناك متسع للتصالح مع هذا الماضي ؟
الاوان لم يفت بعد، ولو كان هذا وقت دفن الضحايا، وإحياء ذكراهم. لا يمكننا تجاهل الماضى، ولا رميه وراء ظهورنا. نحن صناعته، فلا نبالغ بانكاره، إلا إذا أردنا نفي وجودنا نفسه؛ حاضر في تلافيف حياتنا، وفي نظرنا إلى المستقبل، ولئلا يصبح عائقاً، لا مفر من التصالح معه، بالتعرف إلى وجهه الحقيقي، لا المزور. إنه بشكل ما، يجعلنا نكتشف أنفسنا، وأخطاء توارثناها، وندرك أننا لم نأت من فراغ، بالتالي لن نذهب إلى فراغ؛ لدينا ما نفعله وما نقوله.
من الخسارة وقصر النظر، البدء من الصفر، بينما علينا مواصلة مسيرة في جوهرها إنسانية، لم تغب عن الأجيال السابقة، وهذا ليس من قبيل التنفج ولا التزيد. فلننظر إلى تاريخ الشعوب الأخرى، ليست أقل دموية ولاعقلانية مما يعج به التاريخ، مع أنه ليس هكذا تقارن الحضارات، ولا مسوغاً للصفح عن الماضي. وإنما للكف عن جلد الذات، وكيل الاتهامات لتاريخ نجهله أكثر مما نعرفه. نحن جزء من ماضي البشرية، يحمل تاريخنا في داخله العظمة الأخلاقية والدناءة التسلطية. اذا كنا نخشاه، ونتستر عليه، فلن نستطيع المضي نحو المستقبل.
الماضى قيد، والتخلص منه ليس بتحطيمه، بل بكسر ما يقيدنا إليه، وإلا لن تزول القبضة الحديدية للأنظمة التي تحكمنا وتتحكم بمصائرنا. النظام الشمولي يستمد سنده من هذا الالتباس، الأجدى الا يكون الماضي تبريراً لحاضر أسود.
2 يقول البعض أن الحراك السوري كان يحتاج إلى حوامل فكرية يضبط إيقاع الشارع ، وآخرون قالوا : لا بديل عن الخوض في هذا المستنقع رغم ارتفاع منسوب الدم، هل تتفق مع ذلك. أم لدى فواز حداد رأي آخر؟
اضطرت الثورة الشعبية إلى الخوض في هذا المستنقع الدموي، دفعهم النظام إليه، واستجرهم إلى مواقع كانوا فيها أهدافا سهلة له، فإذا كانوا حملة بنادق، فالنظام يمتلك دبابات وطائرات، ثم اتهمهم بالإرهاب، واستخدم كافة الوسائل لتدمير الثورة، لم يراع كل ما حرمته القوانين الدولية. كان الحامل الفكري الذي جند به جيشه، وميليشياته وشبيحته هو “الأسد أو نحرق البلد”.
بينما نشدت الثورة الحرية والعدالة باسقاط النظام. وكانت شعارات، أما الحوامل الفكرية، فالظلم الذي تعرض اليه الشعب طوال أربعين عاماً، وإرادة الخلاص من الاستبداد، كان سندها العامل الأخلاقي، من دون قيادات فاعلة، كان ثمة فراغ سياسي على الأرض، ما سمح للذين انضموا إلى الثورة الاعتقاد أن الانتصار قادم لا محالة، فالتحق بها كثيرون مع تدفق المال السياسي، فتعددت الفصائل المتأسلمة المتعيشة على المساعدات واستجداء مصادرالتمويل، والعمل في التهريب والخطف. ما عجل بالهزيمة، فالحرب أصبحت مصدر دخل وسلطة.
المفارقة، أن النظام ومنذ بدء الثورة، عول على الفساد. فسانده الشبيحة وميليشيات النهب، كانت مصالحهم معه، بالمقابل أطلق أيديهم في القتل. استخدم النظام هذه الوسيلة مبكراً، فمزق البلد إلى اقطاعيات، ووزع المغانم على أساسها، وتحكم بها عن بعد، فكان التسيب بالمجازر وكان النهب هو المكافأة، ولا تضبط تصرفاتهم الا عندما تبلغ الحماقة ببعض أمراء الشبيحة آلظن بأن ما يتمتعون به من صلاحيات لامحدودة تبيح لهم الاستقلالية عن المركز، فكان تأديبهم يتم بالاغتيال آو الاعتقال، ما يعيد ميليشياتهم إلى الحظيرة.
3 في حوار سابق لك قلت ” الحياد جريمة لأنه يصب في خدمة الاستبداد ” . ماذا كان يقصد فواز حداد بـ الحياد ؟ اليوم هناك أكثر من 200 مليون محايد يعيشون في ظل ديكتاتوريات العالم العربي، هل هؤلاء يصبون في خدمة الاستبداد ؟
إذا كانت الحرب بين دولتين تتنازعان على مصالح سياسية واستراتيجية، فالحياد المطلوب هو عدم التدخل من الدول المجاورة. أما في الوضع السوري، فلم يكن الحياد على امتداد الثورة الشعبية سوى اغماض العين عن الجرائم التي كان النظام يرتكبها. الحياد ليس قيمة بحد ذاته، الا اذا كان عقلانياً ومنصفاً، يسعى لاخماد الفتنة، لا تجاهلها والتعامي عنها. في ذلك الوقت، أدى الحياد إلى عدم تحميل المجرم أية مسؤولية، ومساواة المتظاهرين السلميين مع نظام دكتاتوري مسلح، وبلغ نفاق بعض المحايدين آنئذ، أنهم شملوا الطرفين بالادانة دونما تمييز بينهما.
هل ثمة مساواة بين الجلاد والضحية؟ عندما يقتل الرصاص العشوائي الرجال والنساء والأطفال، ولا يوفر القصف الأهالي، والأفران والمستشفيات والمدارس. فالحياد كاذب ومخادع، وبالضرورة مدان.
أما صمت الناس في الداخل، فكان احتجاجاً، وليس حياداً. إزاء البطش الأعمى للنظام، لم يكن بوسعهم حتى الاعتراض. ما يعيد إلى أذهاننا، حياد مائتي مليون في العالم العربي، أننا كنا نحن السوريين في خدمة الاستبداد طوال ما يقارب نصف قرن، لمجرد أننا لم نعِ حقوقنا، وتركنا البلد مزرعة لهم.
4 يتقاطع التاريخ الواقعي، مع التاريخ المروي في رواياتك، كيف يفصل فواز حداد بين التخيلي والواقعي، وأين يتوقف هذا التداخل، وأين يتماهيان مع بعضهما؟
في الرواية، الواقعي والمتخيل خليطة في سبيكة واحدة، لا يجوز الفصل بينهما، فالثاني يتماهى بالأول، ويتممه على نحو عضوي، بحيث ينتج مشهداً لا يمكن تجزئته؛ سنده التاريخ، ولولا الخيال لما تكامل.
الروائي ليس مؤرخاً، ولا الموكل بالتاريخ. وإن كانت مسؤوليته تجاهه تضارع مسؤولية المؤرخ، من ناحية محاولة كل منهم اكتشافه، كل من موقعه. ينصب جهد الروائي في ادخال البشر إلى التاريخ، ما يضمن عدم تركه أسير تصورات سياسية واقتصادية فقط.
5 كنت من أوائل من مزّق مشيمة الاستبداد، أقصد هنا من حيث التكور والخنوع ، وكتبت عن مراحل وتفاصيل ظل أغلب الروائيون السوريون يحومون حولها عن بعد، ليس فقط خوفاً من السوط، إنما من هذا القرين. الرقيب الداخلي، هل أستطيع السؤال حول كيف استطاع فواز حداد كسر هذه القاعدة؟
الاشتباك مع الاستبداد، لم يكن بالتغلب على القرين الداخلي فحسب، ولا الجرأة كانت المحرض عليه. هذه معارك جانبية ولو كانت أساسية. بالدرجة الأولى، يأتي من مفهوم الروائي للرواية، وهو مفهوم متعدد الجوانب، أحدها الأكثر التصاقاً به، هو أن الرواية فسحة للبحث والاكتشاف والاقتحام، فإذا ادرك الروائي حقيقة ما، لا يخفيها، يصبح مكلفاً بها. وقد تذهب به إلى الاصطدام مع السلطة. الأدب عموماً على عداء مع الأنظمة، الدكتاتورية والديمقراطية من دون تحديد، وهذا ليس نوعا من العبث، غالباً تتخذ مسألة الضمير وعلاقتها بالكتابة الأولوية لصلتها الوثيقة بالبشر.
إغفال الروائي شيء مما يعتقده صواباً، أو تجنبه والتغاضي عنه، لا يعني سوى أنه يكتب رواية ما مسلية للترفيه عن النفس، أو مأساوية تستدر العواطف، وهذا ليس عيباً، إنها روايات رائعة، إذا لم تبتذل. لكن هناك رواية تستمد صيغتها النهائية بتعرية فسادنا نحن البشر. بالتالي عندما تمتلك الرواية كينونتها، يصبح الروائي في سياقها، مجرد أنه يكتب ملاحقاً تداعياتها.
6 مرحلة الثمانينات لاقت لديك اهتماماً خاصاً، التنكيل بجماعة الإخوان المسلمين وأحداث حماة، اليوم نرى هؤلاء ” ضحايا الأمس” وقد كشروا عن أنيابهم وابتلعوا الحراك الشعبي والبعض منهم يمارس تنكيلاً لا يقل عن فظاعة الاستبداد، كيف تفسر هذا السلوك ؟ كنت تتوقع ذلك ؟ خاصة أنهم شخصياتك/ الروائية.
اذا كان ضحايا الأمس، ارتكبوا فظائع اليوم، فهذا يعني أن الإجرام بالوراثة. طبعاً، هذا النظر مرفوض تماماً من الناحية الواقعية والأخلاقية، العدالة لا تقبل بأن يحل أحد محل أحد. في تدمر لاقوا الموت، هل ندين الأموات، لمجرد أننا نشك بأنهم لو امتد بهم العمر، لكانوا القتلة؟ المسألة ليست في الجينات، بل كل انسان مسؤول عما ارتكبه. الخشية من هذا التنظير، أننا نتبنى آلية النظام في التوريث.
ثم هل الذين تعذبوا في تدمر هم الذين أنجبوا داعش والنصرة؟ هذا ضرب بالغيب، وكأننا نقول أن السبب هو الإسلام. وهي نظرة لا يجب التسامح معها، يستغلها الغرب، وبرأيي، لا أكثر من إدعاءات ومبررات. بينما الأنظمة الشمولية العربية هي الأب الحقيقي للإرهاب المتأسلم.
في روايتي “السوريون الأعداء”، ركزت على الموقف الأخلاقي، حتى عندما تهيأ للسجين الانتقام من المجرم، رفض الفكرة لسبب قوي، لاحساسه أن فقدانه لعائلته وعذابه في السجن نحو ثلاثين عاماً، لا يمحيها قتل رجل، أدرك أن النظام خصمه الحقيقي، وإذا اعتمد الانتقام ممن كان سبب عذاباته، فقد أغلقت قضيته. كان الأمر يتجاوز الثأر، الى طلب العدالة.
7 ولو بعد حين من طباعة رواية ما من رواياتك . هل تشعر أحياناً أنك قيدت من حركة شخصية ما. بلغة أخرى ظلمتها، أو أنك منحت شخصية أخرى أكثر مما تستحق، وإلى أي حد تظل متعلقاً بهذه الشخصية . تتنقل معك وتشرب القهوة وقد تراقبك . هل صدف ذلك ؟
أتعايش مع شخصيات روايتي مدة تقارب سنتين إلى ثلاث سنوات، وأحياناً أكثر، إنها في رأسي لا تفارقني. ما يجمعنا اكثر من شرب فنجان قهوة، إنها الحياة والحب، والموت، والأرق، والخوف. عندما أدفع بالرواية إلى المطبعة، يكون الوداع قد حصل فعلاً، وإن شعرت بالحنين إليها، لقد باتت مستقلة عني تماماً، بل وقد تصبح الآخر بالنسبة إلي، ولو أنها كانت جزءاً مني.
تغدو هذه الشخصيات وديعة الرواية، لديهم أكثر من حياة، ربما بعدد القراء، شأنها معهم، لا معي. فأنا مضطر إلى الاستعداد للقاء شخصيات أخرى، أول علامات رحلتي التالية: القلق.
8 بعد خروجك من سوريا. إلى أي مدى اختلفت لديك المساحة الروائية، ضاقت أم اتسعت، أو أن ثمة زوايا جديدة كان من الصعب رؤيتها من داخل دائرة الاستبداد وتوضحت عن بعد؟
لا شك، كان لخروجي من سورية أثر لا ينكر، سواء كان سلبيا أو ايجابياً، فهو لا يعدم كليهما. خُيل إلي أنني سأتحرك في مساحة روائية أكثر حرية وغير محدودة. لكن وبالفعل لم تتغير علاقتي بالرواية الا بشكل طفيف؛ هذا أسلوبي وهذه طريقتي. ولاعترف أصبحت أكثر اطمئناناً، وخفضت من حساباتي الاحتياطية، ولو كانت ضئيلة، لمجرد الإحساس بحرية الكتابة دونما عوائق، لكن لا ننسى الرقيب الداخلي، الصراع معه لا ينتهي بمجرد خروجنا من البلد، المشكلة أننا نصطحبه معنا.
وإذا كان مشهد البلد من الخارج يبدو أوسع، ولست تحت ضغوط الحرب بشكل مباشر، لكن في الوقت نفسه خسرت دائرة النار، رغم الخوف من أن أكون أحد ضحاياها، مهما يكن وجودي في الداخل، كان أكثر فاعلية من ناحية الاحساس بما يعانيه الناس من تضييق وغلاء ورعب.
9 وماذا عن الكتابة تحت وقع المعارك ، هل على الروائي أن ينتظر تخامد الصراع. إن جاز التعبير، ليعيد صناعة صخب الحرب من جديد بعد أن ينقشع الغبار عن تضاريس الواقع ؟
الكتابة تحت وقع الأخبار اليومية للحرب يختلف من كاتب لآخر، هل يكتب، ولماذا؟ ومن أي زواية؟ لم أشعر بضرورة انتظار انقشاع الحرب. في روايتي الأولى عن الجحيم السوري: “السوريون الأعداء”، أحسست بأننى ألهث لأكتب ما كان يجب أن أكتبه قبل سنوات، قبل الثورة والحرب، بحيث كنت كمن يستدرك ما فاته. في الرواية الثانية: “الشاعر وجامع الهوامش” أتيح لي خلال مراوحة الاشتباكات على الجبهات الكتابة عما أثارته لدي من أفكار عن الناس والدين والطائفية والعلاقات الانسانية تحت الضغوط اليومية للحرب، فلم أشعر أنني على سباق مع الزمن، لا أكثر من التعامل مع قضايا إنسانية أخلاقية، كان يجب التعرض لها، جاءت الحرب وأطلقتها. أما في الثالثة، فاعتقد أنها النهايات أو الخلاصات، وأرجو ألا تكون مفتوحة على المجهول.
10 على ما يبدو أن تحولات اجتماعية وثقافية عميقة تتجذر بعد ثورات الربيع العربي التي اصابها التصحر أو التحور ، أو دخلت حالة كمون . بالعموم ، كيف تقيم المشهد الثقافي. بين قوسين في العالم العربي، على خلفية هذه التحولات ؟
المشهد الثقافي ليس كالمشهد السياسي يتعرض الى انقلابات ولو كانت كاذبة، بل يحتاج الى اختمار طويل، فالسبع سنوات التي مضت على المنطقة لم تؤد بعد الى ما توقعناه منها، رغم هذه التراجيديا الكبرى التي قدر لها اقتلاع الكثيرمن المسلمات، والتكلفة الباهظة؛ ملايين الضحايا، صحيح أن دعوات التحرر من الأنظمة الفاسدة اخترقت المنطقة برمتها، لكنها لم تفض إلى تحولات جذرية، بقدر ما أسهمت بانكشاف الواقع العربي المتردي، وترسيخ وجود الأنظمة، بل وتأبيده من ناحية ألا متغيرات الا تحت رعاية السلطات، فالفساد ما زال المهيمن.
ما ظهر هو أن المثقفين يجهلون أوضاع بلدانهم، فإذا كانوا قد تحمسوا في البداية، فقد فترت عزائمهم، مع تحول إسقاط الأنظمة إلى حرب ضد الإرهاب، مع أن اسقاطها لا يحول بينها وبين التصدي للارهاب.
الحرب ضد الإرهاب، يعتبر بالفعل المشكلة الجوهرية للثقافة، يجب انتزاعها من الأنظمة التي تتاجر بها وتستخدمها لمآربها في البقاء، وتعطيل الاصلاح. الواضح أن العقلية المخابراتية تعيد تشكيل كتابات المثقفين، وذلك بمصادرة السياسة من المجتمع، والعمل على استجرارهم إلى أجنداتها بالترغيب والترهيب، فالقمع سيكون سارياً، والتهديد بالاعتقالات والسجون لن يتوقف، ومن طرف خفي، إفساد الثقافة، لهذا فلنتوقع مهرجانات واحتفاليات وندوات وإعلانات عن مسابقات وجوائز… كل شيء على مايرام، وستبدأ مرحلة من الاستقرار المديد، وغياب كامل للأمان الحقيقي. لذلك سيكون أغلب ما يكتب هراء، اذا لم نستدرك المتطلبات الأساسية للإنسان العربي في هذا العصر، أحدها الحرية؛ حرية التعبير، وإلا لاجدوى من الكتابة.
11 النقد الروائي غائب؟ على الأقل كـ قراء لا نشعر به. هل تحول للإطناب والإطراء ، وأين هي قضايا وسجالات الرواية العربية كما في الغرب. بشكل اخر ، فواز حداد كـ روائي. يشعر بوجود هذا النقد؟
لن نذهب إلى الغرب للتعليق على الحركة النقدية، يكفي القول، إن تراجعاً هائلاً في النقد بالمقارنة مع الستينات والسبعينات، حينما كانت حركة النقد في عز تألقها وفورانها وتعد بالكثير، إذا كان أمين العالم وعلى الراعي ومحمد مندور وغنيمى هلال وأنور المعداوى ورجاء النقاش… وغيرهم، أساتذة النقد في ذلك الوقت، لكن ماذا عن التلاميذ؟ انصرفوا إلى السياسة والصحافة، ولم ينتجوا شيئاً ذا بال.
يمكن القول، إن الأجيال السابقة كانت لديها قضايا حقيقية، أنتجت نقدا حقيقياً. اليوم هناك أنظمة شمولية، ولا حريات. من المهزلة انتقاد فترة عبد الناصر، وما يعزى اليها من تردي حالة الوطن العربي، بينما شهدت في ذلك الزمن طفرة ثقافية على جميع المستويات. إذا كان الأنظمة الدكتاتورية تقدم نفسها على أنها البديل والوارث للناصرية، فلماذا انحطت الثقافة في زمنها، بينما ازدهرت في زمن عبد الناصر كافة الفنون؛ السينما والمسرح والرواية والقصة والنقد الأدبي…الخ، ليبدأ انهيارها في زمن السادات ومبارك، وأمثالهم في البلدان العربية، وأصبحت تدعو للسخرية في زمن السيسي؟ لا أقول أن عبد الناصر صنع الثقافة، لكنه أثار قضايا حقيقية، فشارك الجميع في الإجابة عنها. النقد هو سؤال، هذا السؤال اختفى، طرح بدلا عنه الكثير من الهراء والترهات.
لئلا نغمط النقد مكانته، لا بد من القول إنه حبيس الجامعات، لم يخرج بعد إلى الهواء الطلق، ذلك الذي يتنفس منه.
12 لكل كاتب طقوسه الخاصة فيما يتعلق بالكتابة، ولدى القارئ دائماً فضول لـ معرفة ذلك ، بدءاً من الفكرة ووصولاً إلى الكتابة. هل تمانع الخوض حول هذا الأمر.
كان لدي طقوس أو لنقل عادات، لكنني تخليت عنها؛ التدخين والقهوة، والكتابة في ساعات الليل، أو في ساعات الصباح الباكر، بقلم معين، ونوع خاص من الورق، ترافقني أنواع مختارة من الموسيقا والأغاني، وربما الهدوء المطلق، ونافذة تطل على منظر أخضر. إغلاق الهاتف، ثم النسخة الأخيرة على الآلة الكاتبة.
بلغ التزامي بهذه العادات أنها إن لم تتوفر، فلا كتابة؛ وكأن العادة تصنعها. ليس عسيرا اكتشاف أن الانسان لا ينبغي أن يكون أسير عاداته. فتخليت عنها تحت تأثير تسارع المتغيرات في حياتي، وعدم توفر وضع دائم للاستقرار. أصبح توفر مكان أو ركن أو زاوية في غرفة أو محل عام في أي وقت، حافزاً للعمل، وأغدو جاهزاً للكتابة بمجرد قراءة بضع صفحات مما كتبته، رغم الضجيج من حولي، انعزل عن المكان والزمان، وأصبح في زمان الرواية ومكانها. وإذا لاحت منى نظرة أو شدني شيء من حولي، لا يشكل سوى فاصل سرعان ما ارتد إلى العمل.
أما عن رحلتي من الفكرة إلى الكتابة، فتحتاج إلى كتاب. وفي الحقيقة، لكل رواية قصة طويلة، ربما كانت أكبر منها.
-
المصدر :
- DUDERI