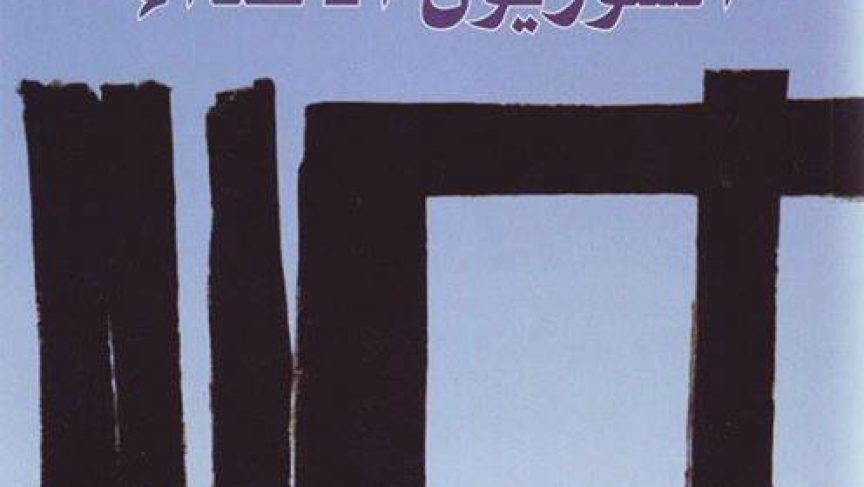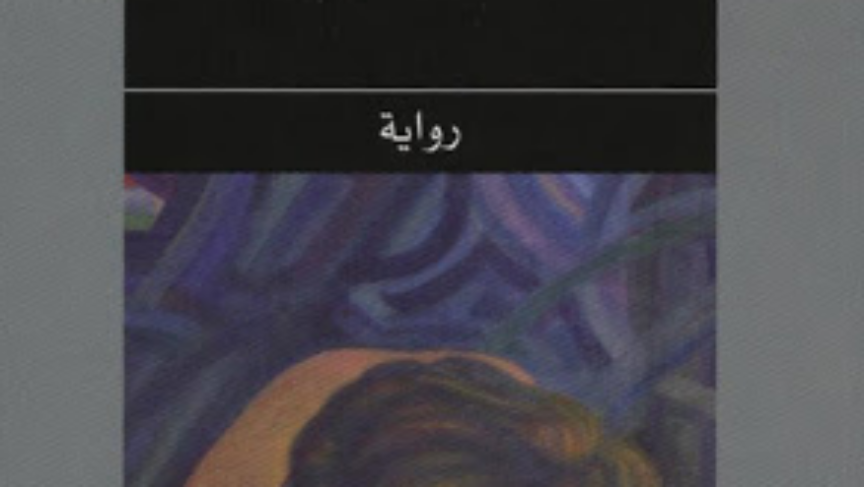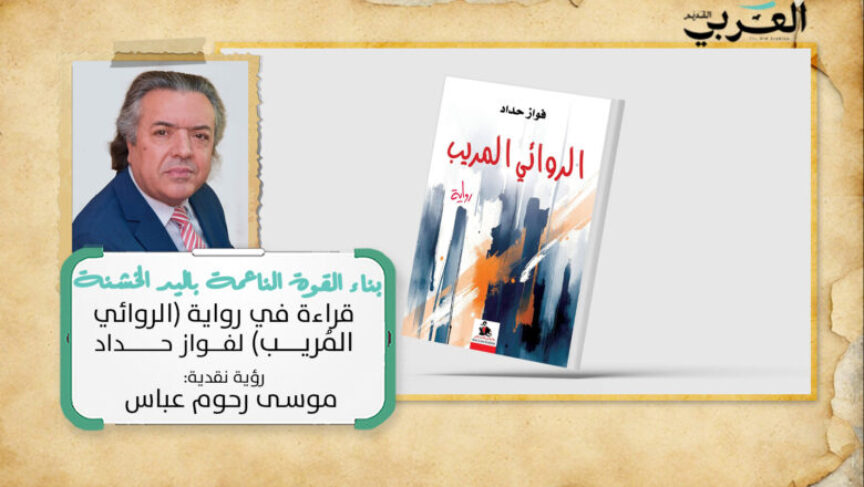�تناول فوّاز حداد في روايته “السوريون الأعداء” العلاقة بين النظام الحاكم في سوريا والشعب منذ تولي حافظ الأسد الرئاسة وحتى تاريخ كتابة الرواية.�الشخصية المحورية “الطبيب عدنان الراجي” من مدينة حماة، اعتقله نقيب “علوي” بغاية تصفيته في حقل الرمي لكن المصادفة جعلته يلتقي بمساعد علوي أحسن إليه سابقا بمعالجة أطفاله وإعطائه دواء بالمجان. حاول المساعد أن يهرّبه رداً للمعروف لكنّه فشل وجل ما استطاعه أن يلحقه بالمعتقلين وبدأت رحلته إلى سجن تدمر.�ما ينظم الرواية ويحبك خيوطها جيداً حكاية آل الراجي “الطبيب وشقيقه المحامي وعائلته التي راحت ضحية مثل آلاف العوائل في حماة أثناء المجزرة”. في المقابل الشخصيات السلطوية سواء كانت سنية أو علوية، النقيب، حبيبته الانتهازية لميس والتي كانت خطيبة وحبيبة صديقه مروان الذي قتل بنيران صديقة واعتُبر شهيداً فحلَّ مكانه في قلب لميس وحياتها..�ربّما لم تكن كفتا الميزان متساويتين بين الشخصيات الخيرة والشريرة، لكن الاختيار وقع على عدد قليل من الشخصيات قامت باختصار كلّ طرف. وقامت شخصية واحدة بتمثيل الطرف الرمادي المعارض العلوي الذي انقلب بعد الثورة مؤيداً والذي نرى في الواقع حولنا عشرات المثقفين ممن يشبهونه.�لقد كان الروائي أميناً للتاريخ ودقيقاً في سرد الأحداث بحرفية عالية. أعادت إلينا ما جرى في حماة وكأن الشخصية الروائية منتزعة من الواقع، وكي يؤكد تلك الواقعية ذكر بعض الأحداث التي يعرفها من عاصر المجزرة أو هرب منها.. مثل حادثة اقتلاع عيني طبيب العيون والد الفنان التشكيلي خالد الخاني، وبعدها في زمن الثورة اقتلاع حنجرة القاشوش.�يضيع القارئ المطلع أحياناً فهو يبحث عن المتخيّل في الرواية فيصدمه الواقع بشدّة.. تفاصيل التّعذيب في سجن تدمر في عهد الأب، التّصفيات الجسدية، سجن صيدنايا، انقلاب رفعت، مقتل باسل، مرض الرئيس، حرب لبنان، العلاقات السورية الإسرائيلية، توريث السلطة، كذبة التحديث، ثمّ مجريات الثورة منذ كتب أطفال درعا على الجدران..�أنا أمام ملحمة سورية وإن عشت بعض تفاصيلها وعرفت الآخر من ألسنة الناس، أمام ملحمة وقفتُ على مسافة منها وكأنّها تحدث أمامي الآن، خضت معارك جسر الشغور، ومجزرة المشارقة في حلب مرة أخرى، رأيت الإنزال المروحي على أريحا وسحل الشباب ممن استشهدوا بالدبابات في شوارعها. كنت أرى بوضوح كلّ ما يصفه فواز حداد في الرواية وأعيشه مرّة أخرى.. لكن أن تعيش الماضي مرّة أخرى لا يعني أبداً الشّفاء منه، وتذكر الماضي بكلّ وحشيته ليس من قبيل تعذيب الذات وجلدها بل لتبقى صورة القتلة وتصرفاتهم موثقة للأجيال القادمة.�لست غريبة عن أجواء القضاء التي تحدّث عنها فواز حداد من خلال شخصية القاضي. فقد عاصرت تلك الفترة وكنت على مقربة من هؤلاء الذين ذكرهم في الرواية، كنت أبحث أثناء القراءة عن أسمائهم الحقيقية ووجوههم من خلال أفعالهم المذكورة في الرواية وقد أدهشتني الدقة التي تحدّث بها الروائي عن دهاليز قصر العدل وقضايا الفساد وسيطرة المخابرات على كلّ أمور الدّولة بما فيها القضاء. لقد كان الوزير وزيراً بالاسم فقط، هذا ما لمسته شخصياً في الثمانينات، وهذا ما أكّده فواز حداد حين ذكر الوزير بطريقة عابرة ومن دون اسم وكأنّه غير موجود أصلاً فهو شخص صوري وضع داخل إطار ومنح لقباً سيحفر له أصدقاؤه الأقرب إلى المخابرات ويطيحون به ليستلموا مكانه.�برع فواز حداد في وصف العلاقة بين السجناء/الأرقام/ في سجن تدمر وفي الحديث عن الانفصام بين الشخص الحقيقي “عدنان الراجي” الطبيب المعتقل وبين الرقم “77” رقمه الذي حمله حين دخوله السجن..�كانا شخصاً واحداً وصار شخصين، كلّ واحد منهما له طريقته الخاصة والمختلفة في التفكير وتحليل الأمور، يكاد الرقم 77 ينقاد تماماً للفكر الإسلامي السائد في السجن ويحافظ الطبيب عدنان الراجي على منطقه الوسطي الأقرب إلى الانفتاح والأعمق في التحليل.. يتغلب الرقم على الطبيب زمناً لا يلبث الطبيب أن ينقذ نفسه من الغياب حين تظهر أمامه حالة إصابة بالكوليرا في المهجع.. تغلّب حسّه الإنساني على ما عداه، لكن ذلك لم يدم، الإعدامات التي طالت المساجين بعد فترة أعادت الرقم 77 إلى الواجهة ليتغلب على الطبيب. (ولقد كان تأثيره قوياً، مختلفاً عن المرة السابقة، حتى أنّه حوّله إلى كتلة من الهم والقنوط.).�هذا الانفصام أغنى الشخصية كثيراً وقدّم في اعتقادي الصورة الأكثر ألماً ووحشية، وهنا بالضبط تكمن براعة الروائي في رصد ما فعلته السّلطة والنّظام الحاكم بالنّاس.. لقد تابع الروائي حالة الانفصام لدى الطبيب عدنان التي جعلته يجنح إلى الجنون وطلب العذاب بطريقة بارعة.�روائياً دراسة أثر التعذيب وتقديمه بهذا الشكل أهم في رأيي من الوصف الدقيق للوحشية.. لكنّ فواز حداد جمع بين الاثنين، فكان أميناً في نقله لمجريات الحدث الواقعي وفي الوقت ذاته برع في تخيّل ووصف أثر ذلك الحدث في نفوس شخصياته على المستويين، المعتقلين والمضطهدين من جهة، والقتلة من جهة أخرى.�لم يكتفِ بتقديم شخصية النقيب الوحشية بل تتبع حياته الشخصية، علاقته بالمرأة، علاقته بأهله وأصدقائه، تقلباته العاطفية، فكانت الشخصية حية أمامنا تتحرّك بأريحية كاملة تجعل عواطفنا تجاهها مذبذبة فنحن هنا لسنا أمام آلة قتل بل كائن بشري يهوى القتل يمتلك نوازع سلطوية ومن جانب آخر يحب ويعشق، علاقته الجنسية بالمرأة يتخللها خجل وارتباك وتردد أحياناً يعبر عن غبائه وقلة خبرته ويجعله يستعين بصديق له لفهم آلية التفكير لدى المرأة الدمشقية.. إنّه الريفي الذي صدمته المدينة وأشعرته بالدونية فأراد امتلاكها بالقوة لكنّه فوجئ بعد تحليلات صديقه أنّ تلك المرأة لا يمكن أن تكون دمشقية! استطاع الكاتب ببراعة تقديم الصورة المشوهة التي سعى النظام لترسيخها عن المرأة الدمشقية ونفى وجودها على لسان أبناء الريف “سليمان النقيب المهندس، وصديقه غالب المثقف الشاعر).
العلاقة بين الأرقام “المساجين في الرواية”�(الرقم 32 ضمر، وذوى، وشفّ، حتى أمسى ريشة في مهب رياح الأصوات الليلية، كانت تنبهه ألا يأكل، المخابرات أوعزت لعملائها في السجن بدس السم له، فامتنع عن الطعام، من دون إضراب ولا احتجاج، فكان الرقم 77 يأكل أمامه، ليطمئنه إلى أن الطعام غير مسموم، ثم يلقمه بيده، أحياناً يأكل وغالباً يرفض.)�سر الرقم 32 تلك الروائح الكريهة التي يطلقها باستمرار والتي حيرت الرقم 77 وجعلته في مواجهة لغز يحتاج إلى حل.�التآكل في مؤخرته بسبب أنه لا ينظف مؤخرته وينسى ويتغوط لا إرادياً.�طريقة موت مريعة تلك التي مات بها الرقم 32 تخشب فيه كل شيء حتى الدم وأخيراً تخشبت أنفاسه على وضعية الزفير ومات!”�لم تقتصر وحشية الهمج الذين يتحكمون بمصائر البشر وحياتهم ويقومون بتعذيبهم على الآثار الجسدية، فتلك الآثار قد تشفى يوماً ويمكن للخارج من السجن تجاهلها.. بل تعدتها إلى الروح والنفس، الآثار النفسية الرهيبة التي تصل إلى الانفصام والجنون ونسيان كلّ شيء يتعلق بالجسد.�خرج الطبيب عدنان الراجي من السّجن بعد زمن طويل ليواجه الحقيقة التي بقيت مجهولة بالنّسبة إليه طيلة فترة سجنه.. خرج ليجد نفسه في امتحان صعب في مواجهة النقيب الذي أرسله إلى حقل الرمي لتصفيته فذهب بمحض المصادفة إلى السجن.. هل ينتصر عدنان الراجي بأخذ ثأره من القاتل؟ أم أنّه يرى العدالة بطريقة مختلفة؟ ذلك ما تجيب عليه الرواية في صفحاتها الأخيرة، حيث ترك الروائي مصير ابن الطبيب مجهولاً ليكمل القارئ بحثه عنه.. ومنح عدنان الراجي الفرصة لتحقيق العدالة كما يراها، ثمّ منح القارئ فرصة ليقف مع ذاته ويرى بوضوح أنّ الثورة لم تكن سوى نتيجة طبيعية لكلّ هذا الاضطهاد الذي عاشه السوريون طيلة خمسة عقود “تقريبا” من حكم آل الأسد.
الزمن في الرواية:�فجأة نجد أنفسنا أمام هوة وفراغ هكذا أراد الروائي أن يتوقف الزمن، زمن القتل والتعذيب لينتقل الطبيب من سجن تدمر ويصمت عن ذكر أيّ تفاصيل لنجد أنفسنا في عهد الابن وتفاصيل عن الثورة ضده.�كان لابد من تلك الفجوة والفراغ الزمني لتكتمل الحكاية.. مع أنّ زمن الأب كان كافياً بتفاصيله لإدراك الراهن الذي نعيشه، لكنّ الحكاية وضعت الروائي أمام خيار وحيد لا يمكن تجاوزه أو القفز فوقه فأسقط أحداث سنوات طويلة لنجد الطبيب عدنان الراجي خارج السجن في مواجهة مع الحياة التي لم تعد كما تركها.�السوريون الأعداء رواية مهمة ترصد تاريخ الاستبداد لابدّ لكلّ سوري أياً كان انتماؤه أن يقرأها ليعرف مع من عاش حياته التي مضت والتي ستأتي.
-
المصدر :
- رابطة الكتاب السوريين