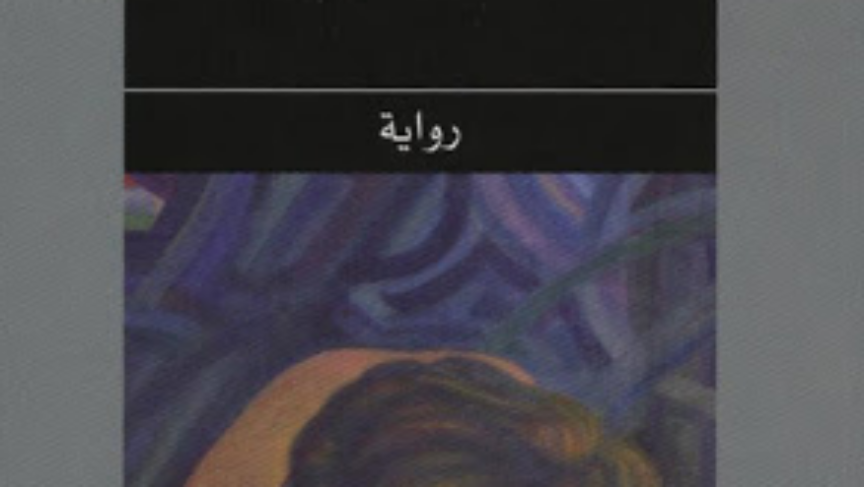ليس منصفاً، من وجهة نظري، المرور على رواية “السوريون الأعداء” لتقديم عرض مختصر لفصولها وأحداثها المتوزعة على 474 صفحة، إذ لا أعتقد أن كاتبها أراد ذلك. على العكس؛ فهي رواية تعكس فهماً عميقاً للحالة السورية على مدار عقود وللمقدمات التي أنتجت ثورة عام 2011، ولذلك فمن الضروري تسليط الضوء على هذا الفهم وسبر عمق شخوص الرواية بشكل أكبر.
لماذا اختار الكاتب أحداث حماه عام 82 ركيزة انطلق منها لفهم الحالة السورية التي تمخضت عنها ثورة 2011، بينما صدر الرواية خلال سني الثورة لا قبلها؟ لماذا لم يتناول الثورة نفسها واكتفى بمرور سريع عليها في خاتمة روايته؟ ولماذا قدم شخوصه في قالب رمزي أكثر منه واقعي رغم واقعية الرواية ذاتها؟
قدم لنا فواز حداد في روايته هذه -والتي لا أراها توثيقية بقدر ما أراها تفسيرية- شرحاً مهماً لتركيبة المجتمع السوري جسّده أبطال الرواية الثلاثة: الطبيب عدنان راجي، القاضي سليم الراجي، والمهندس سليمان. لكل من هذه الشخوص أبعاد ثلاثة، آمالها ومخاوفها، نقاط ضعفها ونقاط قوتها، وأهدافها وغاياتها. وللإجابة على الأسئلة التي تقدم ذكرها، لا بد من قراءة معمقة لكل شخصية منها على حدة.
الطبيب عدنان الراجي :
ذو الشخصية اللطيفة والمساعدة للآخرين. تُقتَل عائلة الطبيب في مجازر حماه من قِبَلِ النقيب سليمان(المهندس) -والذي لم يكن في الأصل ضابطاً في الوحدات القتالية- لا لأنهم آووا أحد الإخوان المسلمين، أو لأنهم شاركوا بعمل يوحي بمعارضتهم لنظام الأسد الأب، ولم يكن قتلهم في سياق عملية انتقامية من أهالي المنطقة، بل لأن حظَّهم العاثر أوقعهم في قبضة النقيب. النقيب التواق إلى القتل وتحسس لذته دون شعور بالندم أو الضعف، كيما يبرهن لنفسه مقدرته على ذلك. إنه قتل بغاية القتل وحسب.
يُعتقل الطبيب دون أن يعرف مصير عائلته، وقُدر له أن ينجو ليشهد عذابات المعتقل في سجن تدمر لثلاثة عقود، وأفضت مسيرة العذاب هذه إلى إصابته بالفصام حيث أوجد شخصية موازية، واسمها الشخصية رقم 77، وشرع في خوض حوارية مع نظيره ’’الوهمي‘‘. كانت هذه الحوارية تمس الواقع بقدر بعدها عن الخيال أو الهلوسة، ما يدفع القارئ إلى الاعتقاد يقيناً بأن الكاتب عاش تجربة اعتقال مريرة وهو ينقل معاناته في هذا السرد عن قبح وهول الأحوال في المعتقلات السورية.
يخرج الطبيب من المعتقل ويواجه قاتل عائلته. بعد تمكنِّه من الانتقام، يختار طوعاً ألَّا يحول قضيته لثأر شخصي بل على العكس، قرر أن يبدأ فعلياً بنضاله ضد منظومة كاملة من الظلم والفساد، لا ضد أداةٍ من أدواتِ الجريمة فقط، وذلك من خلال استثمار خبرته كطبيب في مكانها المناسب.
هذه الدلالات كانت كافية لفهم رمزية دور الطبيب في الرواية، ألا وهو الشعب السوري. حيث يعانى من الاضطهاد دون مبرر، يتحمل هذا الاضطهاد عاجزاً عن فهمه أو ردعه، يرضخ ويحاول في الوقت نفسه إيجاد سبلٍ للنجاة، ويتسائل دائماً ما الذي فعله ليستحق مثل هذا المصير! ثم يختار أخيراً النضال السلمي بعد كل ماتعرض له من اضطهاد. أراد الكاتب باعتقادي من خلال الإشارة لتنازل الطبيب عن ثأره في النهاية وتمسكه بالثورة ضد المنظومة الأمنية بأكملها أن يقول للسوريين: لا تحولوا ثورتكم لانتقام وثأر شخصي حتى لا تفقد غايتها الأولى.
على الرغم من أهمية وجوهرية دور الطبيب كرمز للشعب بعموميته، إلا أنه لم يكن راويها، بل كان القاضي سليم.
القاضي سليم الراجي :
هو شقيق الطبيب. غادر حماه إلى دمشق ليصبح قاضياً كما أراد دائماً، وهذا ما تم له. شخصيته النزيهة والساعية إلى العدالة عن طريق الاصلاح والتغيير البطيء لم تشفع له في نهاية المطاف من اكتشاف أنه ماكان سوى أداة لتدعيم السلطة وتعزيز الفساد. فقدانه المستمر للأمل بتغيير الأوضاع لم يسلَّمه إلى هُوَّةِ الاستسلام واليأس كما حدث مع أستاذه رشدي، بل ظّلَّ مؤمناً أنه سيستطيع التأثير أو التغيير واستعادة العدالة في بلاد يحكمها قانون الغاب. من موقعه كراوٍ للأحداث، وقع على عاتق القاضي ربط الشخصيات والأحداث والانتقال بسلاسة فيما بينها تارةً بضمير الغائب وتارةً بضمير المتكلم. وينتهي دوره بالإشارة إلى أن سورية ذاهبةٌ إلى المجهول مع بارقةِ أمل أن يكون هذا المجهول أفضلَ من الحاضر والماضي الذي عاصره.
لم يَسعَ القاضي حسبَ الرواية لمعرفة مصير أخيه المجهول برغم علاقته الطيِّبة مع أحد رموز السلطة “المهندس”، بل اكتفى بتربية ابن أخيه المغيَّبِ وتحمل عقدة الذنب الدائم أنه لم يشارك عائلته الموت. هذه الشخصية التي تجمع بين النزاهة والجبن والسلبية والوعي بطرق النضال السلمي، مع معرفة عالية المستوى بالعدالة وطرق تحقيقها لا تدع مجالاً للشك أمام القارئ في أن القاضي هو رمز للنخبة المثقفة من الشعب السوري، فهي تكتفي بالسرد دون أن تمتلك القدرة على تغيير الواقع رغم ما مرت به من أهوال. وهي، من ناحية أخرى، متعاطفةٌ حَدَّ اشتهاء الموت مع الجماعةِ، وغير قادرةٍ على مَدِّ يَدِ المساعدَةِ. تملك ما يكفي من المعرفة بالقوانين والعدالة ومن حيث لا تعلم تصبُّ معرفتها في خدمة الطاغية وتكمل،بقصد أو بدون قصد، دوره في المسرحية الدامية.
لم يشأ الكاتب أن ينحاز سلباً أو إيجاباً لأي من شخوص روايته، فكان لكل واحد منهم الحق بالتعبير عن مخاوفه وآلامه وتطلعاته بل وحتى الدفاع عن نفسه حين الحاجة. لكن توزيع المهام على أبطاله كان كفيلاً بمحاكمة عادلة تفي كل دورٍ حقه، لذلك كان يجب على هذه الفئة أن تتحمل عبء دور الراوي لمثل هكذا رواية.
النقيب سليمان (المهندس) :
بدأت مسيرته مع نظام الأسد بالوشاية بخاله عبد اللطيف حسُّون أحد زعماء الحزب الأوحد والمعارض لانقلاب وزير الدفاع حافظ الأسد الذي سمّي الحركة التصحيحية عام 1970. حيث كان النقيب لايزال طالباً في الصَّفِّ الثالث الثانوي ويطمح أن يكمل دراسته في كلية الهندسة كابنة خاله رباب التي هام فيها حبَّاً دون أن يتمكن من الزواج بها لرفضها ورفض والدها له. كانت سياسة الوشاية من أهم خصال المهندس، بدأت بخاله واستمرت في الجامعة ثم في الجيش. تمكن عبر سلوكه أقصر الطرق وأشدها دناءةً من الوصول للقصر الجمهوري والعمل هناك في جهاز سرِّي يراقب أجهزة المخابرات جميعها، أي رقابة فوق الرقابة. انتهت حياته بانتحار طوعي بعد اكتشاف خطته لاغتيال بشار الأسد في حال لم يقف الأخير ضد الشعب في ثورته.
اختار حداد لهذه الشخصية أن تكون بوتقة صهر فيها عصبة من رجالات النظام معاً دون أن ينطبق الوصف على شخصية بحد ذاتها، لأنها ستكون الشخصية الأكثر تعقيداً ووضوحاً في آن واحد بين شخصيات الرواية، فهي المفتاح لتفسير كل أحداثها ومسبباتها.
هل كان المهندس رمزاً لإحدى القيادات التي طالما سمع السوريون عنها؟ هل هو علي دوبا رئيس المخابرات العسكرية أم محمد ناصيف رئيس الأمن الداخلي أم محمد الخولي رئيس المخابرات الجوية؟ لعل حداد أراد أن يجمع في شخصية المهندس ذات الولاء والطاعة الصارمين لحافظ الأسد سمات مختلفة من كل من هذه الشخصيات أو من شخصيات أخرى مجهولة عملت إلى جانب حافظ الأسد على مدار سنوات حكمه. فهو صاحب فكرة تقديس الأسد بالصور والتماثيل والخطابات، وبالعودة لكثير من المصادر نجد أنه لايوجد اتفاق بينها على مبتدع هذه الفكرة، فبعضها يؤكد أن حافظ الأسد نفسه هو مبتدعها بعد سنوات من وصوله إلى السلطة رغم معارضة وزير إعلامه آن ذاك “جورج صدقني”.
أما باتريك سيل صاحب السيرة الذاتية للأسد فيقول أن “أحمد اسكندر أحمد” وزير إعلام النظام من عام 1974 وحتى وفاته عام 1983 هو مبتكر فكرة تقديس الأسد بغية حرف انتباه السوريين عن التوترات الاقتصادية والعنف بين قوات الأسد والإخوان المسلمين.
وحسب روبرت سكات ماسون، هو أحد مؤلفي كتاب ” الحالة الدراسية لسورية” والَّذي أعدَّه قسم البحوث الفدرالي في مكتبة الكونغرس، فيُرجِع تاريخ التقديس إلى عام 1985 بعد الأزمة الصحية التي أصابت الأسد وما تخللها من صراع على السلطة مع شقيقه رفعت.
بينما يذهب يحيى سادوفسكي وهو أستاذ بجامعة جونز هوبكنز وزميل في معهد بروكينجز إلى أن التقديس بدأ داخل دوائر المنظمات الشعبية لحزب البعث كجزء من التعظيم العام لإنجازات البعث، ثم أصبح جزءاً من استراتيجية استهدفت تعبئة المناشدة الجماهيرية في بداية عام 1982، حيث هددت مجزرة حماه و تراجع أسعار النفط والغزو الاسرائيلي على لبنان بتقويض الدعم الداخلي للأسد، وشكلوا سويَّاً تحدِّياً لدوره كزعيم في الشرق الأوسط، فكانت ظاهرة التقديس استجابةً لهذه التطورات.
هنا يبدو واضحاً كمّ الشخصيات الَّتي اختزلتها شخصية المهندس. عَرَفَ حداد أنه لا يمكن فهم تاريخ سورية السياسي المعاصر بمعزل عن ظاهرة التقديس، ولذلك كانت هذه الميزة الأهم في شخصية المهندس والَّتي أخذت حيَّزاً كبيراً جداً من الرواية، فبرغم أن هذه الظاهرة استمدت إلهامها من الواقعية الاشتراكية لظاهرة تقديس ستالين، إلا أن السياسة السلطوية في سورية أنتجت نمطاً من الإذعانِ لم تعرفه الأدبيات قبل ذلك.
استطاعت هذه التعابير الرمزية انتاج سلطة ساعية للتحكم بالموارد المادية جميعها وبذات الوقت بناء مؤسسات الإكراه والعقاب، وذلك ما جمعه المهندس في شخصيته بين خط التهريب و انخراطه مع رؤوس الأموال والتحكم بطريقة غير مباشرة بالاقتصاد من جهة، دوره الأمني وعدم تورعه عن فعل شيء بغية الحفاظ على سلطة الأسد من جهة أخرى.
لم يسعَ النظام في سورية لخلق سلطة كاريزماتية تؤدي إلى الولاء كنتيجة محققة، ولا لخلق مجتمع كارسيرالي* يحقق الانضباط الذاتي كما يراه فوكو، بل سعى لاستبدال الشرعية بالمطاوعة، لتصبح الأخيرة وسيلة الأسد للبقاء في سدَّة الحكم وتوريثه من خلال شخصنة السلطة.
دون فهم ثوب القداسة الَّذي أُسبغ على هذه العائلة لا يمكن فهم لماذا قام الثوار في بداية الثورة بتحطيم تماثيل وصور الأب لا الابن، ولماذا كانت ثورتهم على ميت قبل أن تكون على حيِّ، ولماذا كان غضب المهندس (رمز النظام) شديداً عند هذه النقطة بالذات فقرر مواجهة المظاهرات بالسلاح وإعادة حماه 82 مرة أخرى في درعا، ولماذا أعاد النظام وضع التماثيل كخطوة أولى في المناطق الَّتي استعاد السيطرة عليها لاحقاً.
على الرغم من مرارتها كروايةٍ تفسر الواقع بكل مافيه من فجاجةٍ وقبح، إلا أن الإبداع الأدبي فيها أسبغ عليها خاصية أخرى، حيث توزع إبداعها الأدبي بين المفردات الفصيحة جداً تارةً وبين مفردات من لغة الشارع تارةً أخرى، وحافظ كاتبها في الوقت نفسه على السيَّاقَ العام متمازجاً ومتماسكاً.
لم تكتفِ الرواية بما أسلفت، بل تجاوزتها لتتناول الطائفية والطبقية والاستغلال والخوف والمعتقلات في سورية الأسد، وأوضحت دور الجنس والدين في خدمة السياسة والسلطة. القدرة التفسيرية للأنثروبولوجيا الاجتماعية والسياسية السورية الَّتي تميَّزت بها رواية “السوريون الأعداء” والقدرة على سبر الذات السورية وتعرية الواقع مع وضعنا دون هوادة أو محاباة أمام ذواتنا جميعاً، كانت كفيلة بجعلها إثنوغرافيا للسلطة السياسية وللمجتمع في سورية. فهي كما يقول كاتبها في إحدى المقابلات الَّتي أجريت معه: “الرواية ببساطة مادَّة سبر وكشف ومعرفة، بمعنى تعرية واقع يجري بمرمى أبصارنا، بالتوثيق والخيال والتأمّل. ليس لأنّه يمنحنا مادّة غزيرة للكتابة فقط، بل للتعرّف على أنفسنا أيضاً، وبلادنا وتاريخنا، والجنون البشري، والفساد المعمم، وجرائم التسلّط. والأهم، أنّه لا مفر من الحريِّة والعدالة”.
هي روايةٌ فريدة من نوعها كما أراها، إذ لا تنكأُ الجِراح فقط، بل تخلق جراحاً جديدة أيضاً.
ـــــــــــــــــ
*المجتمع الكارسيرالي: يشرحه ميشيل فوكو في كتابه “المراقبة والمعاقبة”: ولادة السجن.
هو مجتمع استبدل فيه العقاب بالانضباط، فأصبحت السلطة فيه تعتمد بشكل متزايد على مواطنيها لضبط أنفسهم من خلال استخدام تكنولوجيا محددة للسلطة وهي أساساً مستوحاة من الرقابة في السجن، بحيث تصبح قيمة الطاعة مقبولة بل ومدمجة ذاتياً ويحل الانضباط مكان العقوبة ويتم ذلك من خلال قدرة الفرد نفسه على التحكم وضبط سلوكه.
-
المصدر :
- مركز ليفانت للبحوث والدراسات