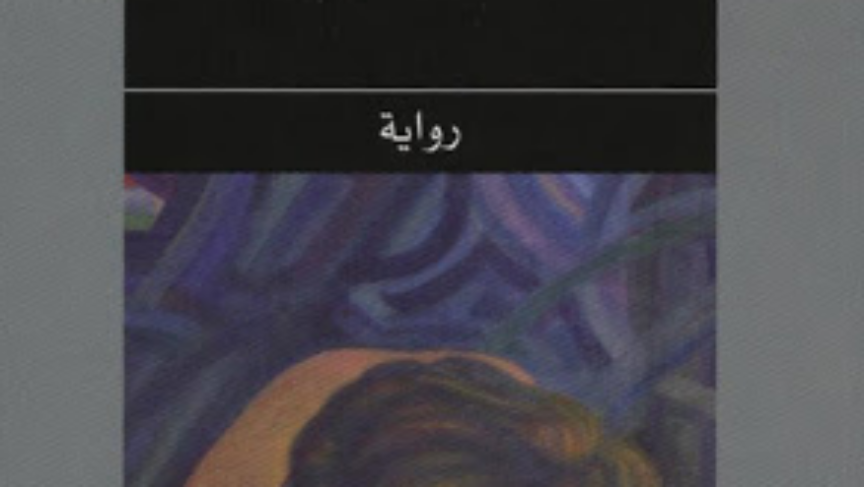في كتابه الضخم أسطورة فاوست، يُطلعنا الناقد والباحث الأدبي أندريه دابيزيس على التأويلات المتعددة التي اكتسبتها حكاية فاوست عبر التاريخ، من أصلها ذي المضمون المسيحي في القرن السادس عشر، إلى التيارات الفكرية المتتالية في تاريخ الحضارة الأوروبية بدايةً ومن ثم العالمية، لتكون واحدة من أبرز وأشهر الأعمال الأدبية في التاريخ. لقد اختلفت التأويلات لهذه الحكاية بين المرحلة والأخرى، وبين العصر والآخر، ليأتي كل تيار فلسفي وفني وكل نظام أيديولوجي ويعيد صياغة هذه الحكاية وفقاً لرؤيته وفلسفته. تتحرر الحكاية من مغزاها المسيحي اللوثري لتنتقل إلى تأويلات المدرسة الرومانتيكية لشخصية فاوست، لتعبر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وصولاً لدور فاوست في أوروبا وألمانيا، خصوصاً بين الحربين العالميتين، والتوظيفات الأيديولوجية لفاوست من الأنظمة الشيوعية والنازية، وحتى الرأسمالية والليبرالية. ينتهي الكتاب مع حضور فاوست الكثيف في نهايات القرن العشرين. إن هذا التاريخ الطويل لحكاية شعبية تحولت إلى عمل أدبي، ومن ثم دخلت في فنون الأوبرا والمسرح وعروض الدمى والسينما والرواية، هذا التاريخ الطويل والممتد يحمل مضامين متغايرة، مختلفة، متناقضة، وأحياناً متصارعة. لقد تلونت أبعاد ومضامين وتأويلات هذه الحكاية بقدر تلونات الفكر والحضارة الإنسانية عبر كل هذه المراحل، فنكاد لا نعثر على مرحلة، أو تحول، أو مفصل تاريخي إلا وحضرت معه رؤية جديدة لهذه الأسطورة-الحكاية. لكن في نهاية الكتاب، ومن خلاصة تجربته البحثية الطويلة، يقف المؤلف دابيزيس عند ثلاثة محاور أساسية في حكاية فاوست يجدها محورية:
1. اليأس من السعي والبحث: فاوست هو العالم والمفكر والباحث الذي يصاب باليأس من قدرة المعرفة والبحث العلمي والفكري والفلسفي؛ من الوصول إلى الحقيقة وماهية الوجود. إن اليأس الذي تبدأ فيه حكاية فاوست هو نفسه السقوط المعروف في الأدب بالسقوط التراجيدي أو الخطأ التراجيدي.
2. الإيمان بالغيبيات: اليأس من المنهج العلمي والبحثي يدفع فاوست إلى البحث عن إجابات على نهم الإنسان للمعرفة والحقيقة في مجال الغيبيات، ليبتعد عن الفكر والعلم اللذين يقدمان معارف متخصصة نحو معرفة تقدم أجوبة كلية شمولية، وهي الغيبيات.
3. العقد مع الشيطان: محاولة البحث عن الخلاصات العامة الغيبية تقود فاوست إلى التعاقد مع الشيطان.
إن كان هناك ما يستخلص من هذه الطريقة في سرد الحكاية، فهو الإشارة إلى أنه لا بديل للإنسان من السعي والبحث والتضحية للوصول إلى المعرفة والحقائق، فمع اليأس تكون الخطيئة التراجيدية التي تؤدي إلى السقوط في هاوية اللامعقول واللامنطقي، وصولاً إلى التسليم بالغيبيات، وأخيراً سقوط الفكر النهائي في إغراءات العقد مع الشيطان. هذه المعادلة الفاوستية يمكن إسقاطها اليوم على الدعوة إلى التغيير في المجتمع السوري بعد عقد من انطلاقة محاولات الشعب السوري للتغيير. فأثناء البحث عن الأعمال الأدبية السورية التي تعالج هذه المعادلة، تبرز الروايات الثلاث للأديب فواز حداد التي أصدرها منذ 2011 وحتى الآن، وهي على التوالي السوريون الأعداء (2014) والشاعر وجامع الهوامش (2017)، وتفسير اللاشيء (2020)، والتي سنحاول تقديم تأويل لها وفق إطار المحاور الثلاثة المذكورة آنفاً عن حكاية فاوست.
أولاً: اليأس، التنازل عن السعي أو التغاضي عن الواقع
يقدم الروائي فواز حداد في تفسير اللاشيء احتمالات اليأس الذي يؤدي إلى التعامي عن الواقع، أي احتمالية التغاضي عن الثورة والمطالب الشعبية من قِبَل المثقفين والفنانين، نتابعها من خلال حكاية مؤرخ أكاديمي، وحكاية فنان تشكيلي. كلاهما يعاني من اليأس من المجريات التاريخية الحاصلة من حولهم، ويسعيان إلى الهروب من مواجهة الواقع ورغبة الجماهير ومطالبه بالتغيير. نتابع في الرواية كيف يودي بهما هذا التغاضي عن الواقع الكارثي من حولهما إلى الانعزال عن الواقع، والانغلاق في التفكير التجريدي وإلغاء الذات-العقل إلى درجة الهوس والجنون. الأستاذ صاروف مؤرخ حاصل على ماجستير بمعدل ممتاز من جامعة دمشق في مجال البحوث الاجتماعية، وهو الآن أستاذ جامعي، يرى الحرب من حوله على أنها فائدة تغيير للبلد مهما كانت نتائجها، لكنه ما يلبث أن يكتشف فشل نظريته التاريخية حيالها: «احتلت الحرب الأولوية في تحليلات صاروف، تعرّض لسلبياتها الوحشية وأشاد بمردودها الإيجابي، حتى بعدما حصدت أرواح مئات الآلاف من الضحايا، وهجّرت الملايين، بكشفها القيح المحتقن، وإظهارها العفن المتراكم في البلد، دونما تحديد هذا القيح وذاك العفن، هل هو الأصوليات الرجعية، أم تشبيح النظام، أم تأبيد اللصوصية والقهر. جميعها على الأغلب. مهما كان، ستتغير البلاد نحو الأفضل، رغماً عن النظام والمعارضة. لا يمكن أن يحدث تغيير أو تقدم إلا بأثمان باهظة، هكذا التاريخ يسير نحو الأمام، فوق الدماء والجثث».
لكن التغيير المرتقب، حسب تحاليل الأستاذ صاروف، أتى فاقد البصيرة، فلم يكن التقدم فوق الجثث والدماء نحو الأمام، بل نحو الخلف، ولم يكن نحو الأفضل، بل نحو الأسوأ. لم يشأ الأستاذ صاروف وقد خذلته الحرب أن تظل تعكر صفوه، فأقصاها مع الثورة عن أفكاره. باتت انتقاداته متعثرة، وسكت عن كل ما قد يثير الأقاويل حول اتجاهه السياسي. لم يرغب، ولو سراً، في أن يُحسَب على أي تيار سياسي معارض أو غير معارض. فأصبح مستقلاً تماماً حتى عندما أصبح الحياد جريمة عند الطرفين، فهو أخف وطأة من الانحياز إلى أي منهما. أخيراً، مع تهاوي تحليلاته، اختار صاروف الخوض في اللاجدوى. كانت الأقل ضرراً.
لم يعد المؤرخ صاروف يطالب بالعدالة، فقد بدت مكلفة، ولا طاقة له على المطالبة بها، فحتى ولو من باب الإنصاف لن يستمع إليها أحد بعدما نفضت الدول الكبرى يديها منها. ثم تصف لنا الرواية حياة وفكر المؤرخ صاروف بعدما أفرغهما من السياسة والحرب والضحايا، مما أودى به إلى حالة من السكون. لم يعد يؤرقه دويّ الرصاص، ولا حتى قصف مستشفى: «استشهد صاروف بفكرة الفن للفن، فقد كان مع إقصاء الفن عن السياسة تخليصاً للأدب من الأيديولوجيا، فأصبح الشعر للشعر، والرواية للرواية، مثلما الموسيقى للموسيقى، والرقص للرقص، ما يحافظ على نقاء الأدب والفن من الشرطة والمسدسات والأقبية». ومن ثم يدخل ذهن المؤرخ والمثقف صاروف في مرحلة اليأس الذي يسكنه الهوس. في كتابه المرض حتى الموت، يكتب الفيلسوف سورين كيركجارد عن العلاقة بين اليأس والشر: «يريد اليأس أن يثبت وجوده عن طريق كراهيته للوجود، يقدم الشر نفسه كشهادة حية على حماقة الخلق». وهذه هي حال الأستاذ صاروف، الذي أصبح يشيد باليأس ويصبح مهووساً به، وهنا نتلمس هنا العلاقة الفاوستية بين اليأس والاستسلام للشر: «كان يريد تخريب صلته بالحياة، ونزع أية قيمة عنها. اعتقد أنه سيصبح أقدر على فهم العالم ورفضه». وهكذا، ما إن يفرغ المثقف من دور الاجتماع حتى يدخل في قوقعته الذاتية: «تجاهل صاروف مآسي حقيقية، وضخّم مشكلته الصغيرة إلى حد أنها احتلت ساحة تفكيره. أصبح لامبالياً إلا بنفسه، لا يسمع ما يجري على بعد مئات الكيلومترات أو عشرات الأمتار. يعني لا شيء يحدث على الإطلاق. وربما اعتقد أن موت الآخرين حياة له».
الشخصية الثانية التي تتناول عبرها الرواية احتمال التعامي عن الواقع والاستسلام عن دعوة التغيير من الحال السياسي والاجتماعي هي شخصية الفنان التشكيلي ماهر، الذي يلجأ إلى الفن «المفشكل» في رسم الأجساد والعري هرباً من تناول موضوعات الحرب: «لن يصدقوا بأنه لم يبال بالحرب، وإن تذكرها فبالمصادفة. لدى مرور جنازة تنطلق في الشوارع، لاهثة على عجل بلا مشيعين مرئيين، أخفوا رؤوسهم وبكاءهم ودموعهم داخل السيارات. كان بوسعه إنكار أية تهمة توجه إليه. لوحاته لا تحتوي على خرائب وأنقاض، وإذا كان ثمة أجساد في لوحاته، فإنها تشكو من البدانة والتخمة، لا النحول والجوع. من حسنات التجريد أنه يتسع لكل ما لا يتسع له الفن بأنواعه القديمة والحديثة، ما يُنجيه من أخذ موقف إلى جانب أي طرف، وفي الوقت نفسه، يتيح له المجال للانحياز إلى النظام والثورة والمعارضة والمليشيات المذهبية بأنواعها». أما المصير النهائي المأساوي لهذا الفنان فيلخّصه الروائي برمزية السقوط نحو اللاشيئية: «لقد مضى بعزم في دروب اللاشيء، يغوص في تلافيفه، ويتحسس بهوس من يوم لآخر تقدمه في اللاشيئية، متيقناً بأنه بدأ يغدو غير ملموس ولا محسوس في صلب اللاشيء. لو ثابر على هذه الحماقة، فمآله التبدُّد في الفراغ متكئاً على الأثير، لا يحس بشيء سوى أنه جزء من العدم الشامل. وجوده اللاشيئي قارب أن يصبح الحقيقة الوحيدة المقتنع بها، وكل ما هو خارجها لا وجود له».
في رواية تفسير اللاشيء يصل المثقف والمؤرخ الهارب من أحداث الواقع من حوله إلى الهوس باليأس، ومن ثم التحول إلى الهذيان والجنون، أما الفنان الذي يرغب أن يتجاوز في فنه موضوعات الثورة والحرب والموت والخراب فيكون مصيره الإصابة بمرض أو شعور اللاشيئية. كأن الرواية تقول لنا أن احتمالات المثقف والفنان العاجزَين عن التواصل مع الواقع من حولهما بإنتاجهما الفكري والفني، والراغبين في تجاوز الحدث السياسي والاجتماعي من حولهما وعدم المطالبة بالتغيير والالتزام بقضايا المجتمع، تنتهي إلى مصير مأساوي.
ثانياً: الاستسلام للغيبيات
حين ييأس فاوست من تحصيل المعرفة بالجهد والعمل، وحين يصل حدود الشعور بالعبث واللاجدوى في البحث عن أسئلة الحياة، يسقط في هاوية اللجوء إلى الغيبيات. ومنا هنا فإنه يتحالف مع الشيطان تاركاً للقوى الخارقة أن تمنحه ما يبحث ويصبو إليه، ومع هذا الخيار يكون هلاكه ونهايته. كذلك فإن المجتمعات حين تُقمَع وتفقد الإيمان بقدرة الفاعلية والناشطية السياسية والثقافية على التغيير، فإنها تصبح مهيأة للجوء أو للإيمان بهاوية الغيبيات. في روايته الشاعر وجامع الهوامش، يدرس فواز حداد هذه الفرضية، أي لجوء المجتمع السوري إلى الغيبيات، مفترضاً نشوء حركة تدين غامضة مركزها الرئيسي ضيعة مغربال، الواقعة بين الساحل والجبل.
نتابع الرواية مع شخصية فنان أيضاً، لكن شاعر، يكلَّف بمهمة ثقافية وطنية تمتد على خارطة الوطن وتحمل شعار «الشعر ضرورة»، الذي هو عنوان الفصل الأول من الرواية. لكن الشاعر مأمون لا يلبث أن يكتشف أن المهمة الحقيقية التي كُلِّف بها هي الكشف عن «مؤامرة» تأسيس الدين الجديد في مغربال. تتسم شخصية الشاعر مأمون ببعض سمات التحالف مع الشيطان، فهو يقبل بالدعم الذي تقدمه إليه الأجهزة الأمنية والمخابرات في مجال الوسط الثقافي، ويكلَّف من قبلهم بمهمة مقابل الدعم الذي يقدمونه له في الصحافة الوطنية والتكريس الثقافي الرسمي. وهو كذلك يفكر بانتهازية في الكثير من مواقع الرواية: «الوقت غير ملائم للالتحاق بالنظام، الدولة منهكة، تصارع للبقاء على قيد الحياة. طوال سنوات الأزمة نجح في أن يبدو على مسافة واحدة من السلطة والمعارضة. لم ينسجم مع السلطة، ولم يشهّر بها. تعاطف مع المعارضة من دون أن يعارض. نجا من الاثنين فلم يصطدم معهما. هكذا لم يفصح عن موقفه».
في الرواية، تتعدد الأسباب في الحاجة إلى الدين الجديد، فهو ينشأ من خيبة الضباط الذين أكثروا من الجرائم والأخطاء ليلجأوا إلى الدين من جديد (مثال من الواقع: ضباط الجيش العراقي الذين أُقيلوا ليؤسسوا تنظيم الدولة داعش)، وفي الرواية أيضاً يؤمن الشباب المثقف الطامح أن التغيير الأكبر سيكون عن طريق ابتكار دين جديد: «بعد نكبة البلد، والكارثة التي حلت به، سوريا تهدم نصفها في هذه الحرب، ومرشحة لأن تتهدم بالكامل، النظام سيعيد إعمارها إلى النمط الحداثي، وبالتالي الدين الجديد سيأخذ مكانته مع إعادة الإعمار. البلد لا تعمر بلا دين. استعادة التدين لن يكون بالعودة إلى ما كنا عليه، لا سيما وأنه عاجلاً أو آجلاً تحل نهاية الرجعية الدينية. حسْبُ الدين الجديد أن يكون جاهزاً ليواكب سوريا التي ستنفض عنها قريباً غبار الموت، وتصعد من قلب الخراب».
حسب رأي منظري الدين الجديد، فإن العلم والعلمانية والليبرالية والعقلانية، ومعهم الديمقراطية، استنفدوا أغراضهم في القرن الماضي: «سيكون القرن الواحد والعشرين قرن الدين، إن لم يكن، فلن يكون له وجود. لقد جاء دوره، إذا لم يهيمن على العالم، فهذا يعني أنه لن يكون هناك بشر، ولا كرة أرضية مدورة أو مسطحة. إن ما نشهد من رايات سوداء وخضراء وصفراء ليست سوى طلائعه المجنونة في بلادنا. ويتوقع الروائي في هذا الدين الجديد أن تسود أفكار التناسخ والتماسخ والتفاسخ والتراسخ والتقمص، والذي هو عنوان لأحد فصول الرواية: «يظن البشر أن الدين لا يُصنَع، بل يهبط من السماء، لكنه كما نعلم قد يُستولَد من الأرض. إن عجز الإله عن تحقيق مطالب البشر بأبسط الأمور، كتحسين الظروف المعيشية والحياتية على أقل تقدير، ستُشيح بوجه الناس عنه وتجعلهم مستعدين لاستقبال أي دين جديد يعد وهمياً بالحلول».
يشرف على كتابة هذا الدين الجديد شخصية يلقّبها الروائي بالمستشار، الذي يسعى إلى ابتكار دين حديث مستعيناً بسماحة التأويل والتوسع فيه، وتقديم تسهيلات ملموسة تُزيح تكاليف دينية عن العباد وعلى رأسها الصلاة: «كان في إبطال الصلوات الخمس فوائد لا تنكر، الإعفاء من مشقة الركوع والسجود، والاستيقاظ صباحاً باكراً لأداء صلاة الفجر، عدم الانقطاع عن العمل نهاراً، وتوفير وقت إضافي للهو والنوم». وأفتى مؤسس الدين الجديد بمشروعية بعض التصرفات الجنسية، فهادنت تلميحاته الكثير مما يتوق إليه الشبان من قبلات ومداعبات وتلامسات بين الجنسين قبل الزواج، والتساهل الجنسي بين الأزواج.
في الفقرة التالية تتلخص نظرية أصحاب الدين الجديد؛ نظريتهم عن ضرورة تدين معاصر: «إذا كنا سوف نصنع ديننا، فلماذا لا يكون وفق أفضل المعايير، باستدراك ما فات الأديان السابقة التفكير فيه والعمل عليه، أن نكون على الأقل بمستوى الألفيات الثالثة. أمامنا المستقبل وإلى ما لا نهاية. ينبغي حساب عشرات الألفيات القادمة، لنحظى بدين يستوعب عقل هذا العالم الشيطاني، ويسيطر عليه، ما يفرض نهجاً يراعي الحداثة، وما بعده من حداثات وتحديثات. هو دين للجميع، يجد فيه السني والمسيحي والعلوي والدرزي والشيعي والاسماعيلي كل منهم بغيته. دين حقيقي أضيفت إليه محسّنات، يُلغي الحواجز بين الأديان. ودين لا يتعارض مع مبتكرات العصر والعلم الحديث». ومع نهاية الرواية، يقضي النظام الأمني على الدين الجديد وخصوصاً على منظره الأول المستشار، لتكشف الرواية في نهايتها مقولة أن النظام هو الله الوحيد القابل للوجود.
نتوصل مع رواية الشاعر وجامع الهوامش إلى أن الثقافة، من شعر وصحافة المهادنة مع القيم المهيمنة الحاكمة، مصيرها الهامشية واللافاعلية، وأما اللجوء إلى ابتكار دين جديد فلا طائل منه. تركز الرواية إذاً على أن التغيير الأكثر فاعلية هو التغيير السياسي، وأي تغاضٍ عن هذا التغيير على المستوى السياسي لا طائل منه، ما دامت الثقافة مرتهنة للسلطة الحاكمة، وأي دين جديد سيكون مبنياً على مصالح أتباعه. لا مجال للجوء إلى الغيبيات، والفاعلية الفنية والثقافية الحقيقية تتعلق بالتغيير السياسي.
ثالثاً: العقد مع الشيطان
تتألف رواية السوريون الأعداء من فصلين أساسيين، الأول بعنوان «بلاد الخلود والموت»، وهو يمتد من أحداث مدينة حماة في العام 1982 مروراً بكل المراحل السياسية والتاريخية الكبرى المتعلقة بسوريا ولبنان، والحرب مع إسرائيل، وصولاً إلى وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد، بينما يحمل الفصل الثاني عنوان «عالم جديد» ويبدأ مع استلام الرئيس الحالي بشار الأسد للحكم، والمرحلة التي تليها بما يشمل الآليات المتبعة في التأسيس للسلطة الجديدة، ومن ثم قيام المظاهرات الشعبية والثورة في العام 201.. وتتضمن الرواية ما يقارب الأرشيف التاريخي لسوريا والأحداث العالمية المرتبطة بها، وخصوصاً أحداث دول الجوار مثل لبنان والعراق، حيث يتلمس القارئ إلى جانب الجهد الفني السردي أيضاً جهد البحث التأريخي الذي قام به الروائي.
عبر حكاية النقيب سليمان، المتدرج في مواقع السلطة، تدخلنا الرواية إلى آلية عمل الأنظمة الشمولية، وطريقة تفكير الموظفين والضباط الانتهازيين، وكذلك القيم التي تحكم الصراع داخل الأجهزة الإدارية والرقابية والمخابراتية. بينما تأخذنا حكاية الطبيب عدنان إلى غياهب المعتقلات السورية، نسير مع حكاية القاضي رشدي مع شخصية نزيهة ومستقيمة، لنتعرف على الصعوبات والعوائق والمصير المقرر للشخصيات التي تسعى إلى تأدية دورها المهني بنزاهة. في كتابه الجسد في رواية الحرب السورية، يحدد الناقد الراحل حسان عباس في هذه الرواية ثلاثة خطوط أساسية: الخط الأول يرسم انهيار جيل الوطنيين الغيورين على البلد، ويمثله القاضي المتمسك بالعدالة والمحارب للفساد؛ الخط الثاني يرسم صعود الطبقة الفاسدة من الضباط، ويمثله الضابط المهندس الانتهازي الفاشل الذي لا هم له سوى الوصول إلى موقع ضمن بطانة الحاكم؛ والخط الثالث يرسم صعود العنف الدموي وغياب العقل، ويمثله الطبيب الناجي من الموت والذي ينتهي إلى حالة فصام.
منذ بداية الرواية، يبدو النقيب سليمان وقد أسلم نفسه للشر، لكن الروائي لا يرسم شخصية خالصة من الشر، فهو يبيّن أصل النقيب سليمان الفقير، عُقَده الطفولية والطبقية مع عائلة خاله، المثقف البعثي الذي يمثل المعارضة البعثية في السبعينات، ورفض ابنة خاله التي يحبها له. يرسم الروائي إذاً الأسباب التي دفعت النقيب سليمان ليكون ما هو عليه الآن. لقد أوشى بخاله ومجموعته البعثية المعارضة، مما انتهى بهم إلى السجن، وبعد أن قدم هذه الخدمة للسلطات، يبدأ النقيب سليمان بالتدرج في مشوراه الانتهازي الصاعد في المراتب. وتُفتتَح الرواية والقارئ برفقة هذه الشخصية في أحداث حماه 1982.
يبرع الروائي في تجسيد أفكار ومونولوجات الشخصية الانتهازية الفاقدة للحس الأخلاقي. يفكر سليمان: «الإنسانية مثل الرحمة قصة طويلة لا رجاء منها، تصلح للّغو فقط، ولا توفر الألم». في كتابه عن الشر، يوضح الفيلسوف تيري إيغلتون أن الشر سلوك إرادي، أي أن الشخصية الشريرة تقدم على جرائمها بكامل الوعي والإرادة، ذلك ما نلمسه في المونولوج الطويل الذي نقرأه داخل أفكار النقيب سليمان وهو يتأمل بإمكانية قتل عائلة بأكملها دون رقيب في أحياء حماه 82: «لن يمعن التفكير، لن يفوّت فرصة أخرى لن يحظى بها أبداً بمثل هذه البساطة والسهولة. لم يكن توقه العارم إلى إطلاق الرصاص قابلاً للتفسير. كان البرهان لنفسه، لا لأي شخص، على أنه غير عاجز عن القتل. الشفقة لا تحبط هذه الرغبة، إذا لم يُجْهز عليهم حقد على نفسه. لن يدعهم عثرة أمام تحقيق رغبة باتت عارمة، رغبة قتل عائلة بأكملها».
إن المؤلف في المونولوج السابق يُدخلنا إلى ذهن القاتل لحظة القيام بإطلاق الرصاص، وبعد عدة صفحات ندرك أنه أقدم على جريمة قتل العائلة، لنقرأ مونولوجاً آخر يدور في ذهن المجرم بعد الإقدام على تجربة القتل: «الجانب اللافت في المقتلة الصامتة اكتشافه لقدرات كان يمتلكها ويجهلها. القتل ليس بالشيء العسير، وما تحريمه إلا تهويلاً كيلا يستسهله البشر. مارسه كفعل نظيف من الايحاءات المغالطة والملعونة. لن يتبرأ منه أو ينكره. كان إنجازاً ناجحاً وبارداً. لم تهتز فيه شعرة واحدة، خشي من فرط بساطته ألا يكون حقيقياً».
يرسم أيضاً الروائي شخصية القاضي رشدي النزيه. يصف جهوده داخل السلك القضائي: «كان ما يتمناه تحقيق نواة صلبة من القضاة الشبان، يحرصون على القانون قبل أن يفقد هيبته بالكامل. كانت سمعة المحاكم والقضاة في انحدار متسارع نحو الحضيض. طمح الأستاذ رشدي إلى إيقاف تدهورها في محاولة يائسة لاستعادة القضاء تأثيره. لكن ما أرداه كان مستحيلاً». محاولات هذا القاضي تبوء بالفشل في إدارات قائمة على الفساد: «ما حققه انقلب ضده، أصبحت العدالة ملاحقة والقاضي مداناً». كيف يمكن إصلاح قطاع القضاء في عالم يجري فيه التهافت على المزايا والترقيات والمناصب والعلاوات، من خلال الإمعان في التلفيق والابتكار في التعذيب. هذه مثلاً حكاية الرائد مروان، الذي حقق من خلال عمله في المخابرات نجاحات يحسده عليها زملاؤه ورؤساؤه، فقد حصد شهرته من قدرته الخارقة على انتزاع اعترافات المتهمين، وعرقل أكثر من مرة إطلاق سراح محتجزين وأعادهم إلى التحقيق، وتسبب بموت معتقلين تحت التعذيب، «في سبيل الواجب» كما كان يقول. وكأي ميثاق مع الشر، يتم السقوط رويداً رويداً، فيعيَّن النقيب سليمان بالمناصب لاعتقاد مرؤوسيه بقدرته على ابتكار نظريات المؤامرة: «إن لم يكتشف مؤامرة، فسوف يخترعها، كان هذا هو المطلوب، استباق الخطر، ولو كان مجرد افتراض أو توهم».
في سهرة خاصة، يجري الحوار بين الرائد والنقيب عن القتل والإيمان: «ليس بوسعك أن تقتل وأن تؤمن بالله في الوقت نفسه». هل كان الجنود مجرمين، أم حولتهم الإباحة إلى قتلة؟ أم كانت الوحشية متنفساً لغرائز القتل والاغتصاب والتدمير؟ هل الدين أو الكفر هو الذي شجعهم على عدم الرحمة؟ الرائد والنقيب يعتقدان أن القتل ضرورة لا بد منها ما دام هناك من يتقبله على أنه نعمة إلهية، فهو من طرف ينظف العالم، ومن طرف آخر يمنح لأنصار النعمة الإلهية مسوغات الموت السعيد. يقول الرائد: «هذا زمان السفلة الأوغاد منقذي العالم من الإيمان، يكشفون قدرة الله، الذي بلا قدرة. القضاء على رب الإسلاميين يتحقق بالتيئيس منه، فهو عاجز، لا يحمي ولا يساعد ولا ينقذ».
يضيف إيغلتون في عن الشر أن الفكر القمعي أو المتطرف دينياً يسعى إلى إلغاء الآخر للإحساس بوجوده الخاص، وهذا ما يفصح عنه الحوار بين الرائد والنقيب: «المعتقد الديني لا يتبخر مهما أصابه من انحسار، لا يُمحى إلا بقتل الله القابع في الرؤوس. الله فكرة بحتة، لا وجود مادياً لها، ولا خلاص منها، الأجدى والأسهل قتل المؤمنين بها، دونما تمييز بينهم، مسلحين كانوا أو عزلاً».
تحتل موضوعة التعذيب مساحة واسعة من ثلاثية الروائي فواز حداد، وتحضر هذه الموضوعة بشكل أساسي في هذه الرواية، بينما تحضر في رواية الشاعر وجامع الهوامش موضوعة التعذيب اغتصاباً بالتحديد. أما في السوريون الأعداء، وعبر حكاية الطبيب المعتقل عدنان، يُدخلنا الروائي في رسم دقيق لعالم الاعتقال، العلاقات بين المعتقلين، بينهم وبين الجلادين، مونولوجاتهم الداخلية، وأفكارهم عن العالم الخارجي: «لقد تحولوا إلى بقايا بشر، همهم تجنب العذاب، يُمضون الوقت في مداراة أوجاعهم، ولملة ذكرياتهم، عسى ترد إليهم ماضياً بات كل حياتهم؛ يتآكل من يوم لآخر وكأنه لم يحدث، لم يكونوا فيه مرغمين على الانسياق في حياة أخرى. قدرهم فيها لا يزيد عن قدر الحيوانات والبهائم».
يبرع في وصف آثار التعذيب على ذهن ونفسية الطبيب عدنان: «أما هنا فالتعذيب ليس لكتمانه معلومات يعتقدون أنه يمنعها عنهم، بل لتحويله إلى إنسان لآخر، إنسان ليس بإنسان، ولقد تحول إلى ما يشبهه، إلى إنسان لم يعرفه من قبل، بلا كرامة ولا إحساس». وهكذا ومن شدة التعذيب وقسوة الاعتقال، يولد بداخل الطبيب عدنان شخصية أخرى هي المعتقل 77. يلجأ الروائي إلى رمزية فانتازية، حيث ينقسم المعتقل المعذَّب إلى شخصيتين: الطبيب عدنان والمعتقل 77، وتجري الحوارات بينهما في عدة فصول من الرواية، تتناول الأخلاقيات في المعتقل. إنهما على طرفي نقيض بين الأخلاق واللاأخلاق. هذا الابتكار الفانتازي نادر الوجود في أعمال الروائي فواز حداد، لكنه هنا يحمل الكثير من الترميز النفسي والذهني عن تجربة التعرض للتعذيب والاعتقال.
وفي سبيل إرضاء مرؤوسيه، يبتكر النقيب سليمان حملة مضمونها بأن الرئيس مؤهل لشغل مكان الله: «أو لماذا لا يكون الله؟ دعوة تحفل بالعظمة المطلقة، ستمنح الخلود للرئيس. عندئذ من سيتجرأ على منازعة رئيس محصن بالخلود». ويكون أول من يطلق حملة صور الرئيس في كل مكان بمناسبة الحركة التصحيحية، ويفرض عرف تشييد تماثيل للرئيس في المدن والبلديات والقرى، كما يطلق سلسلة كتب عن حياة الرئيس منذ كان في المدرسة الإعدادية، مع التركيز على نشاطه الحزبي في الثانوية، وخروجه في المظاهرات، والنواحي الفكرية في خطاباته، إضافة إلى أشعار المديح. وتتابع الرواية: «لم يدرِ أنه أطلق المشروع الأكثر طموحاً، في العاصمة لم تعد المكتبة الوطنية، بل مكتبة الأسد، وأطيحت معها المسميات القديمة. تلقّفته قطاعات الدولة كلها: التربية والتعليم، الرياضة، الخدمات السياحية، المواصلات، الصناعة، التجارة، الزراعة.. كان اللاهثون إلى مهر منشآتهم وأعمالهم بالأسد أكثر من أن يحصوا، وفاء لديون الرئيس دون أن تفيها حقها».
القسم الثاني من الرواية يجري بعد 30 عاماً، وفيه مرحلة استلام الرئيس الحالي (بشار الأسد) السلطة، فتتكرر الحملات «الثقافية»/البروباغندا التي ابتُكرت سابقاً للرئيس الراحل لتثبّت حكم الرئيس الجديد، ولكن مع استعمال لغة جديدة أقرب إلى اللغة الاجتماعية المعاصرة: «منحبك»، بديلاً عن «إلى الأبد». لكن الجديد الذي يحمله هذا القسم من الرواية هو الدور الذي يقوم به النقيب سليمان إزاء المظاهرات الجماهيرية المعارضة للنظام الحاكم بعد العام 2011: «فبينما كان القناصة يصطادون المتظاهرين، كانت الوفود الرسمية القادمة من العاصمة تطلق الوعود للوجهاء. لقد خشي النقيب سليمان وأمثاله من قيام نظام ثوري يطاله ويطال معه جميع الذين دافعوا عن النظام طوال أربعين عاماً، ويزج في السجون المئات من المسؤولين الذين تعاقبوا على الحكم. أما المساجين مناهضو الدولة، فالبراءة وإعادة الاعتبار. وتبدأ رحلة تبادل الأدوار». فعمل على قمع المظاهرات والمداهمات، وقتل الناشطين السلميين تحت التعذيب، وتوزيع الفيديوهات المصورة بالهواتف الجوالة التي تحتوي على مشاهد حية لإذلال الأهالي الأبرياء وغير الأبرياء.
يعمل النقيب سليمان على تفعيل المظاهرات المؤيِّدة والتي تقتحم على المظاهرات المعارضة الساحات وذلك ليضرب الشعب بالشعب، كما عمل جاهداً لإشاعة الخطاب الطائفي عن محاولة السنة لقتل العلويين، ثم ساهم في تسليح الطوائف ضد بعضها البعض: «صياغة سيناريوهات عن المؤامرة والحرب الأهلية والهجمات الحاقدة على النظام، تطلب ابتكار إرهابيين وهابيين وسلاح ودماء وضحايا، كي يصبح سحق الاحتجاجات مشروعاً ومباركاً من الغرب الكاره للإسلام والخائف من الإرهاب». وفي النهاية، فإن مصير النقيب سليمان كمصير من تعاقد مع الشيطان، إنه الانجرار طواعية وبإرادة وفكر وسلوك ذاتي باتجاه الجحيم، فهو يطلق النار على نفسه انتحاراً في نهاية الرواية، عندما يتم الكشف عن اشتراكه في مؤامرة لاغتيال الرئيس الراحل في الثمانينات بالتنسيق مع أخيه بقيادة رفعت الأسد، لتبين الرواية المصير المأساوي للتعاقد مع الشيطان.
تتضمن ثلاثية الروائي فواز حداد العديد من المحاور والموضوعات الأخرى المتعلقة بدور القضاء والثقافة والجامعة والفن خلال المرحلة التي تعيشها سوريا منذ 2011. لكن هذا النص سعى لتقديم تأويل لها يتعلق بحكاية فاوست، وذلك بالتزامن مع مرور عقد على الثورة السورية، حيث يجد السوريون أنفسهم أمام أسئلة فاوستية بامتياز: هل يمكن الاستسلام لليأس والتغاضي عن قضايا الواقع؟ هل يمكن العثور على الحل بعيداً عن السياسة باللجوء إلى الغيبيات؟ وهل يمكن القبول بالسلطات المتعددة المفروضة على الشعب السوري والتعاقد مع الشيطان؟
-
المصدر :
- الجمهورية