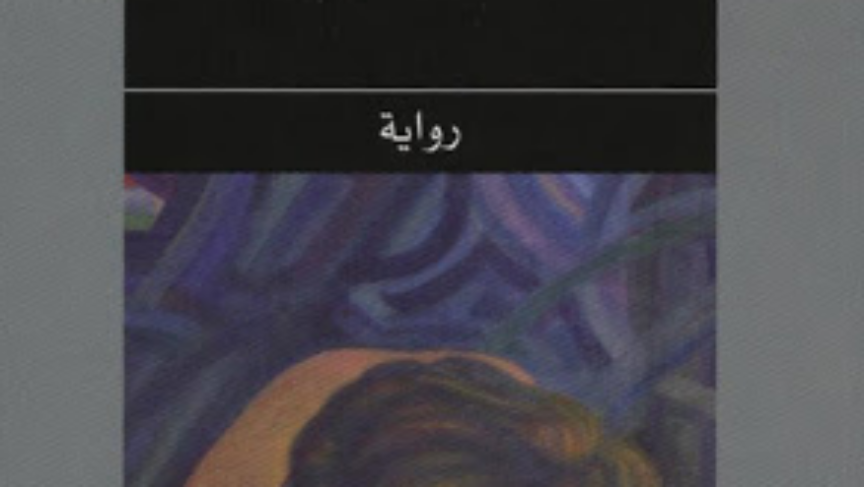تنحاز أعمال الروائي السوري «فواز حداد» إلى الواقع دون مواربة أو تنميق، مواكبة المتغيرات العاصفة في العالم العربي، طارحة تساؤلات ملحة حول الهوية والمصير والدين. يحاول حداد خلق (ثيمة) من الثورة السورية تندرج تحتها قيم الخير والعدالة والإنسانية. وكونه يكتب عن مرحلة هامة في تاريخ سوريا والعالم العربي فمن الطبيعي أن يثار الجدل وتتباين الآراء حول مواضيعه الروائية.
عن الرواية وعوالمها، وعن تأثير البيئة والحرب السورية في شخصية وأعمال فواز حداد جاء هذا الحوار ..
□ كيف بدأت علاقتك بالكتابة؟ وماهي تأثيرات البيئة على عالمك الأدبي؟
■ بدأت علاقتي بالكتابة بشكل مبكر، كتبت عدة قصص قصيرة في الرابعة عشرة من عمري، وكانت جيدة حسب أستاذ اللغة العربية، ما شجعني على الكتابة. أتذكر في ذلك الوقت أنني كنت متأثرا بتشيخوف في بعض قصصي، وبعضها الآخر بطلها ما كان يدعى بالرجل الصغير يتعرض لمصادفات تضعه في قلب أحداث جسيمة. قدمت لي البيئة الدمشقية التي عايشتها بين أفراد عائلتي، قدرا كبيرا من الحب والأمان في بيتنا الشامي. وكانت الحارة والمدرسة والجامعة، مسارحنا في دمشق الستينيات، وما فيها من أسواق وأزقة وكافيتريات ومقاهي وسينمات ومسارح وكتب. ما سوف أدركه بعد سنوات، أننا عشنا في بيئة منفتحة في علاقاتنا مع الجوار، فقد ضمت الحارة عائلات من عدة أديان ومذاهب. بالمقارنة، يبدو هذا المشهد اليوم أسطورة وكأنها صناعة الخيال، فقد بلغ احترام العقائد أن والدتي كانت تنذر النذور في السيدة زينب، كذلك في دير صيدنايا. بينما في العقود الأخيرة، تنظر الطوائف إلى بعضها بتوجس وحذر، إن لم يكن بعين العداء والحقد، وهو أمر لا يصعب تفسيره في زمن نظام البعث الأسدي.
من ناحية أخرى تدين أغلب رواياتي للمكان الدمشقي، تدور في حاراته وأزقته ومرابعه. نشأت منفتحا على كل ما يصادفني ولم أتحرز من أحد مطلقا، وأنا أعني هذا التعبير، أي مطلقا بالفعل، لم تكن لدينا أية أفكار مسبقة، كانت لدينا مشاهداتنا وعلاقاتنا الشخصية والاجتماعية، كان هذا من طبيعة البيئة التي نشأت فيها، لم أشعر بأي تمييز أو فارق مع الآخرين. بينما في السنة الأخيرة في الجامعة وخدمتي في الجيش، أحسست بالتحولات الجارية، كان جنود سرايا الدفاع ورجال المخابرات يستفزون الناس ولا يقصرون في إهانتهم، كان لديهم ضغائن وأحقاد لمجرد أن هناك أناس يصلون، كان في علو النبرة الطائفية استهتار بالبشر وتعدٍ عليهم. ويمكن اضطهاد أو اعتقال أي شخص بسبب ودون سبب. كان من الطبيعي اتخاذي موقفا ضد الطائفية، وجهدت منذئذ ألَّا تكون لدي أية صلة مع النظام، فلم أتوظف أو أنتسب إلى ما كل يمت إليه بصلة.
من المبكر الحكم على النتاجات الأدبية وعن مراعاتها أصول الفن الروائي وغيره، إنها جديدة ومختلفة عما ألفناه؛ شهادات وقصص وتوثيق وروايات صادقة تحتفظ بقيمتها من هذه الناحية كمراجع عن هذه الفترة، لن يستطيع التاريخ الرسمي دحضها ولا تجاوزها، إنها ابنة يوميات حدثٍ لن ينتهي
□ وما قصة اتهامك بالطائفية؟
■ اتهمني بالطائفية، ناقد ذو تاريخ أيديولوجي، وهو لا يزيد عن شغيل ثقافي، وضع كبار الأدباء السوريين في قائمة الرجعية والبرجوازية وأخرجهم من تاريخ الأدب. هوس التصنيف يعاوده من حين لآخر، هذه المرة كان تصنيفا مخابراتيا. ويمكن فهم، ما جمع بينه وبين أمثاله من المثقفين؛ لم يقصروا ببذل جهودهم في إحالة انتفاضة السوريين إلى إرهاب. لملموا بعضهم بعضا على اختلاف مشاربهم ووقفوا صفا واحدا مسلحين بعلاقاتهم الطائفية، وكانت صولاتهم وجولاتهم بدعوى أنهم علمانيون، لكن ماذا عن الضمير وضحايا لا يقلون عن مليون سوري؟ إذا كان النظام علمانيا، فانحطاطه يفسره أيضا أن هؤلاء بطانته المشؤومة على الثقافة. الطائفية سلاح حقير وقذر يستعمله الاستبداد كي يمزق البشر ويدفعهم إلى التقاتل، هذا البلاء الذي أصاب السوريين، لم يخترعه الناس، بل النظام ومن يعملون لحسابه.
□ ما رأيك بالنتاجات الأدبية في فترة الربيع العربي بشكل عام؟ وهل ترى أنها قادرة فنياً على مواكبة المتغيرات التاريخية والثقافية في العالم العربي؟
■ تتالت النتاجات الأدبية أشبه بانفجارات على مدى عشر سنوات دون توقف، وما زالت مستمرة، المهجرون بعد طول صمت وقهر، تنفسوا الصعداء رغم المآسي، افرجوا عن مشاعرهم وتوقهم إلى التحرر، بعدما شارف زمن القمع على الانقشاع، فكانت الكتابة أشبه بالخلاص منه، بعضهم كتب عن تجارب شخصية، أو كان شاهد عيان عليه، أو سمع به. لا يوجد في سورية شخص واحد إلا ولديه رحلة شاقة من العسف والشظف، والصدام مع الأجهزة البوليسية.
بعد هذه السنوات أتيح لهم التعبير عما قاسوه، وما يقاسيه الذين في الداخل أو في مخيمات النزوح والمهاجر. هناك حركة هجرة واسعة من البلد، ما الذي تعنيه طوابير البشر أمام مبنى الهجرة والجوازات، إنهم يفرون من بلدهم، هل لأنهم يعيشون حياة سعيدة؟
من المبكر الحكم على النتاجات الأدبية وعن مراعاتها أصول الفن الروائي وغيره، إنها جديدة ومختلفة عما ألفناه؛ شهادات وقصص وتوثيق وروايات صادقة تحتفظ بقيمتها من هذه الناحية كمراجع عن هذه الفترة، لن يستطيع التاريخ الرسمي دحضها ولا تجاوزها، إنها ابنة يوميات حدثٍ لن ينتهي، قبل أن يشكل منعطفا تاريخيا، وأيضا ذكريات حية، يُشهد لها بأنها تسجل أكبر واوسع طاقة تعبيرية عن الألم، ربما في العالم، لا توازيها إلا ضحايا الستالينية، بل وتتميز عنها في أنها شهادات حية، لم تمض عليها العقود. أما إن كانت تواكب المتغيرات التاريخية والثقافية في العالم العربي، فهذا السؤال في محله تماما، لأنها هي التي تواكب هذه المتغيرات، وتعبر عنها في بلد يحتاج إليها، بل وتضيف إليها نفحة من الحرية الضرورية.
□ وإلى أي حد غيّرتك الحرب في سوريا؟ وما مدى تأثيرها المباشر عليك كروائي؟
■ كانت الحرب من نتائج الثورة وللقضاء عليها، غيرت الجميع، أنا واحد منهم، تأثرت فيها، حتى النظام وأعوانه تغيروا نحو الأسوأ، إنهم ينتقمون من الناس بتجويعهم ودفعهم إلى الركض وراء لقمة العيش، والتضييق عليهم لتهجيرهم. أسوأ كارثة مرت على سورية، وتجاوزت سنوات محنة السفر برلك، التي بعد مضي أكثر من قرن لم ينسها التاريخ، ويُكتَب عنها في الرواية أو المسرح.
بالنسبة إليّ وللكثيرين، ما جرى ويجري لا يجوز أن نغفل عنه، أنه يحدث أمام عيوننا، ويدفع الناس ثمنا باهظا لتحمل نتائجه المأساوية، الأدب مدعو للكتابة، الشهادة الادبية قد تفوق شهادة التاريخ، التاريخ سيخضع للأخذ والرد، قد يستطيع تعرية سردية النظام المعلنة، بينما الرواية سردية البشر، يكتبها السوريون أنفسهم. أما مثقفو النظام فيتنطعون لروايات وشهادات تبرئه، مع أنهم عملوا حساب، لو أن النظام سقط فسوف يدينونه، هؤلاء يلعبون على الحبال كلها. مسألة أن تكتب رواية، يعني أن تقول الحقيقة من خلال الرواية، مهما خالطها من خيال، لن يكون خيالا، ولا متسع له فيها؟ الواقع يستأثر بها، الواقع لا يُجير لأية أيديولوجية، ولا لنظام أو زعامة، سوى للحقيقة.
□ ولماذا ترى أن الرواية قادرة على نقل رؤيتك للواقع وللعالم أكثر من القصة؟
■ طبعا، ليس بسبب عدد صفحات الرواية التي تزيد عن عدد صفحات القصة القصيرة؛ القصة عبارة عن لقطة لافتة، تذهب إلى الهدف مباشرة، مقطع من الحياة، مهارة لا تتوفر لدي أي كاتب، لذا كتاب القصص القصيرة قلائل جدا. عدا أنها موهبة، تخالطها البراعة في الكشف من خلال لمحة أو موقف عابر، ما يُختزن من عمق إنساني. بينما الرواية جنس مختلف، رحب، يتسع لعوالم أكثر من أن تحصى، عالم لا يحده حدود، عالم الناس، عالم الذات، عالم كل انسان. إمكانات الرواية هائلة، لا تنضب. بينما تهتم القصة القصيرة بتفصيل دقيق، أو بحادثة. تسعى الرواية إلى الالمام بعالم معقد، وتتسع لتقنيات كثيرة، وربما كان لكل روائي أسلوبه. الرواية لم تعد صنعة المدن، بل القدرة على التعامل مع قضايا كبيرة وإشكالات إنسانية دقيقة، تتكاثر في عالم يتوسع باطراد، عالم تقصر عنه القصة القصيرة، اختزاله مقتل له.
في الرواية، لا تفرقنا الأديان، إنها في العمق تجمع ولا تفرق، لذلك يرغب النظام في السيطرة على الدين وتجييره لمآربه. هناك الكثير مما يقال عن المذاهب، جعلوا منها صندوق باندورا لتخرج منه آلاف الثعابين، علينا نحن السوريين ألا نسعى إلى اغلاق الصندوق، بل إلى القضاء على الثعابين.
□ في روايتك «الشاعر وجامع الهوامش» دعوة قوية لإعادة قراءة المجتمع السوري من جديد. فهل يمكن إعادة ترميم الهوية السورية المتنوعة مرة أخرى؟
■ ليس هناك ما يعيد ترميم المجتمع السوري والهوية السورية سوى إعادة النظر بأنفسنا، يجب الإحساس بأننا بشر يحق لنا العيش بكرامة، وإننا الانسان نفسه مهما كانت عقائدنا وانتماءاتنا، وأننا في جغرافيا لا تقبل الانقسام، ولا الفرقة، بل العيش المشترك. إننا شعب واحد لا شعوب متقاتلة. لا يمكن لهذا الشعب أن يُحكم بأجهزة المخابرات، وادعاءات أن المؤامرات تترصد بنا؛ المؤامرة الوحيدة هي هذا النظام.
هناك رغبة قوية في العيش معا، يعيقها وجود سلطة لا يمكن لها الاستمرار في الحكم إلا باختلاق التناحرات والخلافات ودفعها إلى الحدود القصوى، وتحويلها إلى هويات كراهية تُستثمر في التقاتل. علينا أن نعي أننا جميعنا ضحايا هذه السلطة، متى كان الشعب يورث بكامله لعائلة تفتك به؟ ليس هناك توكيل إلهي، إنها قصة اختطاف دولة وشعب ومستقبل، بتوظيف عسكر وحزب لتحقيق طموحات سلطة جشعة، لا يمكن لعقل أن يستسيغها، سلطة لا تفكر إلا بالنهب، وكيف تُهرب الأموال إلى ملاذات آمنة. العالم ليس مخدوعا، والشعب ليس قاصرا، إن الديمقراطية قدر.
في الرواية أثبتُ خطل دعاوى ما يقال له البيئة الحاضنة للنظام، إنها بيئة واقعة تحت عسف عصابات ميليشيات التشبيح، وتشعر بالظلم أسوة بالسوريين جميعا، بيئة فقدت رجالا وشبانا في حرب عبثية. بيئة تدفع ثمنا باهظا لمجرد الاعتقاد بأنها تساير مآربه، ومثلما في كل طائفة هناك مغرر بهم، تأثرت بدعايات سلطة عائلة تريد أن تحكم للأبد.
في الرواية، لا تفرقنا الأديان، إنها في العمق تجمع ولا تفرق، لذلك يرغب النظام في السيطرة على الدين وتجييره لمآربه. هناك الكثير مما يقال عن المذاهب، جعلوا منها صندوق باندورا لتخرج منه آلاف الثعابين، علينا نحن السوريين ألا نسعى إلى اغلاق الصندوق، بل إلى القضاء على الثعابين.
□ أثارت روايتك «السوريون الأعداء» الكثير من الجدل، فما العلاقة بين الأدب والسياسة؟ وأيهما يلقي بظلاله على الآخر؟
■ في الواقع لم تثر الرواية الجدل إلا في الداخل السوري، بين مثقفي النظام، أنهم في الخندق المضاد؛ فالرواية تعرضت للطائفية وهو موضوع يعرفه الجميع، الكلام ممنوع حوله لان النظام يستثمره لحساباته التسلطية، الرواية سمت الأمور بأسمائها، أسمت السنة سنة والعلوية علوية والمسيحية مسيحية، هل لهم مذاهب وأديان أخرى؟ على هذا الأساس جري تصنيفهم في مناصب الدولة والجيش وأقبية المخابرات. عندما تحصد المجازر الطائفية الآلاف، فمن الخيانة ألا نتكلم، هل نصمت عنها؟ في الرواية لم اتهم أية طائفة، لأن المتهم معروف، إنه المستفيد من إيقاع الكراهية بينهم. بصريح العبارة كتبت عن التغرير بالطوائف كلها على مدى نصف قرن، واستخدامها لخدمة مآرب النظام. في الرواية، لا يمكن تجاهل ما جرى على الأرض، هناك حقائق لم ابتدعها. لا يمكن للرواية النجاة من السياسة، أحيانا تكون موضوعها، ومن الخداع التقصير في فهم ما يجري. إذا أردنا كتابة رواياتنا التي تعنينا فعلا، فلا يمكن تجاهلها. هل يجوز تجاهل الطائفية التي استخدمت ضدنا جميعا؟
لقد اضطررنا للخروج من البلد كي نكتب بحرية، إذا لم اكتب الحقيقة، فلماذا هذه الحرية؟ هل للمخاتلة في كتابة الحقيقة؟ لماذا اتمتع بحرية دون ان استعملها، حريتي ليست للرفاهية، هل لأصمت في الخارج أيضًا؟ لا خشية من القمع ولا الرقابة لقد صار بوسعنا الكتابة بحرية. هل نتنازل عنها؟
هناك مثقفون خونة، وابتليت سورية بأردأ الأنواع، هناك شبكات تحميهم وتتستر عليهم في الداخل والخارج، كوفئوا بتتويج خيانتهم بالجوائز، والخداع يذهب بهم إلى التباهي بأنهم لم يخرجوا من الوطن، يقاسون مع الشعب، بينما يتمسحون بمآسيه.
رواياتي ليست سلسلة، أعتقد أنني أكتب عن العصر الذي عشته، أحاول أن يكون حاضرا فيها بطيوفه الاجتماعية والسياسية والثقافية. أما مشروعي الأخير عن العشرية الأخيرة، فما زال هناك روايتان لاستكماله، الأولى عن النظام كيف خلق أنظمة وأساليب ملحقة به وامتدادا له، تغلغلت في جميع مناحي حياتنا.
□ لكنك ترفض أن ينظر إلى الرواية على أنها تحمل في طياتها ملامح سياسية؟!
■ أرفض اعتبارها ذات طبيعة سياسية بحتة، إنها عنا نحن؛ حياتنا ومصائرنا، عذاباتنا وموتنا، إنها عن زراعة الأحقاد، إنها عن مجتمع مفتت منقسم على نفسه، مجتمع يتعرض للإهانة يوميا، إنها عن الفساد الضارب في مفاصل الدولة كلها. هل إذا اشتبهت آلام البشر بالسياسة، يجب الامتناع عن الكتابة عنها؟! ألا تهدف السياسة إلى تحقيق العدالة والحرية وتنشد المساواة؟ يريد الناس صناعة عالم حر، بينما النظام يصنع القهر.
يصادف الروائي في الكتابة حقائق ربما كانت سياسية، وهي في النهاية حقائق إنسانية، هل يتجنبها كرمى لهؤلاء الذين يستقدمون جيوشا وميليشيات أجنبية لتحتل البلد، ويلفقون القناعات عن أن الوطن لا تشوبه شائبة طائفية بينما هي تنغل فيه؟
□ ومتى تنتهي علاقة الروائي بمنتوجه؟
■ علاقة الكاتب بمنتوجه لا تنتهي، إنه جزء منه، إلا إذا انقلب عليه، ما يشكل دليل إدانة ضده. ما أكثر الذين انقلبوا على ما كتبوا وبشروا به، وادعوا أنهم آمنوا به. كان الإيمان بالثورة على الأوضاع الفاسدة يبلغ درجة اليقين. ما الذي حدث عندما اندلعت؟ تنصلوا منها وكالوا لها مختلف الاتهامات، مع أنهم اكتسبوا سمعة مثقف من جرّاء التلويح بها، وإذا كانوا قد وصفوا الثورة بالزلزال، فليس تقية، وانما فبركة توصيف يذهب بالثورة إلى الارهاب.
□ روايتك الأخيرة «يوم الحساب» هل هي تعبير عن تأسيس للمتخيل في الحدث السوري؟ أم استشراف للمستقبل؟
■ لا علاقة لها بالمتخيل، إنها عن الواقع، لا استشراف المستقبل، فلندع المستقبل لما سيأتي به، إنها عن الحساب في هذا العالم، وليس في العالم الآخر. عن إدانة الجرائم والمجرمين، القهر واللا عدالة. هناك أناس فتحوا عيونهم واغمضوها على الظلم، لم يعرفوا واقعا غيره، ولا خلاصا منه، وكأنه الأبد، فعاشوا وماتوا تحت ظله المشؤوم، وكأن ليس للحياة وجه آخر، وأن العالم هو هذه الطغمة، ولا بديل عنها، والعسف مؤبد، الشر باق وإلى امتداد، ولا انتهاء. يجب كسر هذه الحلقة، وأن يحاسبوا في عالمنا هذا. إن إحقاق الحق، انتصار للضحايا وهزيمة للشر. يجب أن نؤمن بالعدالة، هناك توق إلى الحرية، لن يعيد غيرها الروح إلى الإنسانية المفتقدة في حياتنا.
□ وهل هي تتمة لمشروعك الروائي والبالغ حتى الآن 15 رواية؟ أم أن هناك المزيد من الأعمال ضمن هذه السلسلة؟
■ رواياتي ليست سلسلة، أعتقد أنني أكتب عن العصر الذي عشته، أحاول أن يكون حاضرا فيها بطيوفه الاجتماعية والسياسية والثقافية. أما مشروعي الأخير عن العشرية الأخيرة، فما زال هناك روايتان لاستكماله، الأولى عن النظام كيف خلق أنظمة وأساليب ملحقة به وامتدادا له، تغلغلت في جميع مناحي حياتنا. والثانية عن الثقافة والمثقفين، وبالضبط عن المثقفين الخونة في هذا الزمن، مع أنى كتبت عنهم في «المترجم الخائن» أي أنني سأتابع تحولات هذا النمط في زمن مضطرب. هذا المشروع مساهمة جزئية في الربيع السوري الذي تحول إلى جحيم. هناك الكثيرون غيري يكتبون أيضا، وفي مجموعها سردية لهذه الفترة العظيمة والمؤلمة. وهناك من سيأتي بعدنا ويكتب عنها.
-
المصدر :
- القدس العربي