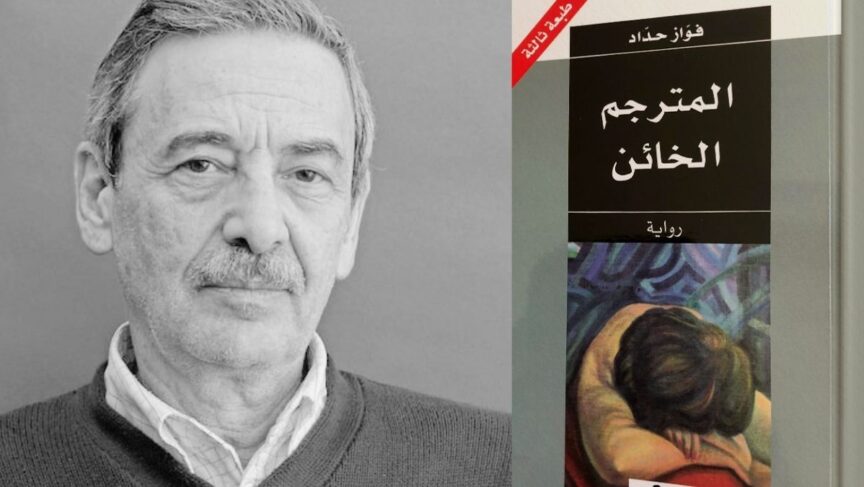التصقت أسماء بعض الروائيين بمدن معينة سواء كانت حقيقية أو متخيلة، عُرفوا بها، كما عُرفت بهم. فنجيب محفوظ ارتبط اسمه كما أعماله الروائية بمدينته القاهرة، ومثله فؤاد التكرلي ببغداد، بينما جيمس جويس بدبلن، ولورانس داريل بالإسكندرية، وغيرهم. كذلك المدن المتخيلة التي لا وجود لها، والتي هي من اختراع كتابها، ارتبطت بأسماء مؤلفيها، فـ”ماكوندو” من ابتداع غارسيا ماركيز احتلت مشهدية روايته “مائة عام من العزلة”. وسبقه الأمريكي وليم فوكنر بـ “يوكناباتوفا” التي دارت فيها أحداث سلسلة رواياته بدءاً بـ”سارتوريس” ولم تنته بـ”الصخب والعنف”. مدن ضارعت الحقيقية، ونسبت إليهم على أنهم خالقوها، وإن استقيت معالمها من مدن القارة الأميركية.
تشترط الكتابة عن المدن الحقيقية، التقيد بالمدينة الموصوفة الموجودة على الخارطة في زمن محدّد، إذ دمشق 1950 تختلف عن دمشق 2013. أما المتخيلة فلا تشترط الدقة، خارطتها موجودة في ذهن صاحبها، بوسعه التصرف بملامحها كيفما يشاء، على أن تراعى فيها شروط المدينة، فلا مدينة بلا معالم، أو بمعالم متفردة عن المألوف، إلا إذا كانت من مدن الخيال العلمي، أو الأحلام والأساطير، حيث المدينة قلعة حديدية، أو سفينة تربض على ضفاف الأنهار، أو تسبح فوق الغابات والجبال.
ومثلما الرواية تتحرك في الزمان، تتطلب مكاناً تتجول فيه شخصياتها. ومهما كانت فلا بد من تلك الرقع المكانية التي تشكل جغرافية العمل الروائي. هذا من أبسط دروس الرواية، التي لا تحتاج إلى تعليم وتعاليم. فالمكان يشكل فضاء الحدث، ليس بشكل اعتباطي، فلا يتواجد أبطال الرواية دون مبرر في مكان دون آخر، إلا لسبب أو هدف. كما للمكان دلالة، فالقبو غير السقيفة، والحقل غير الحديقة. كل منها يوحي بتساؤلات ومخاوف وأوهام، أو الشعور بالاطمئنان والارتياح، أو بالترقب والرعب.
كان جويس يراسل أقرباءه، يسألهم عن بائع الجرائد أو الحانة التي في شارع كذا، هل مازالت عند المنعطف، ويستفسر عن تصميمها، وما كتب على لافتتها، وما آل إليه حالها. بحيث يمكن اعتبار روايته العملاقة “عوليس” إضافة إلى أنها علامة في تاريخ الرواية العالمية، تشكل أيضاً دليلاً إلى معالم دبلن الكبرى والصغرى، لا تهمل حتى تلك الأمور الدقيقة التي يقال عنها تافهة.
لماذا يلاحق الروائي أحياناً هذه الأمور التافهة، التي على الأغلب لن تعني الكثيرين، إلا ربما المؤرخين، هذا إذا كانت التوافه اختصاصهم. هل يرغب الروائي بتثبيت صورة للمدينة تعود إليه، يستعيد المدينة التي كانتها، كما عاش فيها، بصورتها التي لا تتغير، ربما وهبته فسحة للعيش في ماض، لم يتبدد هباء، كأنما هو ومدينته كيان واحد، هو بعضها وهي بعضه، لا ينفصل هذا عن ذاك. في رجوعها إليه، رجوع إلى ذاته. ترى في هذه الحالة أو الحالات، هل يتحول المكان إلى مأساة؟
المشهد الغالب اليوم، هو تدمير المكان السوري، بجميع معالمه، الأحياء الشوارع البيوت المساجد المزارات المقابر… لا يقتصر الدمار على مدن وقرى الأرياف، بل امتد وشمل أحياء المدن الكبرى كدمشق وحلب وحمص…
في يوم قادم، سوف تكون الكتابة عن المدن أشبه بعودة المؤرخين إلى التاريخ، كما في الكتابة عن دمشق منتصف القرن التاسع عشر، أو حلب أوائل القرن الثامن عشر، أو اللاذقية زمن الانتداب الفرنسي، يمكن للمؤرخين بالنسبة لدمشق على سبيل المثال، أن يسترشدوا بمعالم ذلك الزمن على الأرض الدمشقية، فالتكايا والزوايا والمساجد والأزقة والزواريب والقبور ما زالت شواهدها، تختزنها حارات القيمرية والعمارة وسوق ساروجة…
بالعودة إلى الآن، ما دام القصف الممنهج والعشوائي بهذا الدأب اليومي، فلن يستطيع الكاتب، التعرف على المكان إلا من الركام، هذا إذا أسعفه الحظ، ولم يُخل المكان حتى من بقاياه، فلا شيء سوى الفراغ. من محاسن الرواية والسينما، أن المكان على صفحاتهما يحافظ على معالمه، عمره لا محدود، هذا هو وإلى الأبد، لا مدينة تطوي مدينة، دمشق 2013 لا تطوي دمشق 1950 وإن كانت لا تستعيدها، إلا كتاريخ من المتغيرات والنوائب، زمن كان في سيرورته مثقلاً بالظلم والظلام.
ولنفكر، ثمة سوريا في الأفق، ترى ما الذي سيبقى من هذه التي نعرفها؟ لن ندري. أما إذا كان السؤال، ما الذي نريده أن يبقى منها؟ فهو البشر، لكي يتوقف القتل، بعدها فلنتساءل عن الدمار.