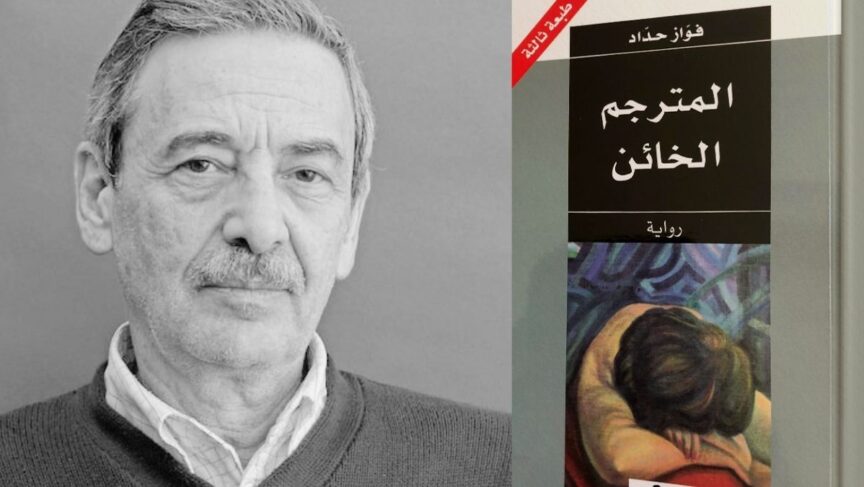شاعت في العقدين الماضيين في كتابات المثقفين ظاهرة التنظير والتعميم، بعد انتشار العمليات الجهادية التي وُسمت بـ”الانتحارية”، عُزيت إلى ما دعي بـ”ثقافة الموت”، وجرى دحضها بالاستناد إلى وجهات نظر وتقييمات سياسية عربية وغربية. إضافة إلى فتاوى من مشايخ مرموقين واكبها مصطلح مرادف كان نقيضاً لها، تبنى دعوة الإقبال على الحياة، نكاية بالجهاديين الانتحاريين الذين جعلوا من أجسادهم قنابل بشرية، فوصفوا بأنهم أناس يكرهون الحياة ويحبون الموت.
بصرف النظر عن القضايا التي يبذلون أرواحهم من أجلها، وبصرف النظر أيضاً عن هؤلاء الذين يستغلونهم لمآرب سياسية، غفلت هذه التنظيرات الداعية إلى الإقبال على لذائذ الحياة، عن عدم قدرة الانتحاريين على تحمل تكاليفها المادية الباهظة.
بلغت المخاوف من العمليات الانتحارية والعجز إزاءها، الظن أن هناك أناساً لديهم جينات مضادة للحياة. هذا التفسير وأشباهه، يبعد عن عدمية بدعة الانتحار، ما يرزح تحته البشر من الظلم والعسف والإذلال والإفقار والنهب المستوطن في منطقتنا، كأنه لا يمكن مقارعتها بوسائل ليست ناجعة، إلا بأن تكون يائسة، بتفخيخ الجسد وتفجيره.
ترتبط التضحية بالنفس بمسبباتها، هذا ما يسعى الغرب إلى تغييبه وردّه إلى دين ظلامي. ويسعى أيضاً حَمَلة دعوات الجهاد المميت، إلى تعويضه بالدين المستباح، ليكون حجة للمظلومين كي يحملوا راية يستظلون بها، ريثما يسعفهم الانتقال إلى العالم الآخر بالحياة العادلة والمتع الفاخرة.
ظاهرة طلب الموت لم تتراجع بقدر ما استفحلت وتوسعت، ففي العراق حافظت على وتيرتها. أما في سورية، فمنظمة القاعدة النشطة شهدت رواجاً قلّ نظيره، افتتحت الجهاد بفرعيها (النصرة وداعش) بعمليات انتحارية أثبتت وجودها على الأرض، وأسهمت بالمزيد من القتل والخراب، بعمليات كانت عبئاً فادحاً على السوريين، وجهت ضدهم، بهدف إيماني، أسلمة حتى من كان مسلماً، فكفرت كل من عارضها، ما جعلها على عداء مع الثورة.
نظرة إلى الواقع اليومي على الأرض السورية، بعد ما يزيد على سنتين ونصف السنة، ومقاربة عدد الضحايا المئة وخمسين ألفاً، وارتفاع أعداد المرشحين للفناء أكثر من المرشحين للبقاء. يبدو الشعب السوري، الذي يعيش في قلب الموت، يواجه مختلف صنوف الأسلحة بصدور عارية، وبطون خاوية، مقبلاً على أن يكون شعباً انتحارياً بحكم واقع الحال، ليس عن عقيدة، ولا لأن السوريين انتحاريون بطبيعتهم، بل رغماً عنهم، بدءاً بالذين ذهبوا إلى معسكرات الشظف والحر والبرد، وليس انتهاء بمن ركبوا البحر طلباً للجوء، لم يفلتهم الموت، ينقض عليهم، إما على الطريق، أو بعودة الأمراض المنقرضة، بعدما هجعت طويلاً، أو يلاقون حتفهم بفعل البرد أو الحرّ، ومؤخراً الغرق.
ترى ما المسافة التي تفصل السوريين عن الانتحار الإرادي الطوعي، أو الانتحار الذي يمارسونه يومياً، وهو انتحار تتحكم به المصادفة وحدها، إن لم تمت أنت، فجارك هو الميت. يُقتلون بالجملة رجالاً وشباناً، نساء وأطفالاً، ينتحرون لمجرد وجودهم في بيوتهم، أو رفضوا مغادرة أراضيهم، لا يجهلون الأخطار المحدقة بهم، طالما الصواريخ بعيدة المدى تقتلهم بحكم أنها مبرمجة. أما قذائف الهاوون العمياء، فتقتلهم بحكم أنها عشوائية. إن نجوا من هذه، فلن تخطئهم تلك.
ربما ليس هناك مأساة في هذا العقد توازي مأساة السوري، لم يعد الموت دفاعاً عن الكرامة، أو طلباً للحرية، بات لأن الأزمة السورية تُركت لجميع أنواع الانتهاكات الداخلية والتدخلات الخارجية. ولم يعد الحديث سوى عن أطراف دولية وإقليمية تتنازع سورية. أما المعاناة الإنسانية، فلا يبحث المجتمع الدولي عن حل لها. وكأنه من المتفق عليه إغراقها بالكلام ما يعوض عن القيام بفعل يحد منها، إن لم ينهها.
بالنظر إلى الموت اليومي الذي لم يتوقف، تنتفي الحياة أصلاً. ولا استغراب، ما دام الغرب يعتقد أن العيش الآمن الكريم نعمة لا يستأهلها العرب والمسلمون.
يفكر السوريون أنه إذا كان الغرب ضد الانتحار، فلماذا يهيئ لهم الموت؟
-
المصدر :
- المدن