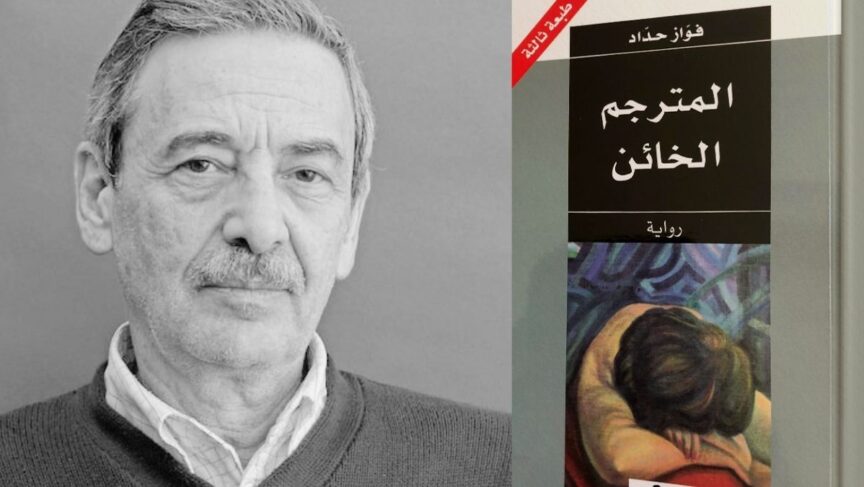يجترح الروائي مفهوماً مختلفاً للرواية، هكذا يظن، يستقيه من واقع تجربته، لا من كتابات النقاد، العمل النقدي أوسع وأشمل وافتراضي. تجربة الروائي أبعد ما تكون عن التنظير، إذ هي تعنيه وحده، ومن دون الخشية من ارتكاب أخطاء نقدية جسيمة، الإحساس بالجهل، لا يمنعه عن المضي قدماً نحو المجهول، وهو ما يحدث غالباً، هناك يجد بغيته. لا يعتدي على المناهج النقدية المعتمدة، بل يدعها للنقاد، وما محاولاته، في حال كانت مثيرة، سوى أنه يضع نفسه محل الناقد والمنقود في آن، وفي هذا ميزة يفتقد إليها بعض الروائيين.
الرواية بحكم طبيعتها تتخذ من المكان فضاء لها، تتطلبه حركة الأحداث، وتنقلات الشخصيات من غرفة النوم إلى المقهى، والتجوال في الشوارع… ليس بشكل اعتباطي، إذ لا يصح تواجدهم بلا مبرر في مكان دون آخر، كما أن جغرافية المكان، عدا عن دلالاتها، تقود أبطال الرواية إلى مصائرهم المحتومة، فتأخذهم إلى حيث النهاية، فتقودهم إلى جسر، أو سكة الحديد، أو إلى الطابق العاشر، أو مفترق طرق… ما يحيلنا إلى القول: المكان هو البطل. أما تحديد الزمن، أو تحرير الرواية منه، فلا ينفيه، بقدر ما يؤكد عليه في الحالين، فالتهرب منه، ما هو إلا صدى لفقدانه المزعوم.
يواجه الروائي عندما يتطرق إلى التاريخ، المسافة الزمنية التي تفصله عن الحدث، ما قد يضعه أمام مكان، اختفت معالمه، وتربعت أخرى، أولم يتبق منه ربما، إلا أطلاله الموحشة، أو أرض منبسطة خاوية على عروشها، تفتقد إلى عناصر مشهد كان يعرفه، وبات يجهله، كما يحدث الآن في دمشق، فهي لم تعد كما كانت لكثرة الحواجز والشبيحة، وأيضاً على المنوال نفسه، لكن على نحو مروع في المدن والبلدات الأخرى، حيث الدمار شامل. فإذا أراد الكاتب الكتابة عن حمص، عليه استعادة ملامحها من الذاكرة والصور.
تحيلنا متغيرات الربيع العربي المأساوية إلى ثورات مهدورة، ومشاهد خاوية، إلا من الحطام والركام وجثث القتلى والكلاب الشاردة. ما يضطر الروائي إلى العمل على روايته، كما لو أنه يعمل على رواية تاريخية، بمعنى إحياء المكان واستعادة الزمان.
يسارع بعض الكتاب اليوم إلى الكتابة عن حدث لم تنته فصوله على الأرض، وما بقي منه في علم الغيب، فلا الفرقاء يعرفون، ولا الذي يحركون الأزمة من بعيد يدركون إلى أين ستودي الأحداث بها، وإن كانوا يتحكمون بمفاصلها الكبرى، ولا ضمانة في بقائها حبيسة الحدود المرسومة لها، الواقع يختزن المفاجآت، وما يجري على الأرض يجري أغلبه في الخفاء، لا نعلم عنه سوى القليل. في التاريخ القريب أكثر من دليل، فالأمريكان لم يخططوا عند غزوهم العراق تسليمه لايران، ولا الثورة التي اندلعت في مصر، أن ينقض عليها العسكر، بعد انعطافات متوالية أودت بالثورة إلى الضياع، وأن يخونها رعاتها، وتلتبس بالأسلحة والخاكي، وأن تنحو الديمقراطية إلى الدكتاتورية. الثورات كلها، ذهبت إلى حيث لم يرد لها الذين أطلقوها؛ مساراتها أفرطت في التقلبات.
سدنة الرواية في حيرة من أمرهم، اذ لا يمكن تجاهل مثل هكذا حدث مصيري يشط ويمط، عالق على الأرض، بينما التاريخ ومعه الرواية يترقبان وجهته. لا يستطيع الكاتب إغفال ثورة اعتقد أنها ستغير وجه تاريخ المنطقة، ويفكر أنه بالخيال يدركها، لا يجوز تغييب الواقع لصالح التنبؤ، أو تعويض هذا بذاك. الواقع عقبة ليس لصلابته، بل لأنه موجود بقوة.
من المبكر الذهاب إلى الخيال، وتجاوز واقع غامض، الكتابة ضرورة لأنها الكاشف عنه، إذ هي أكثر من فعل كتابة، إنها فعل تبصر. وللخيال دور في رأب الصدع بين تلافيفه وسد ثغراته. الخيال الحقيقي هو الذي يقف فوق أرض راسخة تساعده على ترميم مشهد يخفي أكثر مما يفضح، ليس سواه مهيئاً وقادرا على عبور الهوة بينهما.
في الرواية سوف يعود الأدب إلى تعيين المكان وتحديد الزمان. إذ لا يمكن ابتكار مكان متخيل، ولا ابتداع زمان وهمي… طالما القتلى واقع حقيقي، هناك زمان عاشوا فيه، وأرض مشوا فوقها، وتراب دفنوا تحته.
-
المصدر :
- المدن