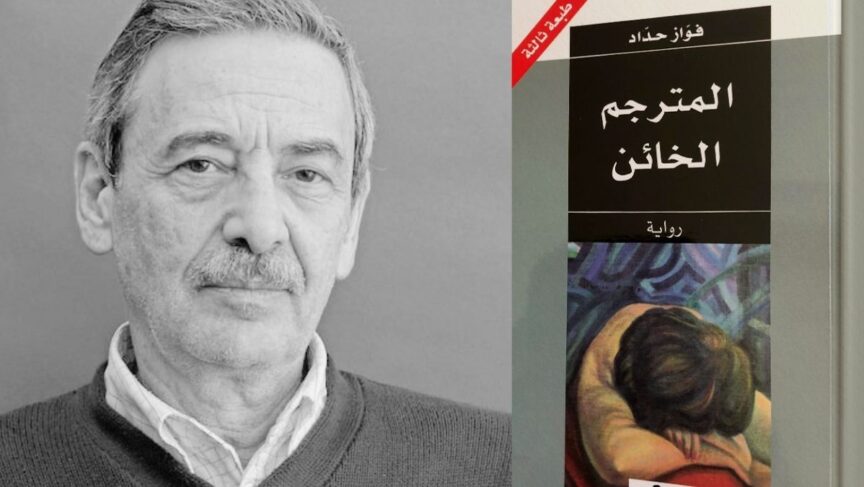احتلت الانتخابات السورية في لبنان حيزاً واسعاً من ساحة الكلام في الأسبوع الماضي، مع أن قلة من المتابعين أخذت الانتخابات على محمل الجد، غير أن تحشد اللاجئين أمام مقرّ السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم، فجّر الغضب اللبناني المختزن على السوريين، مع أنهم أعلنوا عنه بين فترة وأخرى، باتهامات طالت اللاجئين باللصوصية وأعمال العنف، وسرقة لقمة العيش من أفواه اللبنانيين… آخرها أنهم عطلوا حركة السير في بيروت، وأعاقوهم عن الوصول إلى أعمالهم.
أعادت الانتخابات مشكلة اللاجئين إلى الواجهة، وما يواجهونه من الشقيق المتعاطف معهم، ففي الداخل السوري يشارك حزب الله اللبناني في المقتلة السورية بكل حماس وإيمان واخلاص، كفعل مقاومة له الأولوية، فهو الطريق إلى القدس على حدّ قول بعضهم، والقول الآخر، حماية المقدّسات الشيعية، والقول الثالث، منع الإرهابيين من تهديد الاستقرار اللبناني.
في لبنان لا يخفي الكثيرون عداءهم لكل ما يمتّ لسورية بصلة، لذلك كان تعطيل السير فرصة سانحة ليس لصبّ جام غضبهم على اللاجئ السوري فقط، بل بما رافقه من شتائم عنصرية لسورية التي احتلت أراضيهم بمليون نازح، زاحموهم في أعمالهم، وحمّلوهم أعباء لا تطاق. مع العلم أن لبنان لا يدفع مساعدات، وإذا كان قدّم الأرض لإقامة المخيّمات، فمؤقتاً، الجغرافيا فرضته، كما فرضت الكثير من التداخلات غير المرغوب فيها من الطرفين. ولابد من القول إن مصائب السوريين طوال خمسين عاماً، انعكست على اللبنانيين بالخيّرات، فلبنان الحريات السياسية والاقتصادية، أعطى للسوريين مشكوراً منابر صحفية للتعبير عن آرائهم المقموعة في سورية، ومن السهل تفسير هذه الحرية، الأنظمة السورية المتعاقبة، لم توفّر لها أصدقاء دائمين. بينما عادت الحرية الاقتصادية، بالفائدة على التجارة اللبنانية، وكانت المتنفّس لسورية المختنقة بالإجراءات التقشفية للقوانين الاشتراكية، واستفادت المصارف اللبنانية، بالودائع المالية السورية، ومثلها استثمارات الأموال الهاربة من سورية. ولكي نغفر للأشقاء اللبنانيين، القدر الأكبر من عنصريتهم، نتفهّم أنها تعود إلى ما ارتكبه الجيش العقائدي خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، لكن عليهم أن يعرفوا أن الجيش العقائدي لم يكن يمثّل السوريين من قبل ولا من بعد.
بالعودة إلى الحشد الانتخابي، كان في جزء منه، يضم لاجئين سوريين من المخيمات، جاء بهم الخوف، وما أشيع بينهم، عن رفع قوائم بأسماء من لا ينتخبون، جاء بهم التعبير عن يأسهم. أما العراضات والسيل البشري المتدفّق على الطرقات، فلم يكن عفوياً ولا بريئاً، كان منظماً، المقصود منه المغالاة في التعبير عن ديمقراطية انسلّت بطرفة عين من تحت الركام والأنقاض، إذ كل شيء في سورية يجري كما تشتهي العصا السحرية للسلطة.
لكن، لنتأمل، هؤلاء الجالسين على الأرض، ومنهم من تربّع أو جثا على ركبتيه، مطأطئي الرؤوس بملابس مزرية، اصطفوا مثل الخراف، على وجوههم ملامح البؤس والهمّ والانكسار والمهانة، بعضهم تعرّض للضرب، لا يهم فهم قادمون من بلد، الضرب أقل ما اعتادوا عليه، ولم يعد يؤثر فيهم الموت، اعتادوه أيضاً. جاؤوا إلى لبنان ليلاً يحملون القليل من المتاع، ناجين بأرواحهم وأولادهم، بعد أن قتل منهم من قتل، واعتقل من اعتقل، منهم الجرحى والمشوّهون والمعاقون، يقفون في طوابير ليأخذوا حصصهم من الإعانات؛ طعامهم وطعام أولادهم… دونما بارقة أمل حتى الآن بالعودة إلى بلدانهم بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة السورية.
هذا المنظر، إن كان يكشف شيئاً، فخوف اللاجئ من حرمانه من بلده، وتوقه إلى العودة لقريته، بلدته، مدينته. كان له بيت، ولديه عائلة، ويعيش من كدّ ساعديه، وإذا كان قد انتفض، فقد انتفض لكرامته، ودفع الثمن كل ما يملكه. وتحمّل الغرامة الأكبر من جرائم النظام وغطرسته، وخطايا المعارضة وأخطائها، وعقابيل السلاح، ونكران الأشقاء، ولامبالاة العالم.
وإذا كنا نتمنى شيئاً، فألا تتفق كلمة اللبنانيين على المزيد من إذلال السوريين. إذ لا حال يدوم، يوماً ما، سيعود اللاجئون إلى بلدهم، هناك حيث كانوا يعيشون بكرامة، وبعرق جبينهم، ومن غير حاجة إلى كرم دول الجوار، ولا الأشقاء العرب، ولا دول الديمقراطيات العظيمة، ولا العالم أجمع.
فلندع شيئاً للتاريخ، نرجو أن يقتصر على هذه الصفحات السورية التي تكتب بالدم، ولا يُلحق بها بضع فقرات لبنانية يندى لها الجبين خجلاً.
-
المصدر :
- المدن