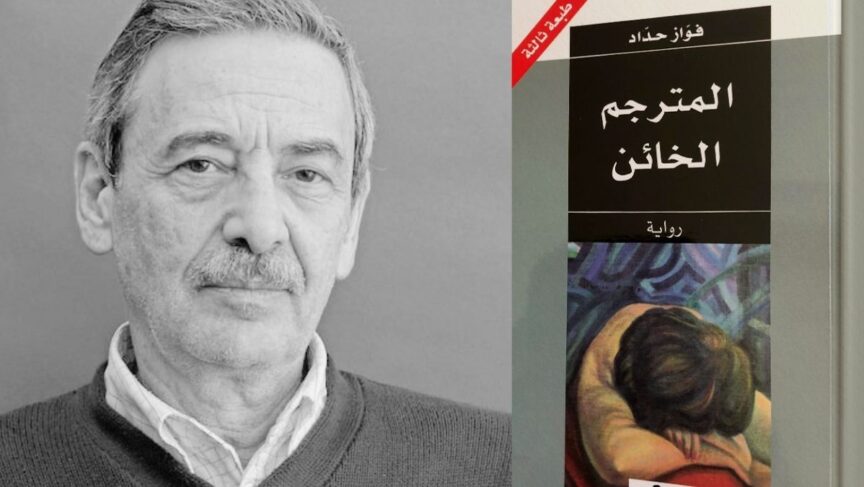في العقود الأخيرة، شارك العالم في مؤامرة الصمت التي أحاطت بتدهور الأوضاع في البلدان العربية من ناحية حقوق الانسان. تجلّى في عدم إثارة قضايا تعكّر صفاء علاقات الغرب مع بلدان لا شك في ديكتاتورية قادتها، بدلالة أحزابها القائدة، وأجهزة مخابراتها. وكان الرأي أنه من الممكن تأهيلها على المدى الطويل، إن لم يكن المتوسط، بإصلاحات متوافق عليها، بدلاً من زج البلاد في صراعات داخلية، قد تسهم في تقييد هذه الأنظمة الشمولية تمهيداً لزوالها، غير أن الحذر من أن تحدث الفوضى ارتداداً نحو ما هو أسوأ من الديكتاتورية، تحيلها إلى دولة فاشلة. لم يشجّع على هذا المسار. لذلك كانت نبرة الإصلاح والتحديث عالية، والتي لم تؤد بعد محاولات مخفقة، إلا إلى المزيد من انحدار الإنسان وحقوقه، فالإصلاح أخاف الديكتاتوريات واعتبر اختراقاً تآمرياً. لم تخطئ في هذا التوصيف، الإصلاحات ستقود حتماً إلى فتح ثغرات في القبضة الحديدية للتسلط، ما يجعلها مع الزمن قابلة للاهتراء، وإن كان هذا من قبيل الأحلام لا المخاوف. إذ ما زالت السلطات الغاشمة تحظى بقوة لا يمكن لها أن تهتز إلا بفعل خطر حقيقي، كما لا يمكن للسلطة، ولو بالتدريج، أن تسلم مقاديرها لخصمها وهو الشعب، ألا إذا كانت تعاني من اللاوعي، مضافاً إليه اللامبالاة المطلقة بيوم الحساب.
ما وُصِف بالربيع العربي، وهو ربيع بحق، هدفه إسقاط أنظمة قمعية. أغلق الرؤية على المسار المبتذل تفاؤله، وأطلق دينامية أخرى، تسارعت على وقع التساقط السريع للأنظمة، أحياناً بمساعدات وتدخلات غربية ملموسة، بحيث بدا الربيع صالحاً ليكون نمطاً للتغيير في العالم، طالما أنه استطاع تقويض ديكتاتوريات راسخة لا تقبل حتى بأكذوبة الإصلاح على المدى الطويل. نجم عنه شعور شعبي عام، غالى في قدرته على إحداث تغييرات جذرية، بالتعسكر في الساحات لمدة مفتوحة، وتعطيل حركة السير والبلد، إن لم تلب مطاليبه، وعلى هذا لم تقف مطالباته عند حد، ما هدّد الاستقرار المزعوم حتى في بلدان الديمقراطيات العظيمة، فما بالنا بالديمقراطيات الزائفة.
في الفترة نفسها، كانت عودة الحرب على الإرهاب، بدعوى ضبط الاتجاهات المتأسلمة عن الانزلاق إلى الراديكالية الأصولية. وكانت بتشجيع من الديكتاتوريات، وتساهل من الديموقراطيات التي سمحت لرعاياها المنجذبين للجهاد بالذهاب إلى أرض الجهاد، بغية التخلص منهم، وإسهاماً منها في خلق حالات نموذجية لعودة الإرهاب، تمهيداً لتحويل الربيع العربي إلى أزمات داخلية، ولو كان فيها عودة السلطة القديمة، لإنضاج تناحرات قديمة بلبوس جديد، وكلها تأخذ براءتها من شعار مكافحة الإرهاب.
وكأن مخاوف الدول من الإرهاب، ولّد إرهاباً حقيقياً. المستغرب أن هذا الإرهاب المطارد في كل مكان، استعاد لياقته وانطلق قوياً متكاملاً، نشطاً وفعالاً، تمظهر بإمارات مقاتلة في العراق وسوريا، وامتلك من السلاح ما عجز عن توفيره أصدقاء سوريا، مع سيل من الانتحاريين لا يكفّون عن طلب الموت. هذا في توقيت غريب جاء مع انحسار التدخل الأمريكي السافر، في وقت باتت الحاجة ماسّة إلى دولة قائدة وراشدة، توفر على العالم مسلسل الإرهاب الذي بدأ، وبدا في المستقبل القريب أنه لن يكتفي بحاضنته. لكن الخطر الذي أصبح على الأبواب، ذهب إلى مماحكات دبلوماسية في كواليس الأمم المتحدة، وغدا عرضة للنزاعات العالمية والإقليمية.
يثبت هذا التكتيك من التراجعات، أن النزوع نحو التسلّط والسيطرة هو العنوان الخفي والمعلن لأي نزاع. وأن استثمار الإرهاب يخضع لهذا المنطق لا غيره. العالم نفسه الذي كان ينتقد أمريكا على زجّ أنفها في شؤون الدول الصغيرة، وتحويل رؤساء دول إلى عملاء، وإعداد المؤامرات والإشراف على الانقلابات، عاد يطالب باستعادتها لأدوارها العتيدة، والتي لم تكن في حالة انقشاع نهائية، وإنما إلى استبدال، فإيجاد حلّ للأزمات خضع للسرية المطلقة حتى أصبح لغزاً، فلم نشهد تقدّماً نحو الحلحلة بقدر ما شهدنا اتجاهاً نحو التعقيد، فالدول التي كانت كبرى، والراغبة في استعادة أدوار مضت، ذهبت في استثمار الإرهاب إلى حد صعدت فيه على أشلاء الدول، أما الدول التي ما زالت كبرى، فهي تستثمر بارتياح، وعلى المدى الأطول، أوراقاً تثبت أن تظاهرات الربيع الأخضر تأتي بالإرهاب الأسود.
-
المصدر :
- المدن