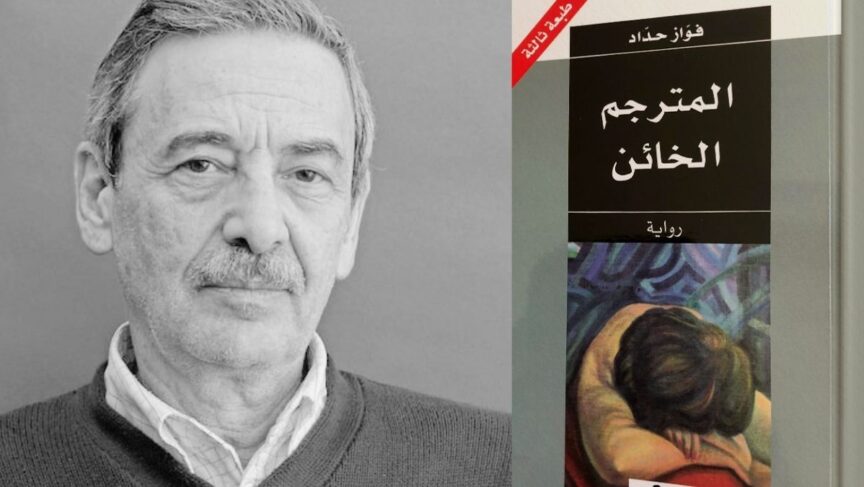عندما عمت المظاهرات البلاد، وبدأ النظام يبحث عن حل، حدد السوريون احتمالين: الأول استحالة سقوط النظام. الثاني آن له أن يرحل، فقد انتهى عمره، ما هو إلا واحد من سلسلة أنظمة تتهاوى في المنطقة. كان المناخ في الشارع العربي مواتياً لهذا التفاؤل. حيرة النظام لم تطل، استعاد أسلوبه الناجع الذي استعمله في حماه قبل ثلاثين عاماً.
جرى تعميم الحل الأمني في أرجاء سورية، الرصاص ينهال على المحتجين، الشهداء يتساقطون دون حساب، المظاهرات لا تنفرط إلا لتتجدد. لكن والإصرار يزداد على عدم التراجع، تعزز الاعتقاد بأن النظام أخطأ حساباته، وتورط بمأزق لن ينجو منه، مهما طال الزمن، وللخلاص السريع منه وتقليل الخسائر، لا بأس بالاستعانة عليه بانقلاب يطيح به. بدا وارداً بسبب تعثر الأطراف. ظل هذا الاعتقاد سارياً حتى بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة، فهي لم تخمد، ولا سقط النظام.
لم يكن غريبا ان تخامر السوريين فكرة الانقلاب لتحريك هذا الاستعصاء. ترددت الفكرة نفسها في كواليس السياسات الدولية، بعدما تلاشت القناعة ببقاء النظام، ولاقت التأييد من دول عربية وغربية، وأصبح هناك ما يدعى بأصدقاء سورية. سربت وكالات مخابرات غربية توقعات عن قيام انقلاب قريب، وأحيانا وشيك. فقد كان الانقلاب لعبة الأمريكان المفضلة في تغيير أنظمة الحكم. في حين كان الواقع السياسي يشير إلى أن الحديث عن الانقلاب شيء يماثل الوهم، فالحلقات الداخلية للنظام آخذة بالتماسك، والدعم الإيراني الروسي لا يتوقف، والجيش يشن هجوماً معاكساً على جميع الجبهات. وتشدد في احتياطاته حتى قيل إنه استبق أي تحرك من هذا النوع بتفجير خلية الأزمة، التي ضمت ضباطاً في الجيش والمخابرات على مستوى رفيع يؤهلهم للقيام بانقلاب سيحظى بتأييد داخلي وخارجي.
تعود فكرة التغيير هذه إلى ثقافة “الانقلاب” التي تشبع بها السوريون رغم مضي أربعين عاماً على آخر واحد منها. وإذا كان قد راودهم خلال الأزمة، فلأنها تربض في الوعي واللاوعي السوري، كأيقونة مثالية في التغيير، سريعة وغير مكلفة، خبرة تناقلها الأولاد عن الآباء عن الأجداد، يرتاحون إليه، فقد كانت الانقلابات السورية بيضاء، لا تتعطل الأعمال أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة، أشبه بإجازة، يستمعون إلى البلاغات المتلاحقة، ويتناقلون الاشاعات حول من وراءه، واسماء الضباط المشاركين فيه، لا يزعجهم تبادل اطلاق النار لو حصل وهو نادر، يسقط بضعة ضحايا خطأ أو مصادفة، لا مقاومة جدية ، بضع محاكمات أشبه بأنها صورية، لم يكن الانقلاب يزيد عن تسليم وتسلم يتم مع بعض الضجيج وبرقيات التأييد تصاحبها الأغاني الحماسية. لذلك كان الاقبال عليه بلا عوائق كبيرة، فلا قصف ولا تدمير ولا اعدامات ميدانية… عدا محاولة 18 تموز 1963 وكانت كميناً بالفعل أعده البعثيون للناصرين، أعقبه اعدامات، بعدها حصل الطلاق البائن بين البعثيين والناصريين. ساءت سمعة الانقلاب بعد هذه العملية، لكنه لم يردع الضباط عن تجربة حظوظهم، التي باتت خلافات داخلية بين رفاق الدرب، وكان الدرب هو النضال في سبيل الاستيلاء على السلطة. الرئيس حافظ الأسد تشاءم من انقلابه الذي أزمع على تنفيذه، خشي أن يعقبه انقلاب، فأسمى مغامرته الانقلابية “الحركة التصحيحية”، وكانت انقلاباً لا يخلو من شبهة تصحيح، وإن لم تصحح شيئاً، مع الوقت أحدثت تغييراً شاملاً وجذرياً. وبذلك ذهب الانقلاب في غمار التاريخ، كأنما لا رجعة له، لكنه كتذكار منح السوريين بعض الأمل، إذ لم تكن هناك وسيلة أخرى للتعاقب على الحكم، غير أن النظام اغلقها في وجوههم، فالجيش الانقلابي المعول عليه أصبح جيشاً عقائدياً مهمته بعد حربين حماية النظام، وأجهزة المخابرات التي تعددت وتشعبت غطت البلاد كلها، مهمتها الأولى رصد أي معارضة أو كلام ولو كان غير مقصود، ما اضطر الناس إلى التكلم همساً، لكن التقارير الكيدية لم ترحمهم.
في آذار 2011 فوجئ السوريون عندما وجدوا أنفسهم في الشوارع يهتفون ضد النظام، وذهب بهم الظن البريء انه سينهار تحت تأثير الهبة الشعبية لاسيما والهتافات كانت تضامنية “واحد واحد، الشعب السوري واحد”. كانوا على يقين أن ثورتهم الشعبية تختلف عن الانقلاب، وأن سر صمودها واستمراريتها يكمن في هذه الميزة، ثم أدركوا أن هذا سبب ضعفها، الذي آل بها الى التشرذم، لذلك لم يكن إعادة التفكير بالانقلاب إلا لأنه كان ينهي الأوضاع القائمة بالبلاغ السحري رقم 1.
-
المصدر :
- المدن