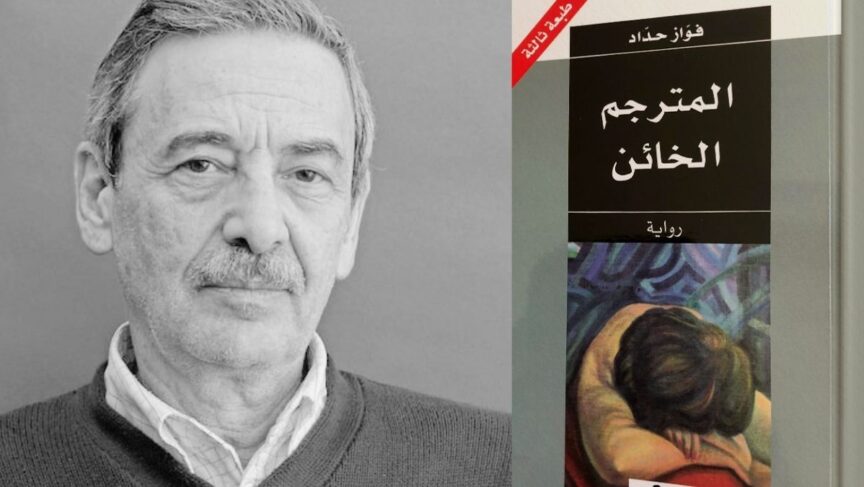في كل يوم هناك فرصة لإنقاذ سورية، لكن في كل يوم أيضاَ هناك أكثر من فرصة لإغراقها في الدمار والفوضى، وهي فرص تستثمر على أسوأ وجه. وحتى يستقر العالم على ما الذي يريده من سورية والسوريين، فالمأساة ستكبر وتتدحرج إلى أبعد من دول الجوار. يدرك العالم أن مصير سورية خرج من أيدي السوريين، ومن أيدي العرب، وهي في طريقها إلى الخروج من أيدي الإيرانيين والروس، فساحات الحرب الداخلية بات من الصعب السيطرة عليها، إلا بالإبادة الكاملة، وهو اجراء لا يعني في المراحل القادمة سوى إبادة الركام والعظام، وما تبقى من الأحياء. هناك مناطق من سورية باتت خالية من الحياة، فالنظام بذل أقصى جهده وأسلحته في القضاء بالتهديم والحرق على ما يدعوه “بيئات حاضنة”. في الحقيقة حتى النظام لا ينعم بالاطمئنان في رقعته الآمنة، فهو مهما طال الزمن، فالزمن الآمن لا محالة إلى انقضاء، وسوف يضطر إلى الانتقال مع بطانته المقربة إليه المطلوبة من المحاكم الدولية إلى بلد يقع خارج هذا الخراب، إن لم تكن روسيا فإحدى بلدان الاشتراكيات السابقة، لا تشملها قوانين العدالة الدولية التي لا تعمل إلا في حال نجاة المجرمين.
تقدم سورية أنموذجاً لأكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث، هذا حسب المراقبين والمحللين الغربيين مع اعترافهم أن الغرب هو أحد المسؤولين عنها، بحكم تخليهم عن هذا البلد الذي قدم ثورة مدنية سلمية، كان الأمل أن تحصد نتائج طيبة تعوض هذا الشعب عن أربعين سنة من القمع، وعلى أن يتلقى مساعدة الدول الغربية الديمقراطية، التي كانت على علم بما آلت إليه أحوال سورية من فساد ونهب وافتقاد لحقوق الانسان. لكن للسياسات الانتهازية والاستراتيجيات الصماء والقنوات الخلفية حساباتها، فتركتها لمصير بات كارثة مستديمة.
الكارثة السورية تتقادم من يوم لآخر، ولا انخفاض لمنسوب القتل والنزوح والعوز وتفاقم الجوع، اعتاد عليها الرأي العام، ولم تعد تثير الاستنكار ولا التحفظ، خاصة بعدما ضرب الإرهاب المتأسلم ضربته في هذا الفراغ الميداني، وغدا المؤهل الوحيد لإنقاذها، وإن كان بطرائقه الدموية. بات اهتمام الغرب هو القضاء على المنقذ الأصولي، لئلا تصبح سورية ساحة تدريب وتمارين على العمليات الإرهابية التي أحرزت نجاحاً مروعاً بأساليب “داعش” الوحشية، فماثل وحشية النظام، وإن لم يتفوق عليها، وكان لتأثير دعاية “داعش” أن كسبت سباق الأكثر اجراماً. على أن التنافس الذي بدأ بينهما ما زال قائماً، “داعش” في العلن، كذلك النظام في العلن، لكن مبرراً في القضاء على الإرهاب. على أنه لا فارق بينهما، كلاهما يصيبان المدنيين والمناضلين السلميين والمدافعين عن أنفسهم وعائلاتهم وأرضهم.
لا يعني الغرب من هذه المقتلة سوى الأقليات، وجد كالمعتاد حجة يطلق بموجبها تصريحاته الانسانية. حماية الأقليات!! لكن ماذا عن الأكثرية؟ “داعش” مثلاً لم توفر الأكثرية، وقبلها النظام، نالها منهما النصيب الأكبر وبما لا يقاس من اجراءاتهما الوحشية.
اعتمدنا في المقال الأكثرية والأقليات كما اتفق عليها الغرب والنظام والمتطرفون الاسلاميون، فما تعارفوا عليه بشأنها متطابق حتى العظم، ولا خلاف بينهم. فالنظر واحد، وما يثمر منه يشمل فوائده مصالح الجميع. هذا لئلا يظن الطائفيون المتنكرون بالمعارضة الإنسانية أننا نتبنى هذه المصطلحات التي لا فائدة منها إلا في تمزيق السوريين وتحويلهم إلى إخوة أعداء. بالمناسبة هكذا تبدو على الأرض، فالأرض لا تخدع احداً، لا حماية للأقليات، وقصف الأكثرية لا يردعه رادع. أما الطائفيون فيتشدقون ويخدعون أتباعهم.
الجلي، بعيداً عن المصطلحات التي لا تبدل شيئاً، الا في المماحكات اللامجدية، كلاهما الأكثرية والأقليات يعانون من أوضاع غير إنسانية، ويعيشون تحت رحمة حرب عمياء لا تفرق بينهم، قامت دفاعاً عن الاستبداد، ويستثمرها الإرهاب.
-
المصدر :
- المدن