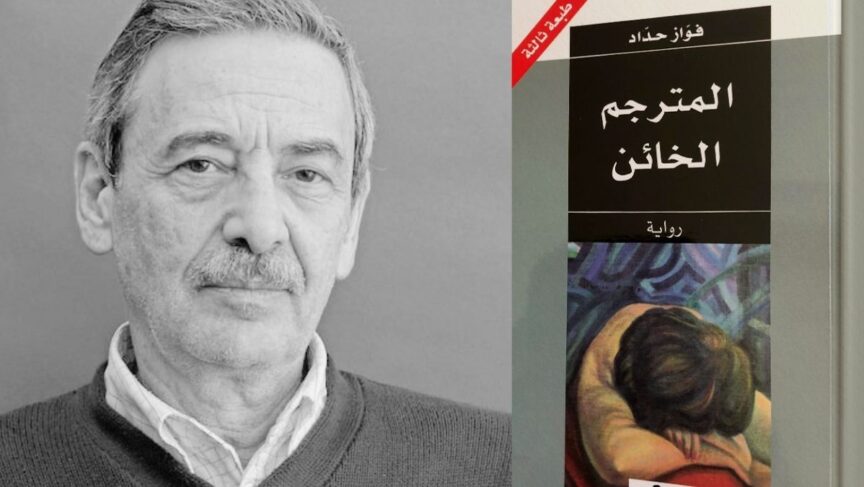أخيراً، أو أننا لم نعلم إلا مؤخراً، أصبح حقيقة تجنيد أولاد لا تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاماً، للقتال على الجبهات الساخنة، ففي فيديو التقط مؤخراً قبض الجيش الحر في الجنوب بمنطقة اللجاة على أولاد جندهم النظام عنوة، وزجهم في معارك درعا، بعد تدريب سريع. اعترف الأولاد عن مسلحين كانوا يمشون وراءهم، لإطلاق النار عليهم لو حاولوا الهرب. قبل ذلك، عرض التلفزيون المحلي السوري فيلماً قصيراً استحوذ على الاهتمام، أوحى بأن الحرب نشاط طبيعي تساهم فيه فتيات بعمر الزهور، ملامحهن بريئة، رغم أنه شابها قدر من التحدي، فقد كانت أصابعهن على الزناد. كما منذ فترة من الزمن اخترع النظام تشكيلات نسائية مقاتلة من المغاوير والفدائيات، ليعقبه اختراعه التالي فتيات صغيرات في السن، يحملن القناصات، وأخريات يستخدمن المدافع والدبابات في أحياء جوبر وداريا بدمشق. إحداهن قنصت في يوم واحد احدى عشر إرهابيا، الثانية دمرت بيتاً فوق ساكنيه. إن لم يكن هذا من قبيل المبالغات، فالفتاة القناصة مارست رياضتها في شارع الصالحية المزدحم، لا في الأحياء المهدمة التي لا تلمح فيها أحداً يمشي، لا سيما ممن يدعون بالإرهابيين.
ليس مستغرباً التساؤل، هل هذا حقيقة، أم أنها احدى تمثيليات النظام لرفع معنويات جنوده، تذهب إلى أن شجاعة الفتيات لا تقل عن شجاعة الجنود من الرجال مفتولي العضلات والمزنرين بالرصاص والقنابل، فالأمة تستنفر طاقاتها كلها، وكما صرح أحد مسؤولي النظام، يثبت أن المرأة السورية قادرة على النجاح في جميع الميادين. ما يشكل استدراجاً لفتيات طالبات مدارس للتطوع في مهنة القنص، تظهر فيها ممارسة الفتيات للقتل على أنه تسلية لاصطياد رؤوس الإرهابيين بالجملة، من دون أن تمنعهن عن طلاء أظافرهن وشفاههن بالأحمر. كما أنها رسالة إلى الخارج، فالإيحاء بالعلمانية المقاتلة من خلال الأنثى غير المحجبة ولا المبرقعة، التي تحارب الإرهاب الاسلامي، ما يقنع الغرب بعدالة قضية النظام.
لم يلجأ النظام إلى تجنيد الفتيات والأولاد إلا بعد النقص الخطير في تعداد جنوده المقاتلين، والحاجة لإرسال جنود المدن الى الخطوط الأولى، ووضع فتيات عوضاً عنهم على الحواجز، فكانت الدعاية حول شجاعتهن تشير إلى كفاءتهن القتالية التي تتعدى التفتيش إلى القتل بدم بارد. السبب معروف، فالحرب تتعثر على الجبهات التي كان النظام مسيطراً عليها، ما أحبط الإيرانيين، الداعم والممول الأكبر للنظام، خاصة بعد توالي خسائر جيش النظام وشبيحته في ادلب وجسر الشغور، فالمعركة معركة إيران أيضاً. ما أوجب العمل من قبل على إرسال المزيد من الخبراء لتسيير المعارك في جبهات القلمون ودرعا وحلب، والمزيد من الدولارات لا يقاف تدهور الليرة السورية. كان هذا في وقت كانت فيه إيران تعد لاستراتيجية انسحاب طويلة، بعد نجاحاتها في العام الماضي، إذا بها تجد نفسها متورطة أكثر في سورية، الخروج يعني خسارة ما حاولت استثماره طوال السنوات الأربع الماضية.
خطة النظام منذ الأيام الأولى كانت سحق الاحتجاجات بقوة كبيرة، منعاً لامتدادها، ولكي لا تقوم لها قائمة. ولقد تمكن النظام من توريط جميع من يؤيدونه بالصراع، مثل إيران وروسيا، وبدورهم ورطوا النظام باستعمال الوسائل كافة للقضاء على الثورة. ولقد تطلب الحل الأمني فالعسكري زج قوى الجيش، بالتوازي مع التخويف من الخطر السني الوهابي، إضافة إلى المؤامرة الكونية المحدقة بالبلد، بحيث بدا النظام أشبه برامبو وهو يقاتل على كافة الجبهات ويحرز انتصاراته على الإرهابيين من الميليشيات الإسلامية، من دون أن يفلح في تجنيد الشبان الذين سارعوا إلى الفرار من سورية، سواء كانوا من أبناء الموالين المقربين إليه، أو المعارضين المطاردين… بينما أفلح في تطويع الشبان العاطلين عن العمل في تنظيمات تعتبر تنويعا على الشبيحة سيئ الصيت.
تبدو المعارك بلا نهاية منظورة حتى الآن، الفتيات والأولاد لن ينقذوا النظام من الانهيار، ومثلهما إيران وروسيا. لو أن النظام يفكر ولو مرة واحدة بشكل صحيح، لوفر هذا العذاب الذي بات يعادل عذابات حرب عالمية ضروس قتلت وهجرت ووزعت أجساد السوريين على ارجاء الأرض وفي البحر، وحولت سورية إلى مجتمعات وبؤر مسلحة حتى العظم. هذه الحرب، حتى المنتصر فيها خاسر ايضاً، لأنه سيتسلم بلدا مدمراً ومنهوباً، مفتتاً ومنكوباً. ترى هل يستطيع النظام التفكير في تدارك الكارثة الكبرى، بكارثة أقل حجماً؟
-
المصدر :
- المدن