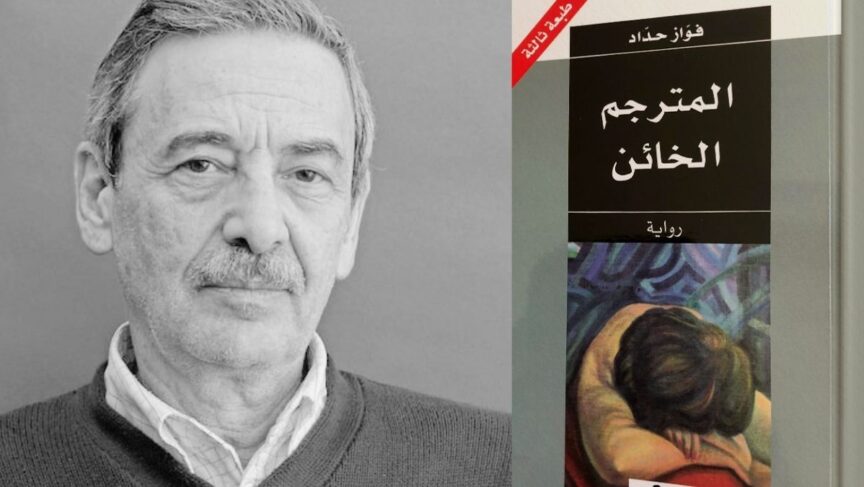في منتصف القرن الماضي، كان الشعر الجنس الأدبي الأكثر لهاثاً وراء التجديد، يتقصّاه في الشعر الإنجليزي والفرنسي، فاحتل إليوت ورامبو، وإلى حد أقل إيلوار وبريفير، مكانة متميزة لدى الشعراء والنقاد العرب. طبعاً، من الصعب تعداد الشعراء الأوروبيين، وإلى حد ما الروس، مثل ماياكوفسكي ويسنين، عدا الهيبيين الأميركيين، الذين أصبحت قصائدهم مراجع وأيقونات، يحال إليها. تضاءل هذا التعلق، وإن استمر مع بيرس وريتسوس وغيرهم حتى نهاية القرن. كان هذا الوضع مديناً للترجمة، وللنقاد الذين أسهبوا في تقدير الشعر الوارد إلى العرب، مع أنهم كانوا الأكثر شهرة في هذا المضمار، قبل أن يتراجعوا، أكثر من مرة، من عصر انحطاط إلى آخر، لاستنساخهم الشعر العالمي، والمرض معروف: الوصول إلى العالمية. وحتى نشفى منه، لابد أن يعيد الشعراء العرب النظر إلى أنفسهم، قبل النظر في الشعر، وسوف يكتبون شيئاً جديراً بالوقوف جنباً إلى جنب مع أمثالهم من كبار شعراء العالم.
الرواية أمرها مختلف، ليس للعرب تاريخ، ولا تجربة فيها، إلا إذا اعتبرنا ألف ليلة وليلة، روايتنا الكبرى على مر الأزمان، تمنحنا شهرة، تبيح إخفاء عجزنا وراءها. لكن الليالي، على الرغم من أنها اخترقت العصور، ولم تبق أَسيرة زمانها، مختلف حول أصلها، وإن كانت أحداثها تجري في بغداد وبقاع متخيلة، وجزر أسطورية. لكنها، بالمقارنة مع الفن الروائي الذي أصبحت معالمه واضحة، وبصرف النظر عن الروايات الإغريقية، تفتقد إلى عناصر الرواية، كما اتفق عليها، وإن كانت لشهرزاد مكانتها الخاصة التي لا تمس، وتبقى تمارس تأثيراتها على كل من أحب الأدب، وذهب به الخيال، ومن ثم العزم إلى كتابة روايةٍ متخففةٍ من القواعد الصارمة.
التجربة الروائية بدأت في القرن السادس عشر، وقدمت أمثلتها الأبرز، والناضجة مع سرفانتس وفيلدينغ وريتشاردسون وجين أوستن. بينما تأخرت الرواية العربية إلى القرن الماضي، وشهدت عدة بدايات متعثرة، ريثما استوى عودها، وأنتجت محاولاتٍ عربيةً جريئةً ومتقدمة، إحداها نجيب محفوظ الذي ابتلي بجائزة نوبل، فابتلي الروائيون بالعالمية، اعتقدوا أن الجوائز هي الطريق المعبدة إليها، لكن، في الكتابة حسب الوصفة الغربية، والتي عموماً لا تزيد عن تقليعاتٍ، تختلف من وقت إلى آخر. جاء اللهاث وراءها في زمن محموم، كان رد فعل على الأيديولوجيات الشمولية التي كانت نبراساً للأدب، وهادياً للرواية في ملحمة الإبداع، كما كانت الطليعة آنئذ تتصور معركتها في الأدب والحياة، فوضعتها الرواية القادمة من وراء البحار أمام خيارات مثيرة.
وجد الروائيون أنفسهم في معرض الانتقاء، فالواقعية السحرية جاذبيتها لا تخفى، والتسيب الفوضوي ألقه لا ينضب، والبوهيمية تليق ببقايا الكتاب المناضلين، أما الجنس فلا تموت إثارته، خصوصاً وقد تفتقت عنه المثلية في بدايات الألفية الثالثة… ونشأ جيل من الكتاب كانوا من الطموح، بحيث نبذوا الواقعية، ولم يغفلوا وهج الأنواع السالفة، فكان القالب واقعياً سحرياً، مع فوضويةٍ معطوفةٍ على بوهيميةٍ، لا تغيب عنها غرائب الجنس؛ خلطة موفقة للدخول إلى العالمية. وربما كنا نذيع سراً في أن الغرب يعاني من عقد جنسيةٍ مستفحلة، نحن الذين نظنه بريئاً منها.
بعد تصدّع الدولة الشمولية، وتهاوي أوهام كثيرةٍ بشأن الدولة الاستبدادية، والرؤساء التاريخيين، فوجئ الروائيون بأن الرواية مدعوة إلى تأمل هذا المنعطف، وهم مدعوون، أيضاً، إلى التحرر من أثقال الماضي، لا تقليد الغرب توخياً للعالمية. الرواية هي أن نكون نحن.
استحوذت الروايات اليابانية وروايات أميركا اللاتينية على إعجاب العالم، لأنها كُتبت عن الناس في بلدانهم. وبشكل بسيط، يمكن القول إن للعرب قصتهم الخاصة، الرائعة والمؤسفة، مع أزمنةٍ تفاوتت فيها تحولاتهم وتجاربهم ومآسيهم. واليوم أمامهم مستقبل لا يصنعه غيرهم، الروايات جزء منه، كوسيلة لاكتشاف الذات والآخر والعالم. لو أننا ندرك أن رواياتنا لن يكتبها أحد غيرنا. لوفرنا على أنفسنا أوهاماً كثيرة، على رأسها العالمية، إذ من خصالها أن العالم لا يمنحها، بقدر ما يعترف بها.
-
المصدر :
- العربي الجديد