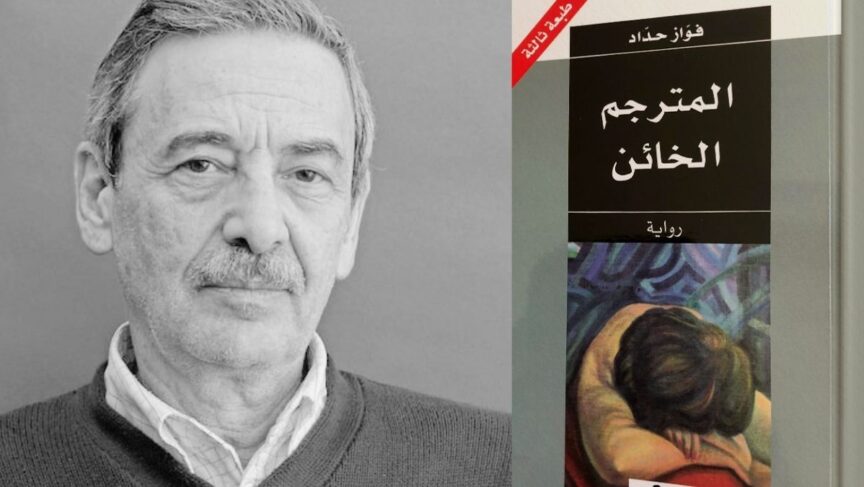على الرغم من تراجع القراءة، وتصاعد الانكباب على صفحات التواصل الاجتماعي، تشهد الرواية انتشاراً مرموقاً، ما يوجب القول إنها نجت من مصير مشؤوم، نتيجة عوامل كثيرة، لا تدين للوقت الحاضر، بل لما تراكم من جهود روائية طوال العقود الماضية.
يجعلنا هذا ألّا ننسى إسهامات روائيين عرب في ازدهار الرواية في الستينيات والسبعينيات، أمثال نجيب محفوظ ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس في مصر، وحنا مينة في سورية، أشاعوا الرواية بين قراء لم تثقل عليهم مطالعة ثلاثية محفوظ الضخمة، ولا روايات عبد القدوس والسباعي الطويلة. كذلك انتشار روايات حنا مينة في البلاد العربية من المحيط إلى الخليج (وهو تعبير في محله) حتى أصبحت ظاهرة شبابية لافتة كروايات تقدمية منحازة إلى العدالة والفقراء.
صار للرواية جمهور ومتابعون أوفياء. قبل سنوات كانت المفاجأة؛ ظهور روائيين بالمئات، والمنتظر أن يصبحوا بالآلاف. شعبية الرواية في ازدياد، ونجت من مصير طاول الشعر، فمنذ عقود استنكفت دور النشر عن طباعته إلا بكميات محدودة جداً، لم تتخل عنه نهائياً حفاظاً على تقاليد تراثية أدبية تربع فيها الشعر العربي على محراب الخلود. لم يختف الشعر من حياتنا، لكن انفض عنه الكثير من عشاقه، إذ لا عشق من دون تواصل مع المعشوق.
” الشعر مادة تخرج من الروح والجوائز أصلح ما تكون لتخريبه وتخريبها”
إذا استثنينا مشاهير الشعراء كنزار قباني ومحمود درويش وأدونيس. نجد أن حصة الشعر هزيلة جداً بالمقارنة مع الرواية، فما بالنا بكتب الدين والحظ والطبخ والجنس؟ وكأنه لا مكان للشعراء الجدد في عالم القراءة.
في الحقيقة، لولا أن الشعراء يقرؤون للشعراء، لما حظينا بقراء مثابرين، فالشعراء الذين اختاروا الشعر سبيلاً في الحياة أصبحوا دائرة مغلقة على كتابها. وما يطفح اليوم على السطح شعر هواة طالما هناك جوائز تشجع على كتابته، بينما هي تسيء إليه، فالشعر مادة تخرج من الروح، والجوائز أصلح ما تكون لتخريبها وتخريبه.
ما يعود بنا إلى الطفرة الروائية التي ساعدت عليها الجوائز، وهي جوائز بلا معايير، وضعت للتشجيع على كتابتها، ما حوّلها إلى فريسة ثمينة، لا عجب أنها خدعت الكثيرين، ثم ذهبت للمحظوظين.
والأسوأ أنها استسهلت مقاييس للرواية حطت من شأنها، ما يجعلنا نتوقع لها مصيراً مشابهاً، فتذهب الروايات الحقيقية إلى دائرة الرواية المطرودة من جنة الجوائز، المخالفة للمقاييس العشوائية، فلا يقرؤها إلا الروائيون، فتلتحق بالشعر، ويصبح حالهما كحال الفلسفة التي سبقتهما، واقتصرت على الفلاسفة وطلاب الفلسفة، لولا أنها نزلت من عليائها إلى الأرض والحياة اليومية، وأصبح لها موعد مع الناس، من دون الاستغناء عن احتكار أسئلة الفلسفة الكبرى، لدائرتها الأولى.
هل العمل على ترويج الكتاب، سيحيل عالم الكتابة والقراءة بأنواعهما إلى دوائر من الخاصة، مغلقة على أعضائها تسن قوانينها الصارمة، ودوائر مفتوحة للعموم متساهلة، تتحكم بها قوانين السوق؟
-
المصدر :
- العربي الجديد