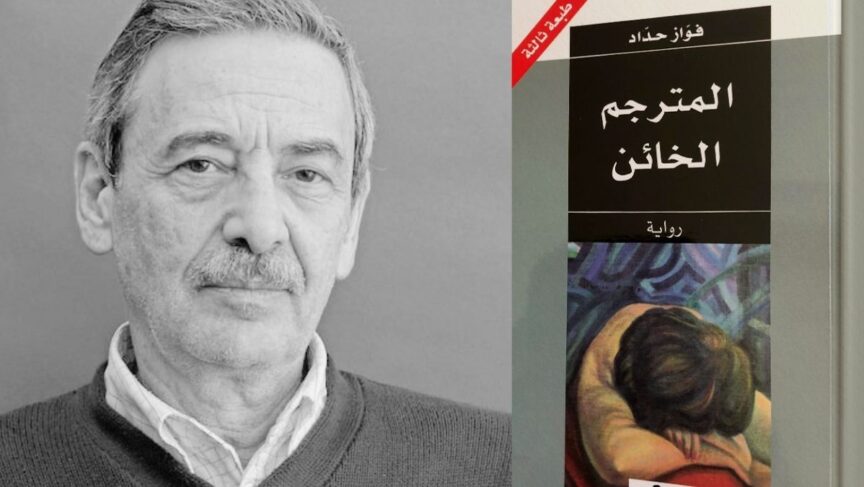هل يؤدي تقدّم الصناعات والعلوم والفنون في عصرنا إلى تهذيب الأخلاق أم إفسادها؟ هذا السؤال كان موضوع مسابقة في عام 1750 طرحته أكاديمية “ديجون” في فرنسا.
أجاب عن هذا السؤال جان جاك روسو. ربح المسابقة واكتشف في داخله فيلسوفاً أو مصلحاً اجتماعياً، وربما عبقرياً. انطلقت موهبته بعدها وتتالت كتبه. لم تتوقّف شهرته عن الانتشار بعد موته حتى أنه اعتبر معبود الثورة الفرنسية، وفي زماننا هذا ما زالت مقولاته تتداول محتفظة بطزاجتها.
غرّد روسو خارج عصره، عصر العقل، لم يكن ضده، بل أشاد بالموكب المظفر لحركة التنوير: “إنه لمشهد جليل جميل أن نرى الإنسان يبدّد بنور العقل كل السحب الكثيفة، ويحلّق بالفكر إلى الفضاء”.
كان تفنيده لمنجزات العقل، لما استجرّه من فوضى، وتجريده للحياة من المعنى، ما حرّض الناس على العودة إلى الإيمان، وحضهم على الفرار من الضجيج، والنفور من زحام المدن، والتوق إلى حياة الريف البسيطة، والطبيعة الزاهية بفصولها الأربعة، عالم من الطمأنينة، حيث النساء محتشمات يرتدن الكنيسة أيام الآحاد.
” بالاسترشاد بروسو، ما زلنا نراوح في عصور الانتكاسات الأخلاقية”
لم يكتشف روسو الحقيقة، كانت مبذولة، فالعقل لم يذهب بالإنسان إلى السعادة، وإنما استجره إلى الحيرة. التقدّم الحضاري من صناعات وعلوم وفنون، لم ترافقه نقلة توازيه في تهذيب الأخلاق، بل في ترديها، العلاقة بينهما مشكوك بها، وعكسية، فلا نأمل أو نتوهم، يحق للنفوس أن تيأس.
لم تُخفِ دعوة روسو الرغبة الطيبة في إصلاح العالم، الإنسان يولد بريئاً، بينما التقدّم يثير التنافس والأنانية والفتنة والجشع…. صيحته نداء للقضاء على الانحرافات الكامنة في النفوس، وتسهيل الحضارة إطلاقها.
ما استوقف روسو في عصره، انسحب على ما بعده من عصور، وأصبحت الحضارة تمثّل الشر، أينما حطّت رحالها بذرت آثامها؛ استعمار البلدان واسترقاق أهلها، ظهور الدول الشمولية وانهيارها، اندلاع حربين عالميتين أفقدت الإنسان الإيمان بالتعاضد البشري، طغيان الرعب النووي، التكنولوجيا التي حقّقت التواصل بين البشر، أحكمت الرقابة عليهم، ما شكل وصمة كبرى لانتصارات تتقدم تحت قصف المدافع، وفوق جثث الضحايا وأشلاء المشاعر، وتآكل العواطف وازدهار تجارات الموت، العائلة تضمحل وتتفتت، أو لا عائلة.
في الجانب المقابل، مضادات الحضارة الهوجاء ما زالت فاعلة، أصبح الخيال أنشط، يبحث عن حلول لمأزق حضارة تواصل تعدياتها على البشر، وهُم في أشد الحاجة إليها. ما الذي ينقذهم من تقلّباتها؟ هل في العودة إلى الطبيعة، والجنوح إلى الرومانسية، استعادة للقيم المفتقدة؟
تنحو البشرية إلى تمثّل روح العصر الوثّابة والجامحة، الحريات الطليقة تشدّها إليه، حريّات قابلة للعطب والمصادرة، تغوي الناس وتستعبدهم، وربما في إعادة النظر إلى الحريات نفسها خيار صعب، إذ لا عودة عنها، ولو كان الشر هو الضريبة، فالنقمة لا تقلّ عن النعمة. بالاسترشاد بروسو، ما زلنا نراوح في عصور الانتكاسات الأخلاقية.
-
المصدر :
- العربي الجديد