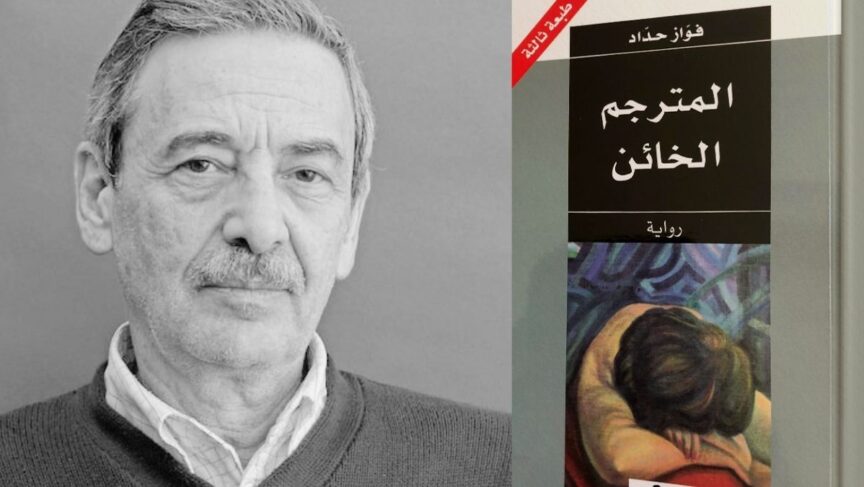هل أمثولة النجاح بأيّ ثمن من ثمرات الحضارة الحديثة؟ في الحقيقة، منحها التقدّم منزلة المأثرة الكبرى، وبالغ بها حتى أصبح هذا النوع من النجاح مقياساً لقيمة الإنسان، يثبت أنه على حق، وفي الجانب الصحيح، بينما الخسران يعادل الهزيمة، واتخاذ الجانب الخطأ؛ إنه الباطل الأكيد.
دافِع التقدّم هذا، شمل طموحات البشر بمختلف أنواعها. فالسياسيون المبشرون بالديمقراطية يجب أن يربحوا الانتخابات، ولو كان على حساب الصدق. الدعاة إلى الدين يفرطون بالرحمة لنشر دعوتهم بالقوة. دعاة الأخلاق الحميدة يتوسلون الدهاء لاستجرار الناس إلى صفهم.
وهكذا في التجارة والأدب والسينما وأدوات التجميل وأدوية التنحيف… إلخ. فالغاية النجاح بأيّ ثمن ولو كانت وسيلته الأكاذيب، أما الضحايا فالمريدون العميان، دون النظر إلى أن النجاح لا تبرّره الوسائل اللاأخلاقية مهما كان عظيماً.
“النجاح بأيّ ثمن” يترجم أيضا إلى “الانتصار بأيّ ثمن”، وهو المنطق الذي سيطر على العالم في القرن الماضي، ولم يتوقف في القرن الحالي. ففي العصر النووي، وضع امتلاك روسيا وأميركا للقنبلة الذرية العالم على حافة الهاوية، بادعاء أن كلا منهما لديها الوصفة لإنقاذ العالم من الآخر، وهكذا تموقعت الأيديولوجية الشيوعية في مواجهة الأيديولوجية الإمبريالية وكانت مادة الصراع بين القطبين المهيأ له المضي الى آخر الزمان، يحكمه مبدأ التسابق على التسلّح.
انهيار الاتحاد السوفييتي وانفراط عقد كتلة دول أوروبا الشرقية، عطل هذا الصراع، وإن مؤقتاً. لم يسترد الروس رشدهم إيماناً بالسلام، بل لاستعادة إمبراطورية أضاعوها في غفلة عن الزمن، باتت حلمهم المنشود، ولن يعدموا الذرائع لاستنفار شعوبهم، لبعث الإمبراطورية الى الحياة. ما يبشّر بارتداد منطق الصراع على هدي النصر بأيّ ثمن.
وتبلغ المحنة القمة في المأساوية بانتقال العدوى إلى الدول الصغيرة، قادتها لم يتورعوا في سبيل البقاء في السلطة عن تسجيل النصر المؤزر على شعوبهم، ولو كان بقصفهم بالقنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة.
وكأن الحياة محكومة بدائرة شريرة، تزج بالبشر في دوامة لا خروج منها. لكن التاريخ الممهور بملايين القتلى، وحمّامات الدم، ومآسي اقتلاع الشعوب من جذورها، ليس قدراً لا انفكاك منه، فلمن يريد التعلّم من دروسه لن يعدم في حروب القدماء العبرة والحكمة.
إبّان الصراع بين اليونان وروما، جهّز الملك اليوناني بيروس جيشا ضخماً، وأقسم على أن ينتصر، وبالفعل انتصر على جيش روما وذبح الآلاف من سكّانها، لكن دُمِّر جيشه الضخم المدعوم بخمسين فيلاً وبآلاف المقاتلين الأشداء.
بعد المعركة، أطلّ بيروس على ساحة حرب كانت على مدّ النظر. لم يبق من معالم روما سوى الأطلال، الناهبون يعبثون بين أنقاضها، بينما جثث الجنود من الجيشين مسجاة على الأرض، تحوم فوقها العقبان وتتناهشها الذئاب. يقال، إن بيروس ركع واستجدى ربه باكياً: إلهي، لا تحقق لي المزيد من الانتصارات، الانتصار بأيّ ثمن ليس انتصاراً على الإطلاق.
-
المصدر :
- العربي الجديد