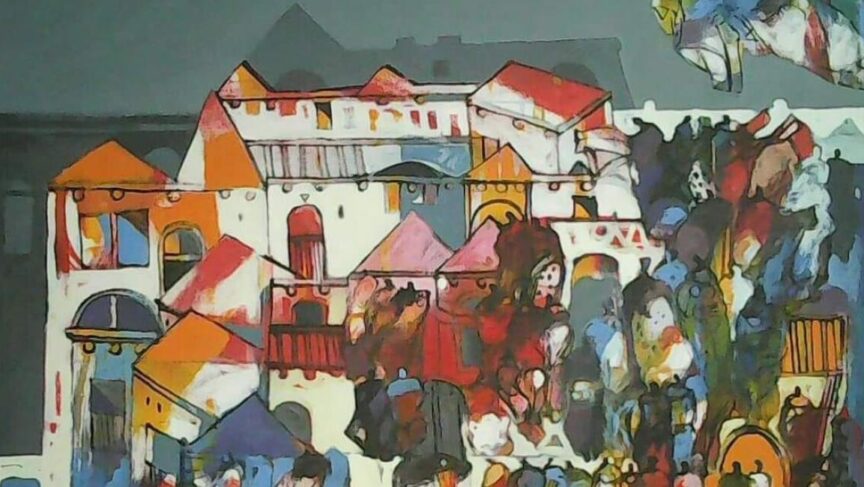لا يتضمّن الجواب على السؤال المطروح الاطّلاع على أحوال الماضي ولا العبرة والمعرفة فحسب، إنما ما يقدّمه التاريخ من دروس، هل تستفيد البشرية منها؟ إذا كان، فلماذا يكرّر البشر أخطاءهم على هذا النحو أو ذاك؟، ما يدمغ تاريخ الإنسانية بالجرائم، ودائماً كان للعنصرية النصيب الأكبر، رغم تكاليفها البشرية الهائلة، ولا يفعل الإنسان شيئاً حيالها سوى إعادة إنتاجها من عصر إلى عصر.
منذ أزمنة الحضارات القديمة حتى الآن، وجِدت العنصرية بذريعة الخوف من الآخر، المختلف، الذي لا يشبهنا، مع أنه مثلنا تماماً، لكنه القادم من خارج الحدود، الفقير والمنبوذ وربّما المطارَد، أو المطلوب رأسه، يُنظر إليه كأنه الغازي متنكّراً باللاجئ. ما السرّ الذي يجعل المجتمع يشعر بأنه مهدّد من إنسان وحيد، ويدفعهم لابتكار مخاوف تتمركز حول هويته، ثقافته، لونه، عاداته. ثم تتعدّاها إلى تحميله مسؤولية ما يطرأ من خلل مجتمعي أو اقتصادي أو معيشي أو ديني، وإذا كنّا في زمن الوثنية، فالآلهة سترفضه.
في عصرنا، ترفضه الحضارة أيضاً. فاللاجئ إذا كان لا يتمتّع بثقافتهم، أو لا يحمل دينهم، فهو متخلّف عنهم، ومنغلق على نفسه، يرفض الاندماج، أو لا يستطيع، فالشقّة واسعة يصعب أن تُردم، فما البال عندما تبرز طقوسه وتعلن رموزه من حجاب ولحية، ومسجد ومئذنة. فيصبح وجوده تحت الرقابة مترافقاً بالتوجّس منه.
يحفل التاريخ بالأمثلة، سواء في اتّهام اليهود في أوروبا بالتسبُّب بالأوبئة أو الأزمات الاقتصادية، إلى اتهام المهاجرين اليوم في الغرب بسرقة الوظائف أو تهديد الثقافة المحلّية بخرافات الأديان. تأتي السياسات الشعبوية وتوظّفها لأهدافها الانتخابية. تنتشر العنصرية أيضاً في الشعوب المنغلقة على حضارتها، تتغذّى عليها، حمايةً للذات، ويجري تعميمها في الإعلام، والثقافة الشعبية، والمدارس والجامعات، واستهلاكها في الخطابات السياسية بتضخيمها وتوصيف مجموعات بشرية بأنها غير متحضّرة، وإرهابية، وتُشكّل تهديداً لها، ما يضعها في قوالب جاهزة، تمهيداً لعزلها في “غيتوات”، أو إقصائِها لاستسهال التخلّص منها ولو بالقتل.
ما الذي يجعل العالم يعيد إنتاج الشّرور القديمة بأثواب جديدة؟
رغم المآسي التي خَلّفتها العنصرية في تاريخ البشرية، من تجارة الرقيق والاستعمار إلى الفصل العنصري والهولوكوست، تُستعاد اليوم في حرب الإبادة في غزة، رغم النضالات الطويلة التي خاضتها الشعوب من أجل الحقّ في المساواة والكرامة، ولا تكفّ مظاهرها عن التكرار بصيغٍ جديدة، وغالباً أكثر مواربة، وبفجاجة أكبر، وكأنما البشر اعتادوا على الارتداد إلى دفاترهم القديمة في الاستكبار، وما تستجرّه من مظالم.
رغم ما شهده القرن العشرون من كوارث عنصرية مروّعة، وتضحيات إنسانية هائلة لكسر حلقات مغلقة، فإنّ القرن الحادي والعشرين لا يزال يشهد عودة أشكال متعدّدة منها، وكأنّ الذاكرة البشرية قصيرة، أو أنّ البنية العميقة للمجتمعات لم تتغير بالقدر الكافي. فما الذي يجعل العالم يعيد إنتاج الشرور القديمة بأثواب جديدة؟ تُنسى الجرائم القديمة أو تُبرَّر، وتُعاد كتابة الذاكرة الجمعية على نحوٍ يُخفي، أو يُخفّف من خطايا الماضي. من دون اعتراف صريح وواضح بأنها جريمة أخلاقية جماعية. إنها حدث قابل للتكرار، في حال غياب الذاكرة أو تغييبها، وربّما ضعفها، هذا إن لم يجرِ التلاعُب بها.
حتى في الدول التي تتفاخر بإرثها الديمقراطي والحقوقي، نجد أن القيم الليبرالية تنهار سريعاً أمام الموجات العنصرية. فحُرية التعبير تتحول إلى ذريعة للتحريض، وسيادة القانون تُطوَّع لتبرير العنف المنهجي، وتختزل المساواة في شعارات لا تُطبَّق فعليّاً في أماكن العمل. لا يتعلّم البشر من التاريخ، ما دام بإمكان السياسة والمصالح إعادة تأويله، لذلك يُعاد إنتاج العنصريات تحت غطاء ما، وتمارس بعلانية أحياناً، وغالباً بصمت.
-
المصدر :
- العربي الجديد