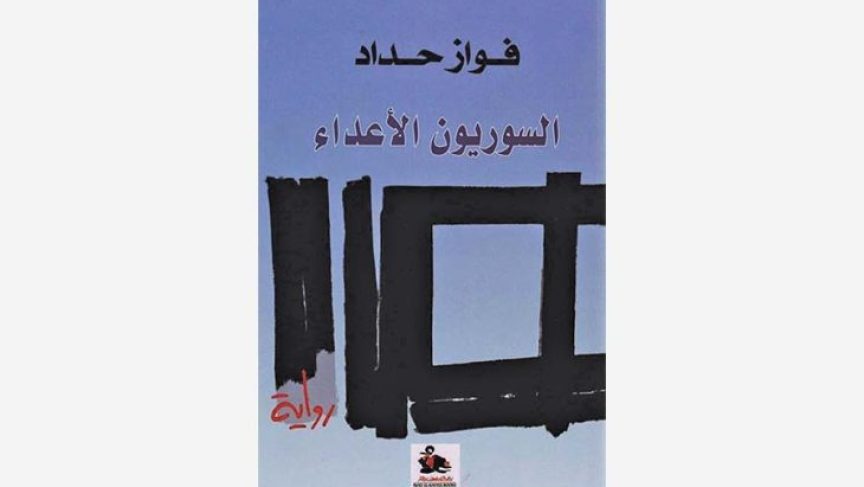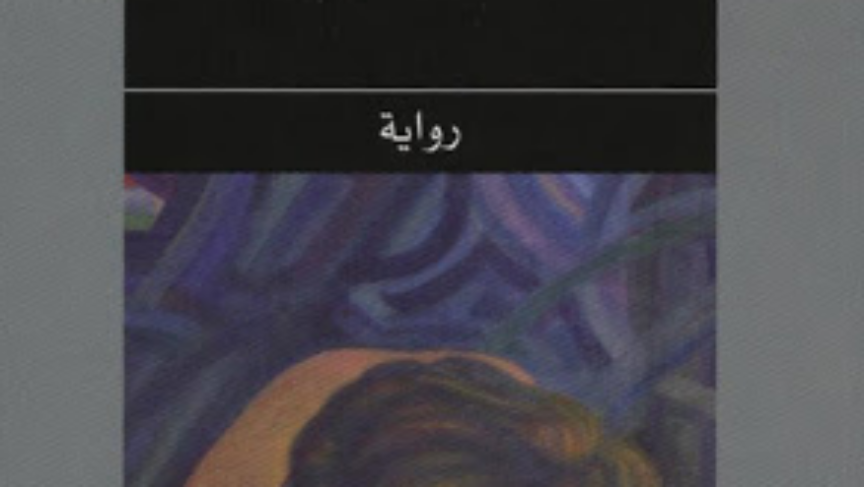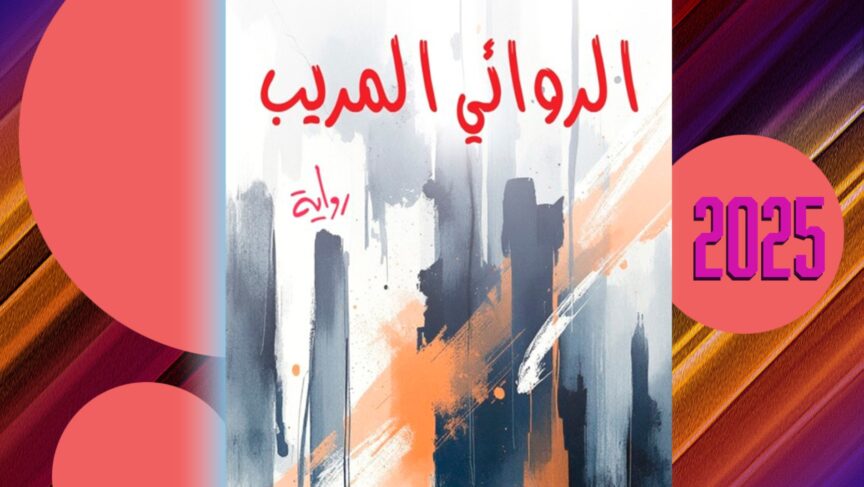بذور الطائفية وتفكيك الهوية
رواية “السوريون الأعداء” لفواز حداد تقدم لنا رؤية أدبية عميقة للواقع السوري في ظل النظام البعثي، حيث يبدأ الكاتب برصد لحظة مفصلية في تاريخ سوريا المعاصر: مجزرة حماة، التي تُعتبر نقطة انطلاق لمرحلة أكثر دموية في تاريخ الحكم البعثي. المجزرة، التي أسفرت عن قتل الآلاف من الأبرياء، ليست مجرد حادثة تاريخية، بل هي بمثابة رمز لبذور العنف والظلم التي زرعها النظام في المجتمع السوري. من خلال هذا الحدث، يُظهر حداد كيف تحول هذا النظام إلى آلة قمعية تقوم بتقسيم الشعب السوري إلى أعداء، عدو داخل عدو، متغذيًا على الفتنة الطائفية التي ساعدت في تماسكه.
الرواية تتناول قضية الطائفية كأداة استراتيجية للنظام، حيث نجح في نشرها لتكون أداة للتحكم والسيطرة على الشعب. هي رواية لا تقتصر على توثيق مجزرة حماة فحسب، بل تسلط الضوء على تداعيات تلك المرحلة المظلمة على المجتمع السوري، من تفكك داخلي إلى تآكل الروابط الاجتماعية والوطنية. تتنقل الرواية بين الشخصيات المحورية التي تجسد تلك الآلام الجماعية، وتكشف عن الانقسام الحاد الذي زرعه النظام بين أبنائه. من خلال المجزرة، يفتح حداد أبوابًا لفهم كيف كانت الطائفية سلاحًا حادًا في تشكيل الوعي الجمعي وتفتيت الهوية الوطنية السورية.
سليمان: ضابط الطائفية وصانع الفتنة في آلة القمع الأسدية
الضابط سليمان أو المهندس كما أطلق عليه حافظ الأسد، يمثل أكثر من مجرد شخصية في السرد؛ هو تجسيد مرضي للطائفية المستشرية التي أصبحت حجر الزاوية في بنية النظام البعثي الأسدي. منذ اللحظة الأولى، يظهر سليمان كعقل مريض يرى في الطائفية أداة لضمان بقائه في السلطة. هو ذلك الشخص الذي أدرك أن الدم هو الأساس الذي يستند عليه النظام ، فسلّم خاله، البعثي المعارض لانقلاب حافظ الأسد 1970، ليتقرب بقربانه إلى القائد ويصبح جزءًا من آلة القتل التي تقوم على الولاء الأعمى للزعيم. في مجزرة حماة، يعكس سليمان تمامًا سلوك النظام الذي حول القتل إلى أداة لتثبيت حكمه، فكان هو الذي قتل عائلة الطبيب الراجي، وأرسل الطبيب نفسه إلى سجن تدمر، ذلك الجحيم الذي يُحوّل الإنسان إلى جسد بلا روح في خضم العذابات النفسية والقهرية.
لكن الأبعد من ذلك، يظهر سليمان في مواقفه خلال ثورة 2011 كأداة لإذكاء الفتنة الطائفية، حيث عمل على تحريض الطائفة العلوية ضد الطائفة السنية، مستخدمًا سلاح النظام لتمويل هذه الحرب التي أراد أن يحولها إلى صراع طائفي شامل. في هذا المشهد، لا يبدو سليمان مجرد منفذ لأوامر، بل مهندسًا -كما أطلق عليه حافظ الأسد- حقيقياً للدم وللفوضى، مبتكرًا طريقًا آخر لاستمرار الفساد والاستبداد.
سليمان في الرواية لا يمثل فقط ضابطًا في جهاز القمع، بل هو صورة حية لآلية نظامية فاسدة وجدت في الطائفية مخرجًا لبقائها. اليوم، لا يمكننا فصل هذا الدور عن الواقع السوري الحالي، حيث تحولت الطائفية التي زرعوا بذورها إلى أداة جديدة لتحطيم النسيج الاجتماعي السوري. سليمان، إذن، هو الوجه الآخر للنظام الذي عمل على تفكيك سوريا من الداخل، مبتكرًا صراعات داخلية كانت بمثابة الوقود لاستمرار الهيمنة البعثية التي ما تزال تداعياتها حاضرة في المشهد السوري اليوم.
عدنان الراجي: قصة البراءة المفقودة في سجون الظلم الأسدي
الطبيب عدنان الراجي ليس مجرد شخصية بدأت فيها الاحداث، بل هو رمز لآلاف السوريين الذين قُدّر لهم أن يصبحوا ضحايا آلة القمع التي لا تفرق بين بريء ومتهم. عدنان الراجي هو طبيب عادي، لا علاقة له بأي تنظيم سياسي أو ديني، وكل ذنبه أنه وُلد في مدينة اختارها النظام لتكون مسرحًا للدماء. لم يكن الراجي جزءًا من المعارضة أو حاملاً لأفكار راديكالية، بل كان مشغولاً بمهنة الطب في عيادته، بعيدًا عن أي صراع سياسي، لكن هذا لم يشفع له أمام الضابط سليمان، الذي كان يرى في المدينة التي ينتمي إليها الراجي تهديدًا حقيقياً ووجودياً للنظام
في الرواية، يُختطف الراجي من حياته الطبيعية، وتبدأ معاناته من لحظة إرساله إلى حقل الرمي ثم إلى سجن تدمر، حيث القتل الممنهج والتعذيب الذي لا ينتهي. في هذا المكان، يتحول الراجي إلى كائن فاقد الهوية، يتجرع الظلم ويعيش في عزلة قاسية، حيث يكتشف أن لا قيمة له في نظر النظام سوى كأداة للتنكيل.
هذا التحول في شخصية الراجي يعكس حال آلاف السوريين الذين أُلقي بهم في غياهب السجون والمقابر الجماعية دون ذنب، مغيبين قسريًا بسبب واقعهم السياسي والاجتماعي. مثل الراجي، عاش كثيرون في حالة من التيه والتشظي، حيث فقدوا ذواتهم وحُرموا من حقوقهم الأساسية في العيش بكرامة. مثل الراجي، كانوا ضحية للطغيان، ضاع مستقبلهم وسط آلة القمع التي مزقت الشعب السوري وأضعفته.
الرواية، إذن، لا تكتفي بتوثيق المعاناة الفردية لعائلة الراجي، بل تسلط الضوء على معاناة الشعب السوري بأسره، الذي اختُطف من قبل النظام ، ليصبح مواطنًا مفقودًا في وطنه.
سليم الراجي: قاضٍ بين مبادئ العدالة وطغيان النظام
القاضي سليم الراجي -أخ الطبيب- يمثل الضحية الخفية لنظام استبدادي لا يرحم. كان سليم يسعى، بشرفٍ ووفاء، لتحقيق العدالة في بلدٍ لا تعرف فيه العدالة سوى الاحتكام لسلطة القمع. يبدأ سليم الراجي رحلته كمواطن شريف ملتزم بالقانون، باحثًا عن الحق في مجتمع يواجه الظلم كل يوم. لكن مع مرور الوقت، يكتشف القاضي أن ما كان يعتقده “قانونًا” هو في الحقيقة أداة لإحكام قبضة رأس النظام على زبانيته ورجاله إن هم فكروا بالانقلاب عليه. لم يكن سليم الراجي مجرد قاضٍ، بل كان، في جوهره، صورةً للمواطن السوري البريء الذي سعى لإصلاح النظام من داخله، ليكتشف في النهاية أن هذا النظام لا يقبل الإصلاح.
ما يبرز في شخصية سليم هو انقسامه الداخلي بين إيمانه بالقانون ورؤيته للواقع القاسي الذي يعيشه. فبعد مجزرة حماة التي أودت بحياة عائلته، أصبح سليم شاهدًا على الظلم، دون أن يكون قادرًا على تغيير مصير أسرته. أكثر ما يثير الاهتمام في شخصيته هو أنه لم يخضع، رغم كل الفظائع التي تعرض لها، بل حاول أن يظل مخلصًا للقيم التي آمن بها. لكن الضابط سليمان، الذي كان يمثل أداة النظام القمعية، استغل إحساس سليم بالمسؤولية، وحوله إلى أداة قمعية أخرى تعمل لصالحه.
الرواية هنا لا تقتصر على تسليط الضوء على شخصية سليم، بل هي رمز لآلاف السوريين الذين استُخدموا من قبل النظام على مر العصور، ليظلوا حبيسي أيديولوجية خادعة تهدف إلى تدمير أي أمل في العدالة. تُظهر الرواية كيف أن الشرعية القضائية، التي كانت في يوم من الأيام سيف العدالة، حُولت إلى سكين قمعي، محطمة بذلك أي فكرة عن المواطنة المتساوية في ظل الطائفية الممنهجة والظلم العبثي الموزع بالعدل.
سوريا بعد التحرير : بين بقايا الطائفية والمواطنة المشتهاة
لا تقتصر هذه الرواية على سرد الأحداث السياسية أو توثيق الحقائق التاريخية فحسب، بل تعمق في الأعماق النفسية للشخصيات، موضحة تأثيرات النظام القمعية على نفوس الضحايا والمجرمين على حد سواء. الكاتب يذهب أبعد من الصراع الظاهر، ليرصد الانقسام الداخلي الذي أحدثته الطائفية في نفوس الناس، وكيف أنها لم تكن مجرد أداة في يد القوى العليا في النظام، بل تسللت إلى طبقات الشعب السوري كافة وبذلك تحقق ما سعى له النظام منذ بدايته. هذه الطائفية، التي أصبحت سمة مميزة لحكم الأسد، عملت على تفكيك الوحدة الوطنية وخلقت صدوعًا اجتماعية عميقة، حتى داخل الأفراد أنفسهم. كل شخصية في الرواية تعكس تصدعًا نفسيًا ناشئًا عن هذا الواقع المرير، ما يجعلها أكثر تعقيدًا وتأثيرًا في المتلقي.
ومع ذلك، لا تقف الرواية عند حدود تصوير المعاناة تحت حكم النظام، بل تطرح أسئلة وجودية تظل مطروحة بعد سقوطه: هل يستطيع السوريون تجاوز الآثار الطائفية التي زرعها هذا النظام في المجتمع؟ السؤال الذي يظل يطارد كل قارئ هو: هل يمكن محو إرث الطائفية بعد زوال السلطة، أم أن هذا الإرث الثقيل سيظل ينخر في النسيج الاجتماعي السوري، مخلفًا تفككًا لا يُمكن ترميمه؟ المعاناة التي عايشها الشعب السوري لفترات طويلة تركت بصمات لا يمكن محوها بسهولة، وتبقى الأسئلة حول كيفية إعادة بناء العلاقات الإنسانية بين السوريين في ظل هذه الانقسامات الطائفية، هاجسًا يواجه الجميع في المرحلة التالية للثورة.
خاتمة الألم وأفق الوحدة الوطنية المنتظرة
عندما تُقرأ الرواية في هذه الأيام أي بعد سقوط الأبد، يمكن القول إنها لا تقتصر على التوثيق السلبي فحسب ، بل تفتح أفقًا للأمل. فكما سقط النظام، يظل السؤال الأكبر: هل يمكن لسوريا أن تتجاوز الطائفية التي كانت صنيع النظام ليقوى؟ الرواية تؤكد أن التحرر من إرث الطائفية يتطلب أكثر من مجرد سقوط النظام، هو عملية عميقة تتعلق بإعادة بناء العلاقة بين السوريين على أسس من المواطنة والمساواة. في هذا السياق، تقدم الرواية أملًا من خلال فهم بداية هذا الصراع الذي حوّل السوريون إلى أعداء، في أن سوريا بعد الأسد ستعود لجميع أبنائها، وأن الوحدة الوطنية، التي سعى النظام لتدميرها، يمكن استعادتها، فمن سعى إلى تدميرها تَدمّر. وبذلك يتعين على السوريين أن يتجاوزوا ما زرعه النظام من فتنة طائفية لتبقى سوريا أرضًا للعدالة، وللتفاهم، والمحبة بين كافة أطيافها ومكوناتها وأجناسها وأعراقها.
هي سوريا العظيمة، ملكٌ لكل السوريين.
-
المصدر :
- سطور