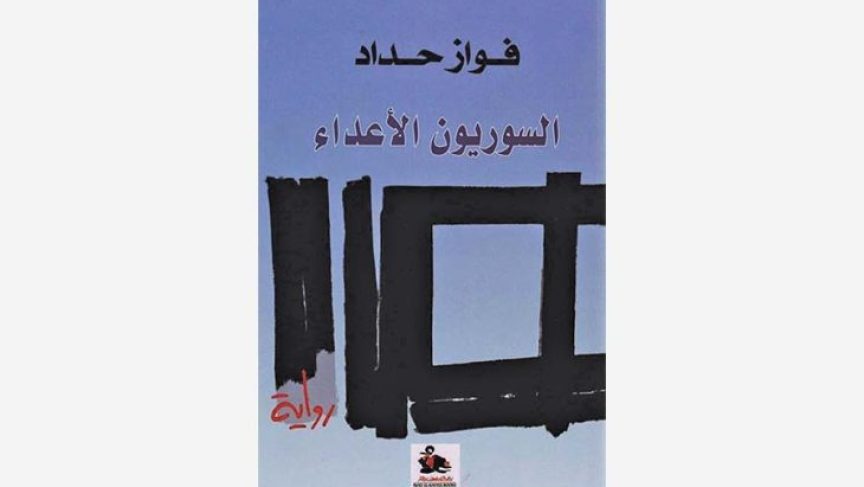إذا كنت اعتبر قراءتي هذه، قراءة متأخرة لرواية فواز حداد «السوريون الأعداء» بيروت – دار رياض الريس 2014، فليس لأنني قرأتها مؤخرا، وإنما لما أثارته من نقاش وجدل. يرى الشاعر منذر مصري أن «السوريون الأعداء» هي أكثر رواية اختلف على تصنيفها والحكم عليها السوريون المشغولون بتصنيف أنفسهم، والحكم على أنفسهم، هم بالذات، بالإصرار على لصق تلك الصفة ـ التهمة بها، التي يحار المرء كيف يمكن لكائن من كان قراءة أي عمل أدبي يضعها في رأسه: «هل هي رواية طائفية لكاتب غير طائفي؟ أم رواية غير طائفية لكاتب طائفي؟ أو أنها ليست طائفية وكذلك الكاتب حكما؟ ليأتي الاحتمال الأخير، الأشد عسفا، رواية طائفية لكاتب طائفي!». ربما كان هذا البحر من الاحتمالات دليلا على عدائيتنا السورية! وكان للرواية من اسمها نصيب!
منذ البداية، ما أن يلتقط المرء أنفاسه ويستعد للانطلاق، حتى يطالعه كمّ هائل من العنف، ذلك النوع من الوصف القاسي الذي يترك غصة في الحلق، وشعورا قابضا في المعدة. تساءلت في ما إذا كان سير الرواية سيكمل على هذا المنوال؟ أم أنه سيتصاعد كالمعتاد مع تقدم الأحداث؟ غريب أن تبدأ القراءة وتصطدم بتلك المشاهد أولا بأول! فماذا إذن يخبئ لنا الكاتب في الصفحات المقبلة؟ وهكذا، مع تتابع الفصول وتوالي الأحداث، أدركت كم أننا، نحن السوريين، أعداء حقا، وكم تشبهنا هذه الرواية إلى حد الألم.
بالتأكيد نجح الكاتب في محاولته رسم الواقع، عاريا، كما هو، دون أي محاباة أو أي تورية، فكل شيء مرئي وواضح للعيان، التسميات والأحداث، الكره والخوف، الحقد والعنف، حتى الروائح والأصوات بأنواعها يمكن شمها وسماعها. مظاهر رسمت المشهد السوري، شهدناها وعشناها، وربما ساهمنا بها بإرادتنا أو غصبا عنا، لكننا عندما نقرؤها، نتوقع أن تبدو مختلفة، أو مخففة، عسى أن نستطيع تقبلها واحتمالها. إلا أن الأمر أشبه بكابوس طويل لا نهاية له ولا يقظة منه، عانى منه من يسمّون سوريين أطوارا وعقودا، لدرجة أنّ حواسنا تخدرت، وكأننا اعتدنا خلالها كل ذلك الذل والمهانة والخنوع، وتقبّل الأفكار المجهزة لنا، دون السماح لنا بمجرد التفكير وإعادة النظر. لهذا أعتقد أن أهمية هذا العمل تأتي من كونه يجعلك تحلق عاليا لتنظر إلى أسفل، نحو تلك المجازر التي حصلت وما تزال تحصل، ما يجعل الرؤية أوضح وأكثر شمولا. القرب من الواقع، القرب جدا من الواقع، أظنه يعمي البصر والبصيرة معا، وليس كالبعد الذي يسمح لك بمجال رؤية أكثر اتساعا، يضعك في موقع المحاسِب المنتقد لنفسك، قبل أي أحد آخر.
قد يبدو أمرا فظا، تسمية الأشياء بمسمياتها، مثيرا لكثير من الإزعاج وردود الفعل الغرائزية وما دون الوطنية، كالمذهبية والطائفية، كما أشاع الكثيرون بخصوص هذه الرواية، لكن لا بد من التجرد عن كل ما يعتمل في النفس من أفكار وآراء مسبقة، والتفكير في العمل بموضوعية وعقلانية. لأنه في النهاية، الكاتب هنا يصور واقعا، لا خيالا، لذا لم أجد مبالغة ولا مغالاة في رسم الشخصيات ولا في مجرى الأحداث. تلك الجرأة في الطرح، قد تثير الحنق لدى البعض، ليس كما يقولون إنها تجيش مشاعر الكراهية، وإنما لسببٍ آخر، هو أن كل ما ذُكر فيها كان حقيقة، وليس هناك ما هو أكثر مرارة من الحقيقة! عارٌ أننا نتاج هذه التمثيليات والأوهام حينا، والمساهمون فيها حينا آخر، أما العار الأكبر أننا ما زلنا إلى اليوم، رغم كل الدلائل المادية والمعنوية، ننساق وراء الأكاذيب ذاتها والأوهام ذاتها. فكم هو مؤسف أن هذه الرواية تنطبق على سوريا، بلدنا، وطننا، منذ زمن بعيد وإلى اليوم.
أما عن اللغة، فكانت لغة سهلة، لا تحمل تعقيدات، المحتوى أخذ على عاتقه هذا الجانب، فكان لا بد من لغة بسيطة تنقل هذا المحتوى إلى القارئ، دون إثقال عاتقه بمزيدٍ من الأعباء. استكمالا للمحور الأساس الذي تدور حوله الرواية، وهو تحليل الحرب السورية القائمة بين أبنائها، كان هناك إلقاء للضوء على كثير من المسائل الوجودية، كالإيمان والشك والاضطرابات النفسية والإجرام والجشع والجهل. فجاء على لسان الشخصيات في نظرتها للإيمان واللايقين:
«وكان الله الغائب الأكبر…»
«إذا كان الأمر محلولا بالإيمان بأي شيء، فلماذا الله بالذات؟ الرائد لم يخيّب ظنه، أخذته الحماسة وقطع الصلة بينهما، ليخلص إلى عدم توفر القناعة لديه بقدرة الله إذا كان موجودا، لا سلطة له على هذه المليارات من البشر، الكون خرج من يده، هذه الأفكار تؤيدها حقائق ما يجري في العالم، الحروب لا تتوقف، الكوارث على قدم وساق، النازحون بمئات الآلاف، عدا المجازر.. لو أنه كان موجودا لتدخل بالتأكيد».
«ماذا لو لم يكن هناك رب؟».
«كان الله يؤرقه، في وقت فات الأوان فيه على الإيمان والشك والكفر والإلحاد. كان حانقا على الله أكثر. أراد أن يقسو عليه ويصارحه؛ ليس هناك رب في المكان الذاهب إليه».
إنها مقولات تدعو إلى التفكر بحذر، خصوصا ضمن السياق الذي جاءت فيه، وعلى لسان الشخصيات التي طرحتها، إذ تشاركت تلك الشخصيات في شكوكها، واختلفت اختلاف الليل والنهار في تصرفها حيالها.
اللافت في هذه الرواية أيضا، من عنوانها إلى ختامها إلى كل ما جاء فيها من أحداث، أن لا حضور قوي للحب. في أعتى قصص الحروب وأكثرها قساوة، لا بد لحبِّ حاضر يخفف من ثقل المشهد، لكن كيف للحب أن يكون في غابة كتلك؟ ربما ما مضى بسوريا نحو كل هذا الخراب، أنّ الحب لم يكن موجودا.
«هذه البلاد لا يؤسف عليها، لن يبقى حجر فوق حجر، يعرفهم، أليس واحدا منهم؟ يرى بوضوح ما بعده وضوح، الآلاف المؤلفة من القتلى والجرحى والمفقودين وذوي العاهات. لا تأسف، هذه البلاد بلاد الخلود والموت، المجد والخوف. لم يعان من الخوف، ولم يظفر بالمجد، الخلود لغيره، والموت له. كل هذا الموت والدمار، ما كان ليحدث، لو أننا… وضغط على الزناد، لئلا يندم».
في الخاتمة، ما أعتقده أن هذه الرواية، هي محاولة تفسير لما جرى في سوريا منذ عقود وإلى اليوم، أكثر من كونها توثيقية. هي محاولة تحليل نفسية كل الأطراف التي ساهمت في هذا الخراب، سواء بمواقفها الفاعلة أو السلبية، وأي تفسير طائفي للرواية، في رأيي، هو أن صاحبه، ربما، لم يتخلص بعد من نزعة طائفية كامنة في العمق، قد لا يكون من صَنَعها، وإنما هي رواسب نظام فكري وسياسي وظرف مُعاش، هيمن على أنفسنا ورسم مخاوفنا وشكوكنا. نزعة يخجل صاحبها منها ويجاهد لإخفائها. ربما ما فعله الطبيب عدنان الراجي في الرواية، بعدم تحويله المشكلة الكبرى إلى ثأر شخصي وانتقام دموي، إشارة من الكاتب إلى أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سلميا، على الأقل بين أبناء الوطن. مهما علا صوت الظلم، لا بد أن يحل السلم والوعي بين أبناء الشعب مكان العنف والثأر، وإلا كيف لهم أن يعرفوا عدوهم الأوحد الذي تلاعب بهم وكأنهم بيادق على رقعة شطرنج غير منتظمة، رسمها كما يشاء، ووزع مربعاتها مع من يشاء، بأسماء من يشاء!
«السوريون الأعداء» عمل روائي يتنكب به فواز حداد مهمة تنبيهنا للحال الذي نحن عليه، إلا أننا، لأسباب وغايات كثيرة نتجاهله وننكره. والمأساة التي تتبدى دون أي رغبة بالمواربة في هذه الرواية، أننا أحيانا نرضى به ونبرره ونحارب بعضنا من أجله.
-
المصدر :
- القدس العربي