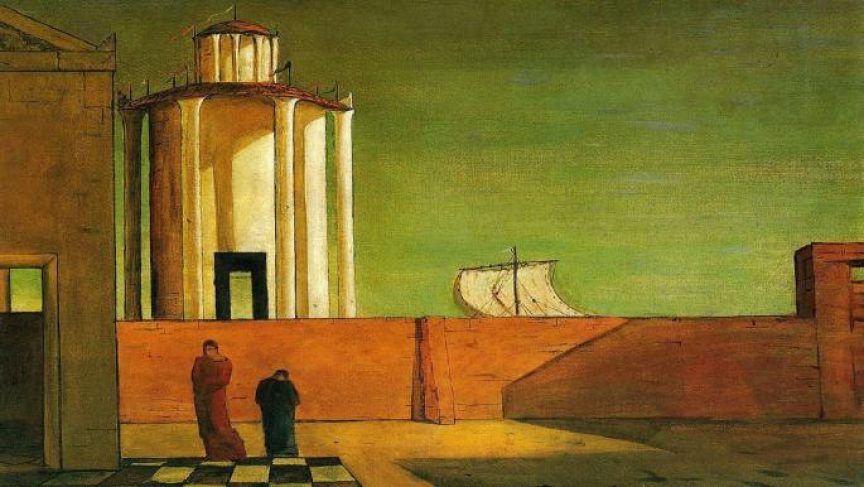ليس من السهل التحلّي بالحكمة. إنّها ليست منحة ولا موهبة، فنحن لا نُخلَق حكماء، بل نُصبح حكماء. تُكتسب الحكمة من التجربة والخبرة والتأمُّل، لكن حياة الفرد مهما اتّسعت وطالت، لا تمنحه الخبرة الكاملة لمواجهة مختلف ما يستجدُّ من مواقف غير محسوبة، مفاجآت الحياة لا تنضب، مع ملاحظة أنَّ الحكمة تُجنى بالمِحن القاسية والتجارب المريرة؛ فالحياة الصعبة لا تُوفّر ألماً، وتُكافئنا بأكثر الخبرات أصالةً، إنها الحكمة المجرَّبة، الحكمة على سندان الواقع.
يستعين الإنسان، مع تدرُّجه في الحياة، بخبرات الذين حوله، فالأُسرة تُوفّر قدراً منها في مرحلة الطفولة، وترفده المدرسة والجامعة بقدر آخر في فترة الشباب، بينما الحياة العملية تضعه في مواجهة العالم؛ الاختبار الأكبر، فتمتحن ليس قدراته وطموحاته فقط، بل وبالدرجة الأولى الإنسان في داخله، إلى أي حد يتمسّك أو يتنازل عمّا آمن به.
طالِب الحكمة لا يكتفي بما تُعلّمه إياه مصادفات الحياة، بل يولي وجهه صوب الماضي أيضاً، وما يختزنه من معرفة وخبرة، قد يجد هناك ضالّته من الحكمة، ولو كانت ابنة زمانها، فالحكمة لا زمان لها. تجارُب الحياة تُعلّمه التروّي في النظر إلى الأمور. هذا أبسط ما يمكن أن يوحي به العيش في عالم مضطرب يتعرَّض لما لا يمكن التنبُّؤ به، تُساعدنا المعرفة المتسلّحة بالعلم والأخلاق.
هذه المقدّمة تُعتبر تقليدية، قرأنا على نمطها الكثير، وإذا كانت تتكرّر فلأنها لا تعدم قدراً غير ضئيل من الصحّة. وربما في الإلحاح عليها إدراك أنّ الحكمة ليست على قارعة الطريق، لكنها غير ضنينة ولا محتكَرة، وإذا كانت مبذولة، فلمن يبحث عنها ويتزوّد بها، وفي الاعتراف كلّما تقدَّم العمر بنا، بأن ما جنيناه من خبرات في حياتنا غير كاف، يعني أنه ما زال ينقصنا الكثير، وبوسع الإنسان التعلُّم يومياً.
إن كانت الحكمة مبذولة، فلمن يبحث عنها ويتزوّد بها
أنجبَت البشرية الأنبياء وعباقرة الفكر من العلماء والفلاسفة والأدباء، ولم يكن لتباهي بلدانهم بهم، إنهم طارِدو الظلام ومشاعل النور للإنسانية جمعاء. وقصّة النبي أيوب، تهب المؤمنين أمثولة على الابتلاء بالمصائب، وإدراك أن التحلّي بالصبر هو الموقف الحكيم منها، والصمود في وجه الشدائد، وعدم الاستسلام للشر.
لا تقتصر الحكمة المبثوثة في الكتب السماوية على دين دون آخر، ولا على كتب القدماء أو المحدثين، فالحكمة خبرة إنسانية، قد تبدو كأنها اختصاص الفلاسفة وحدهم دون الأدباء. ففي التراث الفلسفي الممتد من اليونان إلى ديكارت، كانت الحكمة تُمثّل المعرفة الكاملة، الناتجة عن الفلسفة والعلم معاً، واعتبرها أفلاطون إحدى الفضائل الأربع بالإضافة إلى الشجاعة والاعتدال والعدالة. وفي العصور الحديثة، توافرت في كتابات الفلاسفة العلمانيّين والعقلانيّين من أمثال سبينوزا وجان جاك روسو وكانط وهيغل ونيتشه وكيركيغارد. بيد أن الأدباء لم يتخلّفوا عنها، وأدلوا بنصيبهم منها؛ شكسبير في مسرحياته “هاملت” أو “ماكبث” أو “الملك لير” وغيرها. وسيرفانتس صاحب رواية “دون كيشوت”، ويمكن إدراج الكثيرين مثل غوته ونيتشه، بل وأسهم فرويد بتصوّره للحياة الحكيمة العاقلة.
وتتجلّى الحكمة في مثال مونتاني، أبرز من كتب في الحكمة في القرن السادس عشر، في كتابه الوحيد “المقالات”، المستمدّ من تأمُّلاته العميقة حول الحياة والموت، ومن أحداث التاريخ في الماضي والحاضر. تحافظ هذه الحكمة على حضورها إلى زمننا هذا؛ القرن الواحد والعشرين. ففي تأمّلاته حول الموت تتمثّل الحكمة في عدم محاولة التغلّب عليه، إنما في محاولة التغلّب على الخوف منه، فالموت قادم في كل الأحوال، ولا مهرب منه. فلماذا نخاف منه إذاً؟ ينبغي أن نتقبّله بكل رضى وطيبة خاطر كأمر محتوم. واعتبر أن الفلسفة، تحديداً، تحضيرُ النفس للموت. وإذا لم تساعدنا على تقبّله بكل شجاعة وجرأة، فلا معنى لها.
تساعد الحكمة البشر في أخطر ما يجهلونه. ففي اعتبار الموت الحقيقةَ الكبرى إدراكٌ لحقائق أُخرى، لا تقلّ عنها: مثلاً، حقيقة أن الحياة ثمينة، وحسب مونتاني: الحياة تحفتنا العظيمة والمجيدة، وكل وقت هو الوقت المناسب إن أحسنّا الاستفادة مما تعلّمناه.
-
المصدر :
- العربي الجديد