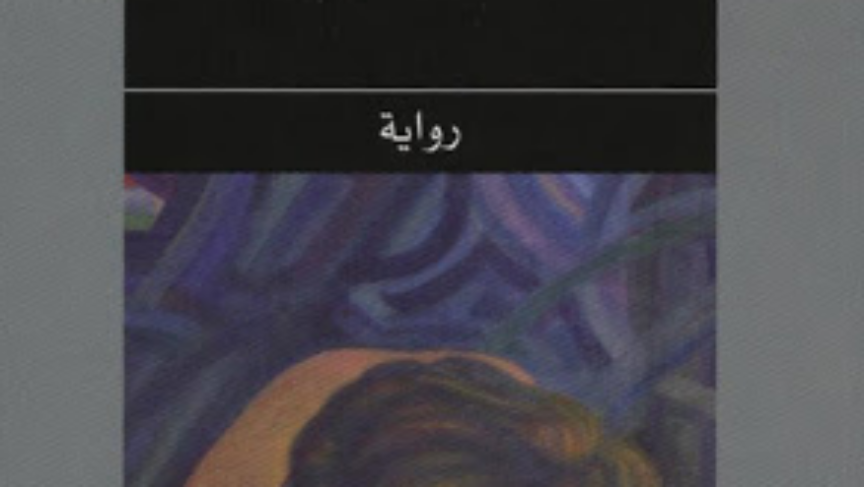يُعدُّ الروائي السوري فواز حداد أحد أبرز الأصوات الأدبية التي لم تساوم على الحقيقة، ومنذ بداياته يسأل التاريخ والسياسة والثقافة، كاشفاً المسكوت عنه، موقفه المناصر للثورة السورية انعكس في أعماله، حيث انتقد في عمله الأخير (الروائي المريب) ما أسماهم مثقفي الضباب الذين تواروا خلف الشعارات، بينما كانوا امتداداً للفساد والانتهازية، مؤكداً مسؤولية المثقف وحرية التعبير في مواجهة القمع والتحولات الصعبة.
في هذا الحوار مع سانا، يتناول حداد رؤاه حول الحركة الثقافية السورية خلال نصف قرن، وعلاقته بالثورة كأديب صنع أعماله مع التركيز على تقنيات الكتابة والسخرية السوداء التي استخدمها لمواجهة قسوة الواقع، مؤكداً مسؤولية المثقف والحرية الأدبية في زمن التحولات العاصفة.
1ـ ماذا قصدت بعبارة مثقفي الضباب؟
مثقفو الضباب، تعبير يشير إلى إخفاء بعض المثقفين مواقفهم الحقيقية، وعدم اظهارها، حسب الأحوال السياسية، سواء كانوا يساريين سابقين، وربما قوميون، أو متعاطفون مع الدين أو ضده، تقدميون أو رجعيون، وحسب تنظيراتهم، قد تكون الأديان سبب التخلف، وعندما تستدعي ظروفهم التحول من طرف إلى طرف، تكون مصالحهم هي العامل الأول في انحيازاتهم العلنية والسرية، كما أنهم يطلقون اتهامات ضد المعارضين حول الطائفية والإرهاب والتأسلم، وبالنسبة إلى قضيتنا السورية، هؤلاء كان يطلقون شعارات تقدمية ويسارية، بينما كان انحيازهم للنظام الديكتاتوري.
إن ممارسة هذه الأدوار والتنويع بينها، تتطلب منهم التستر بالضباب، ففي الضباب يستطيعون أن يكونوا ما يشاؤون، طالما أنهم مدربون على انتهاز الفرص، لكن إذا أدركنا أنهم جزء من نظام فاسد فلن نتوه عنهم، فهم يمارسون الانتهازية بأحط صورها، والثقافة تقدم لهم الذرائع للكذب والادعاء وتلفيق التهم.
كان ظهورهم جلياً بعد عام 2011، فالأوضاع باتت على المحك، المظاهرات والرصاص في الشوارع، والاعتقالات والمداهمات ليل نهار، ما جعل الشخصية الضبابية تتبلور على نحو مشين في هذه الفترة، بينما كان النظام يمارس القتل كآلية عادية للقضاء على الثورة، لم تستثن المثقفين، الذين قدموا ضحايا، اختفوا في السجون أو قتلوا جراء نشاطهم الإعلامي والإغاثي، ولم يوفر المشتبه بهم، أو حتى الذين يكتبون على صفحات التواصل.
لعب مثقفو الضباب في تاريخ الثقافة السورية دوراً طالما تكرر، فقد كانوا مع النظام والمعارضة في آن واحد، حسبما تميل الكفة يميلون معها، فمثلاً مع سقوط النظام، كانت أصواتهم الأعلى ضد النظام البائد، ثم مع ظهور الانتقادات ضد الدولة الجديدة، عادت أصواتهم تعلو تحت راية الديمقراطية والعلمانية، إنهم جاهزون لجميع الاحتمالات والتقلبات، ولديهم المبررات، لكن عندما تتغير الرياح، يتغيرون معها، يتمتعون بحماية النظام، بينما كان المثقفون الحقيقيون مطاردين.
2ـ إلى أي حد أسهمت الرقابة الرسمية وغياب استقلالية الكاتب في إضعاف الثقافة السورية؟
في حال استعرضنا الحركة الثقافية طوال نصف قرن، يمكن القول إن النظام نجح بإنتاج ثقافة غير نقدية، قولبها على الرضوخ والشلل، تراوحت بين ثقافة موالية ومؤيدة ورمادية ومحايدة ودعائية، لم تقدم سوى ترويج النفاق، هذا لا يعني أن الثقافة السورية لم تقدم اختراقات مهمة على جميع الأصعدة، في الأدب والسينما والمسرح والفن التشكيلي والموسيقا، من خلال جهود أفراد وتجمعات صغيرة، تمكنت من تصدر المشهد الثقافي بجرأة وكفاءة، إلى جوار الكثير من الأعمال التافهة التي رافقها الضجيج، ما عوض عن سويتها المتدنية.
خلال الثورة، استطاع عدد كبير من المثقفين المعارضين النجاة بالخروج من البلد، قدموا على مستوى التنظير مداخلات مهمة، كذلك في الفنون بأنواعها، وفرتها لهم الحريات في بلدان الديمقراطيات، أما في الداخل فاضطر المثقفون المعارضون إلى الصمت، لو كان الذين خرجوا، لبثوا في الداخل، لاعتصموا بالصمت، فالنظام البائد كان يبحث عن ضحايا ليلقن المثقفين درساً لا يقل عن الموت.
إذا كان هناك من تقييم لهذا المشهد الطويل من الحركة الثقافية، فهو أن قامات ثقافية حملتها على عاتقها، وبالنسبة للثقافات الوافدة، لم يكن تمثيلها إيجابياً، فلم تثمر كما كان متوقعاً، وإنما كان تقليداً بائسا لها، فلاحقت الصرعات، وتيارات مهمة في الأدب بلا مردود، وطالما الحرية مفتقدة، لا يمكن تحقيق ثقافة حقيقية من دون حرية التعبير، إضافة إلى استقلالية الكاتب عن النظام والدولة، بينما كان الحجر على الحريات هو السائد، ما وضع قيوداً على الكتابة، بلغت من التأثير حد نشوء ما يدعى بالرقيب الداخلي، هذا عدا الرقابات المتعددة (اتحاد الكتاب – وزارة الإعلام – القيادة القطرية – المسؤولون عن الصفحات الثقافية في الصحف والمجلات وامتداد علاقاتهم إلى الصحافة العربية).
3ـ هل من الممكن اعتبار “الروائي المريب” رواية شخصية أو سيرة ذاتية؟
ليست رواية شخصية ولا سيرة ذاتية، لعدم مطابقتها لمواصفات هذه الأنواع، في الوقت نفسه ليست منقطعة الصلة عنهما، حيث يلجأ الروائي أحياناً إلى استعارات من حياته ومسيرته، فعلتها أكثر من مرة، مؤخراً في “جمهورية الظلام” من خلال شخصية تلعب دوراً رئيساً فاعلاً على مدار الرواية، يفوق الروائي العليم، أسهم في تسيير الحدث الروائي ودفعه في اتجاهات متعددة، ومعرفته الكثير من الخفايا.
في “الروائي المريب” استعنت ببعض رواياتي، ومواقف تعرضت لها، كانت على انسجام مع حركة الرواية، كعامل مساعد، كما أنها لم تكن رواية شخصية، إنما رواية عن أجيال من المثقفين، وتيارات أدبية شكلت مفاهيم، وليست رواية توثيقية، إنها أحداث وشخصيات ومواقف وتقلبات وتحولات ومحاولات للتمرد في عالم كان قاسياً على الأدب، كان فيه غبن لأدباء لم يأخذوا حظوظهم رغم ما بذلوه من جهد، عالم … كان لأدعياء الثقافة وشطار الأدب الزاحفين نحو المنافع والشهرة الكاذبة، هذا مشهد عام استمر طويلاً.
4 – تقنية الشخصية الغائبة كنمط أدبي فريد ومعاصر نجدها حاضرة في روايتك، لماذا فضلت هذه التقنية؟
في هذا النوع غياب الشخصية يفوق حضورها، إن ما يحركه غيابها من إبهام وتساؤلات يخلق حولها هالة، تتضخم مع قوة تأثيرها، وبقدر ما يفعله غيابها تؤكد حضورها، هذا الغياب يكون فعالاً بغموضه، تستمد منه الرواية ديناميكيتها وتصاعد أحداثها وتوترها، وزئبقية شخصياتها، ما يناسب تعقيد مشاهد تدور في الخفاء.
لم أختر هذه التقنية بل تورطت فيها، لقد استدعت نفسها، الرواية تطلبتها، خاصةً أنها تقود إلى متغيرات لا تثبت على حال، لا يمكن ضبطها، ولا تحديد ظهوراتها الخاطفة، لماذا كل هذه القدرات؟ إنها ما تختزنه الحياة، من أشياء لا نعرفها، وإنما نتعرف إليها، لنقل باختصار إن إمكاناتها واسعة قد لا تحد، إذا أحسنا استثمارها، إنها أحد الأوراق في الرواية، استخدمت على أن يكون الغائب حاضراً.
5 ـ ما الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام البائد بحق الثقافة والمثقفين؟
في رواية سابقة وهي “المترجم الخائن” تعرضت للمثقفين بشكل مباشر، لكن كان هذا عن زمن ما قبل الربيع العربي، بينما “الروائي المريب” عن حدث حاضر هو فترة الثورة، ما وضع حدوداً واضحة وحاسمة بين النظام والشعب، كما أن لها امتدادات نحو الخلف، حيث استطاع النظام في الفترتين ضبط الثقافة، بربط اتحاد الكتاب بحزب البعث والمخابرات، واعتماد أشخاص ليسوا من الموالين فقط، بل الموثوقون أيضاً، حازوا رضا الأجهزة، هذه المركزية جعلت التحكم بالثقافة سهلاً إلى حد أنها عطلتها، وأدت في الواجهة إلى ظهور شلل من الأدباء يتنافسون على المناصب والمنافع، بينما الأغلبية معتم عليها، وعلى نسق الديكتاتور، انتشرت عقلية الأوحد في الثقافة: الأوحد في الرواية، الأوحد في القصة، الأوحد في الشعر، مع الهروب من إشكالات المجتمع، وتجاهل القمع والفساد، كذلك عدم التطرق بشكل جدي إلى تصحير المجتمع من السياسة، انعكست على الأدب، بدعوى أن الفن لا علاقة له بالسياسة، وإذا تطرق إلى ما يجري، فكان باستثمار آلام الضحايا، واعتماد سردية الإرهاب، هذا ما فعله النظام البائد، كمم الثقافة، ما أنتج ثقافة زائفة ومثقفين زائفين.
6 ـ لماذا كنت تميل في أعمالك التي رصدت فيها الثورة السورية والواقع السياسي إلى السخرية رغم ما فيها من ألم وسوداوية؟
يلجأ الروائي على الرغم من تراجيدية الأحداث، أو بسببها لاستعمال أسلوب السخرية، إن الاطلاع على الواقع خاصة إذا كان قاسياً، يعزز انتقاده بسخرية مرة، هذا الأسلوب يعمل ككاشف للتناقض الحاد في العالم الثقافي، فبينما الثقافة في جوهرها ليست إلا الضمير، تستخدم كمهارة في التحايل على الحقائق، وتجميل القبح، ونشر الخواء والضحالة، ما يُعد انتصارا لببغائية الشعارات، وللمآرب الشخصية على أنها وطنية.
السخرية وسيلة للتعرية، تفضح انحطاط مدعي الأدب رغم الرطانة التنظيرية التي يتحلون بها، وإذا كانت السخرية سوداء، فلأن الواقع أسود، وحدها تُشهّر بديكتاتورية ثقافة يقوم على حراستها أقزام ايديولوجيين، وعملاء تافهون، احتلوا المشهد الثقافي طوال عقود، مزودين بعقلية مخابراتية، قمعية ومتغطرسة، تستعمل كافة الوسائل لإقصاء الآخرين.
7 ـ المأساة السورية، إلى أي درجة تجد أنه من الضرورة بقاؤها موجودة في أدبنا ونتاجنا الإبداعي؟
المأساة السورية رغم حضورها القوي، بدأت رحلتها إلى التاريخ، وستطرق أبوابنا بين فترة وأخرى، لئلا تتكرر ثانية، وتكريماً للذين ضحوا بأرواحهم لأجلنا وللأجيال القادمة.
تنهل الرواية والأدب عموماً من التاريخ، لهذا لن تغيب كمادة تحمل الكثير من الحقائق الكبرى، عدا العبرة والدروس، إنها شهادة رائعة على عظمة البشر، وبالضرورة كانت أهم حدث تاريخي سوري في العصر الحديث.
تحمل المأساة السورية وجوهاً متعددة، لم تكن جرحاً، كانت مذبحة ومحرقة، لم تكن معركة، كانت حرباً عالمية في بلد صغير، الضحايا بالملايين، تعددت فيها صور صناعة الموت، مأثرتها الكبرى إسقاط ديكتاتورية شمولية رثة.
-
المصدر :
- سانا