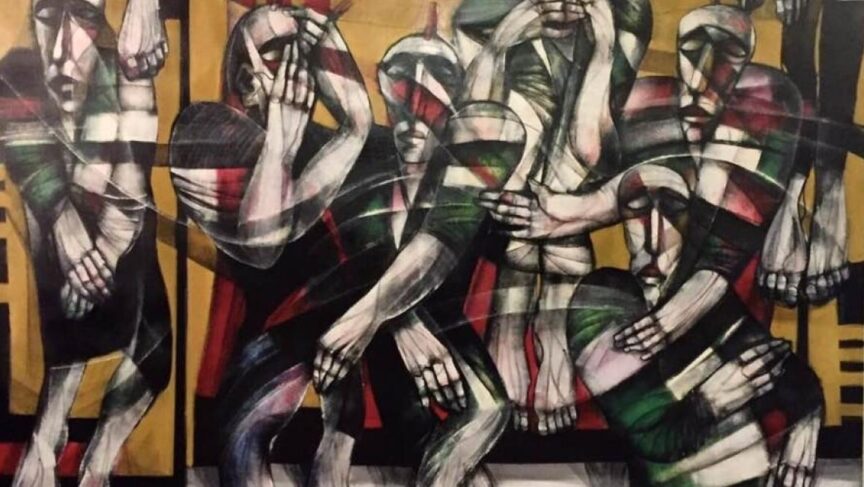في المشهد السوري، بعد التحرر، تكاثرت الأسئلة إلى حد أنها فاقت الأجوبة بما لا يقاس. وبالنظر إلى أن لدى المثقفين من المؤهلات ما يجيب عن الكثير من التساؤلات، ما دام أنهم بحسب الشائع، الضمير الذي يُهتدى به، لكنهم ارتابوا وتعمدوا الشك دليلاً، وهو أمر محمود، إن كان يصل بهم إلى اليقين، لكنهم استطابوا الشك وأوغلوا فيه، وبات الشك هو اليقين المخادع، ما أنتج بحسب تصوراتهم أن العجز أصبح قدراً محتوماً يواجه سورية في أكثر فصولها وعوداً، وهكذا ما زلنا ننتظر في زمان السؤال، وجاءت الإجابات مشفوعة بالاتهامات.
لماذا؟ لن نعمم، بعض المثقفين، اختاروا دور المثقف الصياد الذي يتحين الخطأ والزلة والهفوة، لا كي يدل عليها وينبه منها، باتت الأولوية العمل على تحويلها إلى جرائم، تستخدم مادة للتشويه أو “الترند” هذه الآفة التي يجري التنافس عليها للحصول على الشهرة، بينما هي وصمة أصبحت مهنة.
يتعامل المثقف الصياد مع أي خطأ يُرتكب، وكأنه جريمة ضبطت متكاملة الأركان. لا فرق بين خطأ عابر وفساد ممنهج، أو بين اجتهاد فاشل ونية خبيثة؛ كل شيء مباح، ما دام يصب في تأكيد فكرة واحدة: هذه السلطة الجديدة بديل عن نظام الأسد، وبالضرورة امتداد له أو نسخة منه، ومنهم من قال إنها أسوأ منه، فالأسد كان علمانياً، يسمح بالسهر والكحول والحشيش والدعارة وأكثر، ألم يصنّع الكبتاغون ويصدّره؟ حتى إن العالم المهووس بالرفاهية أصبح مديناً لنا بالمتعة والنشوة. كما أن الفساد في زمن الأسد كان دليلاً على الحرية، واغتنام المال بلا حساب، وكانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها لانتهاز الفرص حتى للسفلة.
هذا الرد من القماشة نفسها المتداولة على وسائل التواصل، وإذا كانت لا تسيء إلى نظام الأسد، فإنها تسيء إلى العلمانية، ولا تتسامح مع الفساد بقدر ما تعيد الاعتبار له وتعلي من شأن الليبرالية الانتهازية.
المهم أن تكون ضد السلطة، حتى لو كان الكذب هو الوسيلة
المشكلة هنا ليست في النقد، فالنقد ضرورة صحية وأخلاقية، وإنما في انحراف النقد إلى الاستثمار الانتقائي للكبوات والأخطاء، والمبالغة المقصودة في توصيفها، وتحويلها إلى سرديات كبرى تفتقر إلى الدقة والإنصاف، وتنتقل من صفحات التواصل الاجتماعي إلى المقالات “الرصينة”، يتلقفها مثقفو المصادفة، وتتحوّل إلى عناوين عريضة، عدا عن اختراع أخطاء، لا تقل خطورة عن ارتكابها، بذلك يتحول المثقف من باحث عن الحقيقة إلى مروّجِ ما يوافق الهراء الصدَّاح بسياسيات معطوفة على أيديولوجيات جرى تحديثها.
هذا السلوك ليس مجرد انحراف فردي، بل بات أحد الأنماط السائدة، يغذيه مناخ إعلامي مريض، وأرضية مشبعة بالاستقطاب، فحين يخرج تقرير كاذب أو خبر ملفّق، أو إشاعة مفبركة، تسيء إلى جهة أمنية أو إدارية، تُتداول بسرعة البرق، ويُبنى عليه كمٌّ هائل من التحليلات والمواقف. لا أحد ينتظر التحقق. لا أحد يراجع، لا أحد يدقق، لا أحد يحاسب؛ العقل في استراحة. المهم أن تكون ضد السلطة، حتى لو كان الكذب هو الوسيلة.
يخشى أن يصبح المثقف الوطني أحد المشاركين في هذه “الطوشة”، أو الساكتين عنها، في هذه الحالة لا يعود المثقف صوتاً موضوعياً، ولا نزيهاً، أو ضميراً نقدياً، بل أداة لأطراف لا تقيم وزناً للواقع الذي يجري بمتناول البصر، وتسقط عنه إحدى أهم صفات المثقف وهي التزامه بالحقيقة.
المفارقة في سورية اليوم، أن هذا الانحدار الأخلاقي يترافق مع شعور زائف بالتفوق الثقافي؛ المثقفون يمتلكون الفضاء العام، لكنها خدعة، إنهم يخرجون منه، إلى فضاء التزوير وغياب الوعي وإنكار الوقائع. ولا يمكن تقييم عمل بعض المثقفين إلا بأنهم استخفوا بدورهم إلى حد أنهم فقدوه.
-
المصدر :
- العربي الجديد