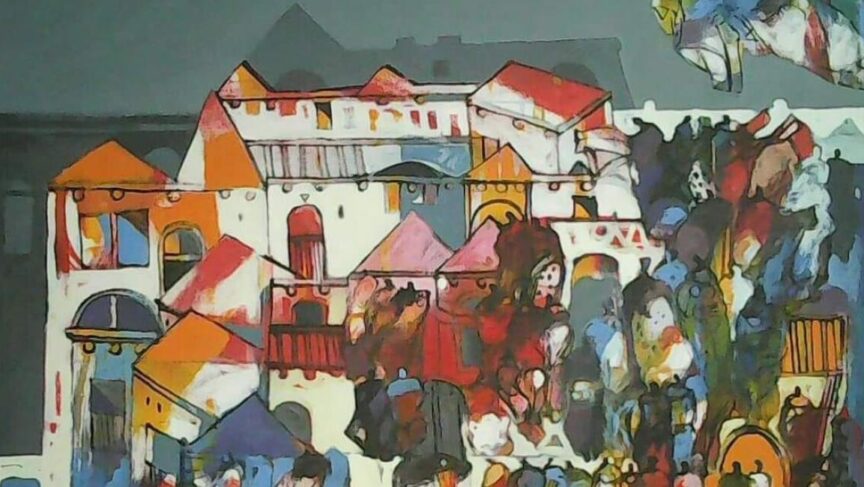هل الإنسان حرٌّ أم محكوم بالقدر؟ طرح هذا السؤال الروائي الروسي دوستويفسكي في روايته “الإخوة كارامازوف”. التساؤل ليس جديدًا، فقد طُرح كسؤال ديني وفلسفي مرارًا: هل الإنسان مسيّر أم مُخيّر؟ لم يُطرح سؤال دوستويفسكي في سياق نظري، وإنما في عمل روائي، حدّد مصير شخصياته، وجسدته صراعاتهم الداخلية. فالرواية أصبحت ساحة اختبار للفكرة الفلسفية، وللتعبير عنها.
من هذا المنظور، ليست الرواية مجرد سرد لوقائع وأحداث واقعية أو متخيّلة، بل هي في الجوهر محاولة لفهم علاقة الإنسان بالعالم من خلال إعادة صياغة الأسئلة الوجودية الكبرى، وذلك بالتآزر بين العمليتين الروائية والفلسفية، وعبر البعد الفكري العميق الإنساني والمعيشي. فالرواية تمنح للفلسفة لغة الحياة، من خلال شخصياتٍ نابضة بالحياة، وأحداثٍ تنبض بالصراعات الفكرية تجاه الحياة والمجتمع.
الشخصية الروائية ليست مجرد أداة لتحريك الأحداث، بل هي أيضًا وغالبًا انعكاس لموقف فلسفي أو حالة فكرية. فمثلاً في رواية “الأبله” لدوستويفسكي، يمثّل الأمير ميشكين النموذج المثالي للإنسان الطاهر البريء في مواجهة لامبالاة العالم وفساده، وبالتالي كان تساؤل دوستويفسكي: هل تستطيع البراءة أن تصمد في عالم يهيمن عليه الشر؟
هذه الشخصية ليست وسيلة لتحريك السرد ومنحه التوتر والإثارة فقط، بل هي تجسيدٌ لفكرة تدور حول الصراع بين الخير والشر، والقدرة على التصالح مع القبح الإنساني.
في حين نجد أنَّ جان بول سارتر في روايته “الغثيان” يجعل من شخصية أنطوان روكنتان ساحةً لصراع فلسفي ذاتي حول الوجود والعدم. تتجلى بحالة روكنتان، الذي يعيش حالة اغتراب فكري وشعور بأنَّ العالم فاقد للمعنى، عبثية أيّ محاولة لإضفاء معنى على الوجود. لم تعد هذه الفكرة الفلسفية في الرواية مجرد تأمّل نظري، بل تتحوّل إلى حالة وجودية ملموسة يعيشها البطل في علاقته بالأشياء والناس.
هذا النمط من التفلسف يظهر بوضوح أيضًا في أعمال فرانز كافكا، حيث يُصبح الصراع مع البيروقراطية في رواية “المحاكمة” أو مع النظام الغامض في رواية “القلعة” تعبيرًا عن عبثية الوجود الإنساني أمام قوى غامضة وغير مفهومة. كافكا لا يقدّم حلولًا أو تفسيرات، بل يعيد القارئ إلى حالة القلق والشك الفلسفي حول معنى الوجود وحدود الحرية.
الشخصية الروائية ليست أداة لتحريك الأحداث بل انعكاس لموقف فلسفي
لا تهدف الرواية الفلسفية إلى إمتاع القارئ أو إثارة مشاعره فحسب، بل إلى دفعه للتفكير. عندما يواجه القارئ الأسئلةَ التي تطرحها الرواية، فإنّه يصبح شريكًا في عملية التساؤل والبحث الفلسفي.
ومثلما قراءة رواية “الجريمة والعقاب” لدوستويفسكي تجعل القارئ يعيد التفكير في مفهوم العدالة، تدفع قراءة رواية “الغريب” لكامو إلى التساؤل حول معنى الحياة في مواجهة الموت.
الفلسفة في الرواية ليست مجرّد دلالة على ثقافة الروائي، ولا إضفاء بعض الأفكار على عمله، بل تدخل في جوهر البناء الروائي، بحيث يصبح السؤال الفلسفي جزءًا من نسيج السرد، ما يضع القارئ أمام أسئلة الوجود الكبرى حول: الخير والشر، العدل والظلم، الحرية والقدر، الحب والكراهية، الوجود والعدم.
هذا من دون الزعم بأن الرواية تقدّم أجوبة نهائية، لكنها تجعل القارئ يدرك أنّ البحث عن الإجابة هو في حدّ ذاته فعل إنساني، لا يخلو من مغامرة قلقة، تتحول في الرواية من تجربة أو سؤال إلى مسألة شخصية وإنسانية ووجودية وأخلاقية.
-
المصدر :
- العربي الجديد