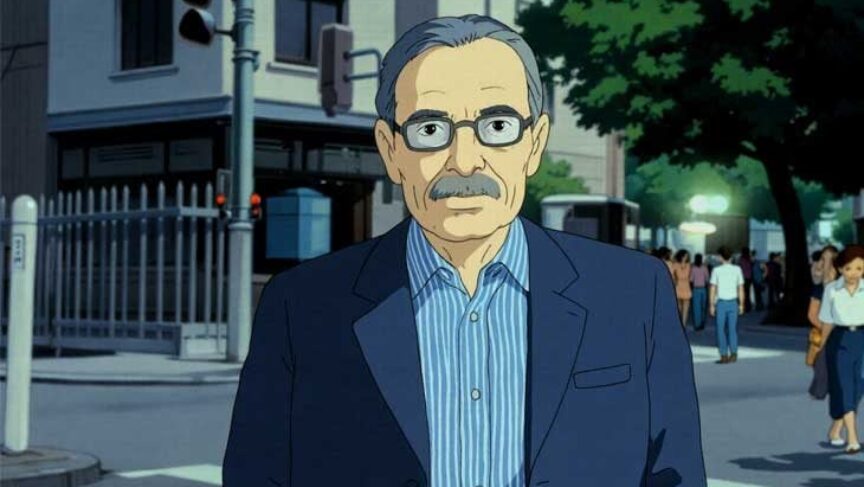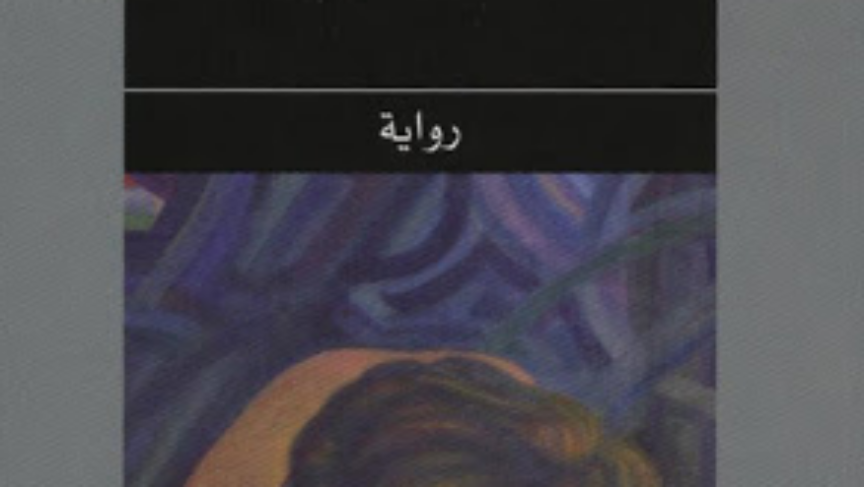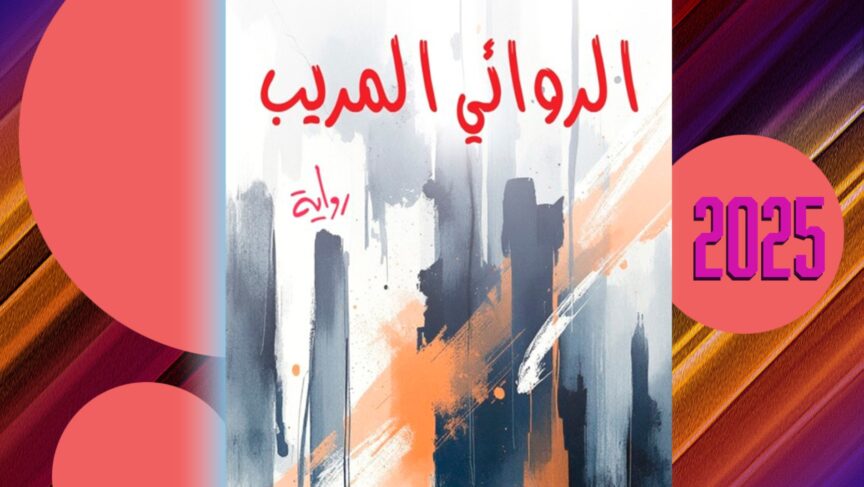يفتتح فواز حداد، عمله الصادر مؤخرا «الروائي المريب»، بمشهد من مقهى الروضة الدمشقي المعروف، الذي يعتبر ملتقى للمشتغلين بقضايا الثقافة والسياسة، حيث يتناقل الحضور، أن البلد «على فوهة بركان»، لأن «الرئيس الخالد» (كناية عن ديكتاتور سوريا الأسبق حافظ الأسد) في غيبوبة. يعلّق الراوي على الحدث، بأسلوب هازئ ضمنيا من الرطانة السياسية ـ الإعلامية المميزة للإعلام السوري (وهو أمر سيكون إحدى الخصائص الفارقة في الرواية) فيقول إن الرئيس «لم يمت، بل ودّع الحياة».
يضمّن حداد المشهد تفصيلا صغيرا عن خبر ذكره أحد الجالسين، لكن الحضور يتجاهلونه بسبب الحدث السياسيّ الضاغط، يقول إن شخصا أصدر رواية ولأنهم لم يكونوا يعرفونه من قبل فقد سموه «الروائي الشبح»، وسيكون هذا التفصيل محورا رئيسيا يدور حوله أغلب «أبطال» الرواية، الذين يمكن اعتبارهم أيضا نوعا من «الأبطال المضادين» الأشبه بالمسوخ في روايات الرعب.
تتطور حبكة الرواية على سعي هؤلاء، الذين سنعلم أنهم ممثلو «شبكة الثقافة» السورية ومدبري شؤون دوام النظام (رغم موته الواضح)، لوأد هذا التفصيل الصغير الذي يتكون مثل البذرة في رحم الرواية.
رغم أنه «بلا ملامح»، كما يصفه الراوي، فإن فريد جسام، سيكون أحد الشخصيات المركزية في الرواية، ويرأس مجلة أدبية، كما يدير «عصابة» من الأدباء المريدين «في الداخل والخارج»، ثم يأتي بعده حسين كروم رئيس «اتحاد الكتاب العرب» (نقابة الكتاب السوريين الرسمية المنشأة بمرسوم تشريعي عام 1969)؛ ثم «كبير النقاد» الذي هو روائي أيضا، والذي يصفه الراوي بأنه «على النمط اليساري السمج: مناقشات وتنظير وسجن وسجانون وثوار طهرانيون»؛ و»الراديكالي» الذي «أصبح ترجمانا لامعا جهبذا ومكثارا»، وهو يتمتع بـ»براغماتية جسورة تحلل أي سياسات، ولو كانت إجرامية، مع ما يصاحبها من خساسات بشرية، من الوشاية إلى الخيانة»، وهناك سعدي «ضابط أمن الاتحاد»، المخبر الصغير الذي يشي بزملائه ويودي بهم إلى المعتقلات والقتل، وهناك حسناء شاهين، الشخصية النسوية التراجيدية التي يقوم جسام بإقناعها بإنشاء كتاب عن علاقاتها الجنسية مع الأدباء، وإضافة إلى ضابط مخابرات يتعامل مع جسام، فهناك «ضابط أعلى للثقافة»، ذو اسمين، الأول يتلقب باسم طه ويمارس نشاطه من شارع الحمراء وسط دمشق، والثاني شكيب، ويمارس نشاطه من القصر الجمهوري، وهناك «الوسيط» الغربي، الذي تتعامل معه المخابرات السورية لإطلاق جسام «إلى العالمية»!
التراجيدي في قلب الملهاة
إضافة إلى الروائي «الشبح»، الذي تحرّك رواياته الصادرة بأسماء متعددة الحدث، كونها تقلق هذه «الشبكة العنكبوتية» التي تحاول التحكم في الثقافة وضبطها، هناك صفاء الشاعرة، التي يحاول جسام إغواءها، ولكنها تقع في حب «الشبح» وتلاحقه من عاصمة إلى أخرى، وهناك حمود، القاص الذي يُعتقل ثم يهرب (بمساعدة «الشبح» وصفاء) ويتزوج نازحة قُتل زوجها.
يشتغل حداد على رسم شخصيات مميزة لهؤلاء، خائضا، في الوقت نفسه، في لعبة روائية شديدة الجرأة، لأن القارئ العارف ببعض شؤون الثقافة السورية، سيتمكن من مدّ خطوط تشابه بين تلك الشخصيات الروائية، وبعض النقاد والأدباء والصحافيين العاملين في الشأن الثقافي السوري، كما سيتمكن من اكتشاف تشابهات أيضا مع سيرة حداد نفسه (في حوار بين «الشبح» وصفاء تسأله: «هل أنت في الرواية أم في الواقع» فيقول: «أنا في رواية، هي الواقع، لا انفصال بينهما»). لكن الحبكة، تتضمن طبعا – وإلا لن تكون حبكة روائية – شغلا تخييليا ورمزيا يُحرر هذه الشخصيات من التشابهات المعلومة، خصوصا في شخصيتي جسام والحسناء، اللتين تسمحان برؤية التراجيدي في قلب الملهاة السوداء التي يصنعها مسخ السياسي والمخابراتي للثقافي في الوضع السوري.
التعذيب حوار بين طرفين!
ستزداد غرابة قراءة الرواية مع الانتباه إلى الجدل، في مناسبات عديدة، بين الكاتب، و»الروائي الشبح» (أو «المريب» كما تسميه الرواية)، وراويه، الذي أراده عالما بالأحداث، وبتدخله في مواضيع عديدة للشرح، أو للعودة بالأحداث إلى الخلف أو للتقديم، والأهم، بإدخاله لتعابير ومصطلحات وأفكار الشخصيات بأشكال شتى تستدعي دراسة خاصة، ولعل أنسب طريقة لمن يريد فهمها أن يعود لتنظيرات ميخائيل باختين البديعة، حول النصوص التي «تعاكس مركزة حياة اللغة، وتخالف اتجاه قوى توحيد الأيديولوجيات اللفظية، وتعمل على إيجاد كثرة لسانية، تترجم الوعي بضرورة تعدد اللغات والملفوظات وتداخل الخطاب»، وذلك «لتعكس بعمق وجوهرية وحساسية أكثر، وبسرعة أكبر، تطور الواقع نفسه».
يستخدم حداد هذه التبادلات بين السياسة، ومثقفي الأسدية، كأحد أساليبه في السخرية الضمنية الكامنة في تلافيف الرواية، ومن ذلك أن الراوي يصف «التبدّل» الذي طرأ على تفكير ضابط مخابرات، بعد نقاشاته مع أحد هؤلاء المثقفين، فيقول إن اغتصابه وتعذيبه المعتقلات «أصبح من أساليب التواصل، مسرحية يدور فيها حوار بين طرفين».
تتكرّر في الرواية مشاهد يتجاور فيها الفظيع مع الكوميديّ، مثل مشهد اجتماع «الراديكالي» برفاقه القدامى الذين يتفاجأون بخطابه الجديد المتعارض مع شيوعيتهم، فيقدم الراوي البذاءة مترافقة مع العنف ضده فلا يكتفي المثقف بلفلفة الفضيحة، بل يحوّلها إلى فضيلة يتاجر بها، بنسجه قصة عن محاولة اغتياله من قبل الإرهابيين. تتكرّر أشكال الفضائح التي يرتكبها هؤلاء، مثل اعتقال «كبير النقاد» لمحاولته الاعتداء على شاعرة مبتدئة، ثم تدخل المخابرات للإفراج عنه، وتعرّي جسام أمام الشاعرة نفسها، لترفع عليه خنجرا وتهدده بالقتل، ومثل البذاءات والإهانات التي يستخدمها ضباط الأمن معهم.
في اختياره الثقافة موضوعا لروايته الحالية، يضع حداد لبنة أخرى في معماره الروائي الكبير، الذي رصد التاريخ السوريّ الحديث بمظاهره المتعددة، بدءا من روايته «تياترو 1949»، التي بدأت بالتاريخ السوري الحديث بعد الاستقلال، وصولا إلى عمله الفارق، «السوريون الأعداء» الذي كان، على الأغلب، أول عمل يتناول موضوع الثورة السورية، والذي استدعى استنفارا كبيرا لدى مثقفي النظام.
الرواية، ضمن هذا السياق، وبهذه الجرأة الكبيرة، تكاد تكون تصفية حساب هائلة، شخصية وعامة، مع ثقافة الحقبة الأسدية، ومحاولة لإنهاء هذه الحقبة، التي استدرك الكاتب سقوطها في آخر صفحتين من روايته. قام حداد بقتل تلك الثقافة المسخ بألف جرح (على الطريقة الصينية)، ثم قام بتفكيكها ووضعها في مكانها اللائق من التاريخ باعتبارها جثة متفسخة.
-
المصدر :
- القدس العربي