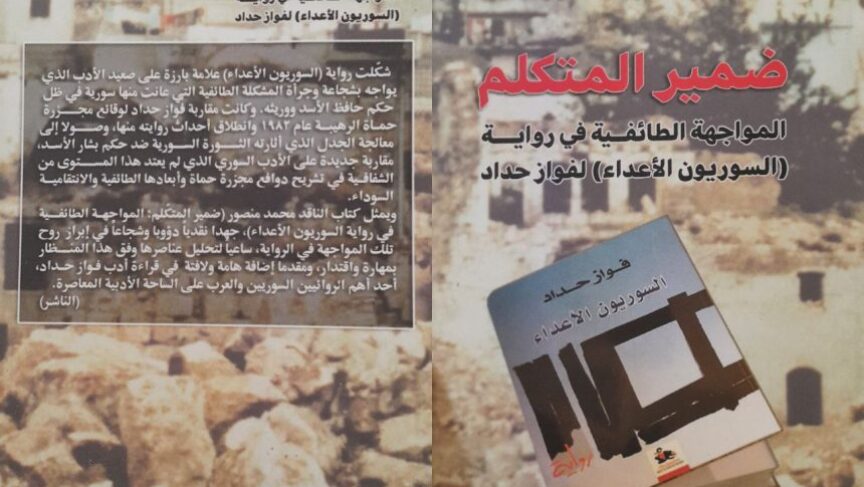واكبت الرواية العربية الاتجاه العالمي للرواية، فسلكت مسارات الحداثة في التجديد والتعبير عما يقلق الإنسان، عبر تحطيم الحدود التي تفصل بين الواقع والخيال؛ ومن هذا المنطلق عمل الروائيون العرب على تجديد المضمون السردي بتطعيمه بالعجائبية والأسطورة، وتظفير لغة السرد باستيهامات الشعر، فبرزت الواقعية السحرية (القديمة- الحديثة) التي تمزج الواقع بالمتخيل، فتنتج واقعًا هجيناً يتأرجح بين العالمين.
ولو استنطقنا المعاجم لوجدنا أن “عجب” يتناوشها معنيان: الغرابة، والإدهاش، فالغرابة صفة، والإدهاش سلوك؛ فهي بذلك تعبر عن صفة الموضوع ورد فعل المتلقي تجاهه، والعجب عند (القزويني) “الحيرةُ التي تعرضُ للإنسانِ لقصورهِ عن معرفةِ سببِ الشيء، أو عن معرفةِ كيفيةِ تأثيره فيه”، ويقترب هذا المعنى من “التردد” لدى الفيلسوف الفرنسي- البلغاري تودوروف (T.Todorov) حين عرّف العجائبي بأنه: “الترددُ الذي يحسُّ به كائنٌ لا يعرف قوانين الطبيعة، فيما يواجهُ حدثًا غيرَ طبيعيّ حسبَ الظاهر”.
وتشي كلمتا “الحيرة” و”التردد” بوجود بُعدين للإدراك (الواقعي، واللاواقعي)، يدخل بينهما المتلقي في حالة من (اللاحسم)، وهو ينتج عن تداخل الواقع والخيال، والتوظيف والتحول والتشويه، فالمتلقي يتردد بين عالمين: عالم الحس والواقع، وعالم الوهم والخيال، وهو ما يميز العجائبي عن غيره من دلالات السرد الحكائي، “فالتردد هو ما يمدّ العجائبي بالحياة”، ولا يتم هذا التردد أو الحيرة لولا أن الموضوع العجيب راقَ للمتلقي، واستمرأ غرابته، فلا يثيره خروج “العجائبي” عن المنطق والعقل؛ بسبب تواطئه مع ما يخالف المنطق، وتخليه -مؤقتًا- عن حسه النقدي. وفي هذه النقطة بالتحديد يتمايز العجائبي عن الخرافة، ففي الخرافة يصطف العقل كليًا بجانب اللامعقول وهو واعٍ لوهمه، بينما هو في العجائبي يتأرجح بين المعقول واللامعقول بتواطؤ واعٍ.
تلقف الكاتب فواز حداد هذا المنهج، فألف روايته “المترجم الخائن” بأسلوب عجائبي، عبّر فيه عن صوت الإنسان المقموع المهمش، من خلال بطله (حامد سليم)، وما تولد عنها من شخصيات عجائبية، خلقها ليعيش واقعًا بديلًا عن الواقع الطبيعي، فكانت الشخصيات أقنعة قاوم بها حيف الآخر، كما عبّر الكاتب عما في الواقع من تناقضات، عجز البطل عن مواجهتها وحسم النتيجة لصالحه، فلجأ إلى عالم الخيال حتى يكون ملكه ومالكه. ومن ناحية ثانية مرر الكاتب الانتقادات لواقع ينخره الفساد حتى النخاع، وتتلاعب به النفوس الضعيفة.
وبطبيعة الحال، قدم المؤلف رواية اجتماعية تسلّط الضوء على التناقضات التي تحكم أحد ميادين المجتمع السوري، وتزيل الأقنعة عن أوجه الفساد التي تنخر الوسط الأدبي- الثقافي وذلك بالولوج إلى أدقّ تفاصيل الحياة اليومية في تلك المؤسسات، والوصف الدقيق والمسهب للشخصيات والجماعات التي تستحوذ على الرأي العام في عالم الصحافة والأدب والثقافة، يعريها الكاتب ويفضح فسادها، كما لم يجرؤ كاتب آخر على ذلك، ويبين للقارئ كيفية سيطرة الشخصيات النافذة وتحكم الشللية الثقافية، وتحولها إلى مافيات تتغول على المجتمع كتّابًا وقراء، ومن ثم سحق كل ّمن لا يقدم الجزية الفكرية وهو صاغر.
ينتمي بطل الرواية إلى هذا العالم، عالم يعيش بوجهين: وجه نزيه، جميل، غيور على الأدب وقوانينه التي يُحظر المساس بها، ووجه خفيّ قبيح منتفخ حدّ الانفجار، متغطرس حدّ الجريمة، وفي هذا العالم الذي ينجح به المنافق المستعد دائمًا للانسلاخ عن مبادئه، يرسم الكاتب الظروف المحيطة التي كوّنت القمع اللازم، لتشكل الشخصية العجائبية، فالعجائبية هي هلوسات ولوثات، لا تولد إلا تحت الضغط الشديد كالقمع والكبت والتهميش، ونتيجة ذلك تكون وسيلة المهمشين للانتقام من الآخر أفرادًا وجماعات.
ولا يُشترط أن يصدر التهميش عن الوسط الاجتماعي، بل قد يصدر عن المؤسسة التي يعمل فيها الفرد، وهو ما حصل مع بطل الرواية (حامد) الذي تعرّض لظلم مؤسساتي، حين تكاتفت عليه المافيات الأدبية/الصحفية وأقصته عن الساحة، فحولته إلى معزول منبوذ أشبه بالأجرب الذي يتحاشى الكتّاب التواصل معه في العلن، وحاصرته من النواحي كافة، وقضت على مستقبله المهني، كما قطعت مصدر رزقه، لأسباب ظاهرها تصرفه في خاتمة رواية ترجمها، فغيّر تلك الخاتمة وفق رؤيته، وباطنها حنق أحد الكتاب المتسلطين عليه، ورغبته في الانتقام. يضاف إلى هذا القمع حساسيته الشديدة واعتكافه على قراءة الروايات، وغوصه في عوالمها مهملًا واجباته الأسرية ومتناسيًا أنه زوج وأب لطفلين، مع ما استجد فيه من عادة التكلم مع نفسه في خلواته.
لعل هذه المعطيات، جعلت من حامد شخصية تستقطب مظاهر الصراع الداخلي، واستنادًا إلى هذا تغدو الاستعانة بمعطيات علم النفس أداة فعّالة لكشف المضامين النفسية لهذه الشخصية، وسبر أغوارها والوقوف على مقوماتها، وصولاً إلى التحول العجائبي لحالاتها النفسية، من مونولوج وهلوسة وتقمص، وفي الوقت ذاته كشف الطريقة السحرية التي يتشكل فيها العجائبي وكل ما يمتّ إليه بصلة.
وبناء على ذلك تتوجب دراسة المضامين النفسية للرواية استنادًا إلى المنهج النفسي القائم على “التحليل النصي” الذي يهمل مؤلف العمل، ويركز على العمل الأدبي نفسه، بحيث يتم تفجير النص من الداخل، مع الاستعانة بمعطيات علم النفس الفرويدي، وما تقدمه من تفسيرات للعمليات النفسية الموجهة للسلوك الإنساني، وبذلك يتم الكشف عن قدرة الكاتب على التغلغل في أغوار النفس الإنسانية واستخراج ما فيها من هواجس ومكبوتات، ثم تشكيلها تشكيلًا دراماتيكيًا يحير البطل والقارئ معًا.
وقد (تبرعمت) نفس البطل إلى ثلاث شخصيات: المترجم (عفيف حلفاوي)، والراصد (أحمد حلفاني)، والراوي (حسن حفلاوي)، ولا شك أن لاختيارات الأسماء إشاراتها عند المؤلفين، والراجح أن الكاتب كان يقصد المعنى المضاد لكل اسم، عفيف: المترجم النزيه، وأحمد: الناقد المستقيم، وحسن: القارئ المتبحر. ولم تكن في بادئ الأمر تعدو كونها أسماء مستعارة يختبئ حامد خلفها، ويمارس مهامه بعد فضيحة التزوير التي التصقت باسمه الحقيقي، لكن الأحداث تطوّرت فتجاوزت فكرة الاسم المستعار إلى شخصيات تتحاور مع البطل.
شخصية عفيف حلفاوي: يستفحل الاسم المستعار (عفيف) في ذهن حامد، وشيئًا فشيئًا تتشكل شخصية حلفاوي داخله بوعي تام من البطل لغرائبية ما يحدث ومنافاته للعقل، بل بوعي لأسباب تبرعم هذه الشخصية منه، يقول الراوي: “حامد لم يفته هذا الأمر الغريب، وكان من الطبيعي تمامًا أن يقول لنفسه مستنكرًا: أيّ جموح في الخيال لو أنّني قبلتُ بتقاسم ذاتي مع آخر، هو أنا، ويعمل على تبعيضي، مجرّد هذه الفكرة تدعوني إلى الضحك الهستيري، ومع هذا رجّح أن تكون محنته السابقة مع الترجمة، قد صوّرت له هذا الانفصال عن ظلّه، أو الانسجام في داخله”(ص 155).
ويرسم المؤلف مظهر هذه الشخصية وطباعها رسمًا دقيقًا، يتناسب مع مترجم حرفيّ ينقل ما يقرأ عن اللغة الإنكليزية نقلًا أمينًا، وهو يتجاهل تدخلات حامد، ويسير باتجاه واحد معاندًا ملاحظات حامد له. وربما تُحيلنا شخصية حلفاوي إلى شخصية الشيطان مع “إيفان” أحد أبطال رواية “الإخوة كارامازوف”، في تعالق بين النّصين غير خافٍ، وكما ضاق إيفان ذرعًا، فصرخ قائلًا: “إنّك تصوراتي وأوهامي، وأنت ذاتي مجسّمة، ولكنْ من ناحية واحدة فقط من نواحي نفسي. وأنت أفكاري ومشاعري. ولكنّك أحقرُها وأغباها”، خاطب حامد حلفاوي، فقال: “أنا حقيقتك، أما أنت فخطئي وكذبي وحماقتي التي لن أغفرها لنفسي” (ص 158). وتمنّى إيفان التخلص من الشيطان: “إن عجزي عن الاهتداء إلى وسيلة لتحطيمك، هو وحده السبب الذي يحتّم عليَّ أن أشقى مدةً من الزمن”، وكذلك تمنى حامد التخلص من حلفاوي وزميليه، لكنه كلّما حاول ذلك أوجد المبررات لوجودهم: “تمنّى موتهم، لكنّهم لم يعدموا أعذارًا للعيش، ألم يُلفّق وجودهم بخزعبلات من تدبير تخيلاته؟” (ص 445).
وهكذا يستمر حامد بعمله في الترجمة، وفق هذا الجوّ من التردد بين الواقع والخيال، تردّد يجرّ إليه القارئ، فيتعاطف معه، ولا بأس، ما دامت هذه الحيلة أثبتت نجاعتها في إخراجه من عزلته، وحصوله على مصدر رزق سريّ.
شخصية أحمد حلفاني: كما تشكّلت شخصية حلفاوي، لتقوم بوزر ترجمة الروايات عن حامد، وذلك بالاتفاق مع المستشار، تشكّلت كذلك شخصية أحمد حلفاني (الراصد)، لتجترح الكتابة والنقد في الصحفبعد اتفاق سريّ بين حامد ومدير الجريدة، لكن مشكلة حامد الوليدة هي كيفية التوفيق بين الشخصيتين، شخصيتان بلا جسدٍ ولا مخّ ولا إحساس، تقاسمانه جسده وعقله، شخصيتان بطباع متباينة، الأول (حلفاوي) عنيد ذو نفَس مديد، لا يرهقه جدلٌ مهما امتدّ زمنه، يفتقد إلى روح المبادرة، حرفيّ يتقيد بالنص الأصلي تقيدًا خانقًا، يتمتع بجلَد يُحسد عليه، وبمخٍ سميك لا يُحسد عليه. بينما أحمد حلفاني كاتب ذكيٌّ أريبٌ، له تاريخ طويل من النشاط الثقافيّ، يؤهله للشّغب، وخوض المكائد والنزاعات، وإصدار الأحكام، كلاهما استقى خبراته العملية من حامد، غير أن حلفاوي يمثل صوت الآخر وحلفاني يمثل صوت حامد إلى حدّ ما.
فما كان من حامد إلّا أن نظّم الدوام بينهما، فيعمل كلّ منهما في الزّمن المخصص له من دون التعدي على حصّة غيره، ويحصر تحركاته ضمن غرفة العمل الوحيدة مع الانتباه للأوقات، فالفراغ مفسدةٌ ومجلبةٌ للمتاعب، وهكذا ظنّ حامد أن بإمكانه إدارة الفضاء بينهما والتحكّم فيه، ولكنْ “ليست المشكلة في أخذ الأول مكان الثّاني، بلْ فيما سيؤدي إليه من انزلاق حمولات فكرية من صاحبها إلى غير صاحبها، وانتقالها بذلك من مجالها إلى مجال آخر لا يصلحُ لها “(ص 192).
ويضعنا الكاتب في قلب غرفة العمل، نرقب، ونشاهد كيف يتم تبادل الأدوار بين العمل والراحة بين شخصيتين تشغلان جسدًا واحدًا، ذلك الجسد الذي يصبح أشبه بأداة نقل تركبها الشخصية لأداء مهمة الرواح والمجيء ترويحًا عن النفس، ويخيل للقارئ وهو يقرأ وصف تنظيم هذه العملية، مع إمكانية خرق للنظام وحدوث تزاحم بينهما على ركوب الجسد.. يخيل إليه أنه أمام شبح يدخل جسد حامد ويخرج منه، كما تصور ذلك برامج الكرتون، أو ما يشبه الجنيّ الذي يتلبسه فترةً، ثم يخرج ليحلَّ محلّه آخر، وقد يتلبسانه معًا في الوقت ذاته. يصفهما الكاتب بأنهما ليسا أشياء ولا جمادات، “إنما ما يشبه الأرواح الهائمة، لا الأحياء الساكنة، وبما أنهما متطفلان على حامد سليم، وهو شابٌ من لحمٍ ودم، غيرُ محكم الإغلاق، فإنّ وجودهما يعاني حتى حين يرغب بالاستقرار من التّرجرج والتّمدد داخل قالب فضفاض متحرك، إذ قوامهما الأثيري المتحرّر من ثوب الجسد، يسيل عبر أي منفذ متوفر” (191). هذه القدرة على النفاذ عبر أيّ فتحة، تحيل الذهن إلى شخصيات كرتونية تتمتع بهذه القدرات كـ “الشبح كاسبر” الذي كان يدخل عبر فتحة منفذ مفتاح الباب.
ولم يغلق عالم حامد على هاتين الشخصيتين اللتين تمكن من تنظيم وجودهما بعد عناء، بل بقي الباب مواربًا لدخول شخصية ثالثة:
حسن حفلاوي: وهي كسابقتيها انبثقت عن اسم مستعار، اقتُرح عليه من أحد الانتهازيين، المستغلين لإمكانيات حامد وثقافته، وثالثةً قبِل بها على مضضٍ، حتى يخرج من ضائقته المالية. فقد طلب منه أحد الروائيين الذائعي الصيت أن يسطو على الروايات الإنكليزية التي لا تلفت النظر في بلدانها، ثم يزوده بموضوعات وحبكات منها، كي يقوم -كما يزعم- بهدمها وإعادة بنائها من جديد. هي عملية سرقة أدبية وضيعة، يلجأ إليها أنصاف الكتّاب والروائيين، فيقومون بالسطو على الروايات المنسية، وينهبون مواطن الإبداع فيها، ثم يعربونها وينسبونها إلى ذواتهم الفقيرة أدبيًا وأخلاقيًا.
وهكذا شرع الكاتب ببناء شخصية القارئ المختلس، هو شاب طيّع مطواع، يغوص في أكداس الروايات كلص يبحث عما هو جدير بالسرقة من فكرة أو حبكة أو شخصية وربما أسلوب. ولم يكن من السهل أن تلبسه هذه الشخصية، فقد قاومها ورفض مهمتها، فيما برزت شخصية (حامد) القارئ الناقد المستكشف لعوالم الروايات من الداخل، والمواد التي تصنع منها: اللغة والحدث، تآلف الواقع مع الخيال، وكيف يرسم الكاتب شخصياته ويفبرك لها ملامح وطباعًا وأصواتًا وأقوالًا… وغير ذلك من تفاصيل الطريق التي يسلكها الكاتب للوصول إلى خط النهاية، كان يظهر فيها حامد الناقد، ويختفي حفلاوي لص الأفكار والحبكات.
وطالما حاول التخلص من الشخصية الثالثة، لكنّ إلحاح صاحبها الكاتب اللص من جهة، وحاجة البطل للمال من جهة ثانية، مكّنت تلك الشخصية من الدخول إلى فضائه والتجوّل في غرفته مع الشخصيتين السابقتين. ويرسم الكاتب بأسلوبه العجائبي مشهدًا اختلطت فيه أفكار حامد فتلاقت الشخصيات الثلاث في اللحظة ذاتها، بينما كان من المفترض أن تبقى متباعدةً، كلٌّ في مجاله، فيقول: “تهادى المنظر متينًا، كلٌّ منهما في طرف (المترجم والراصد) ويميل نحو الآخر، أشبه بمثلث متساوي الساقين، فيما توضّع الثالث أشبه بعقدة جامعًا بينهما بزاوية مشتركة تعكس قوة تأثيره، أسهم الحضور الراوي للغريب (شخصية القارئ اللص) في تثبيت مثلّث لا يمكن خلخلته إلا بتفكيك العقدة الجامعة بين ساقيه، بإرسال الثالث إلى الفضاء الذي جاء منه” (ص 377). ولكن وبالرغم من هذه المقاومة والرفض الناتجين عن المهمة الدنيئة التي يقوم بها (حسن حفلاوي)، ودناءة صاحبها لص الأفكار الذي كلّفه بها، رغم ذلك تجد طرقها إلى عالمه، وتتمكن من نفسه، وتستمر معه حتى نهاية الرواية.
لقد أزال فواز حداد الحدود بين الواقع والوهم، فبنى وجودًا موازيًا، خلق فيه شخصيات تنتصر لصاحبها، وتواجه الواقع الخارجي بأدوات جديدة، فحقق إحدى مهام السرد، وهي تفكيك بنية الحلم، وإعادة بنائها ضـمن عالمـه المتداخل مع الواقع، وبذلك تصبح التهويمات الخيالية والشطحات النفسية إشباعًا للحاجات التي يقمعها العُرف والمجتمع. وإذا كان الهدف من الهروب إلى عالم العجائبية يتراوح بين تحقيق الأمنية، أو الإثارة والاستمتاع، فلعلَّ الكاتب مكّن بطله من تحقيق بعض أمنياته، وحقق للقارئ الكثير من الإثارة والمتعة.
وبهذا التداخل العجائبي/النفسي المحكم مع الواقع، يتنقل الفكر بينهما تنقلًا حرًّا، وكأنهما عالمٌ واحدٌ متوافق ومتفق، يغدو فيه جسدٌ واحدٌ لثلاث شخصيات وهمية أمرًا مقبولًا، يتلقاه القارئ ضاربًا بحدود العقل ومنطقه عرض الحائط، متواطئًا مع الكاتب واجتراحاته الأسطورية، ومتماهيًا مع تصرفات الشخصيات فيفرح لنجاحها، ويبتئس لإخفاقها.
-
المصدر :
- العربي القديم